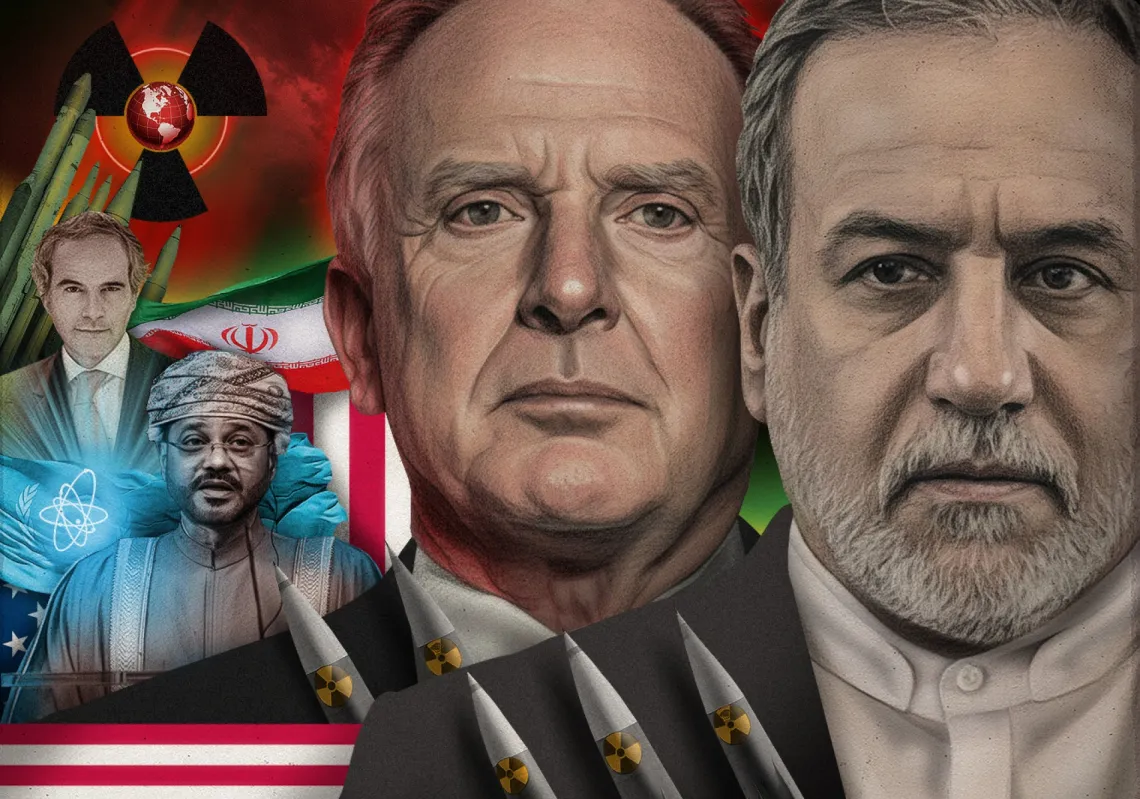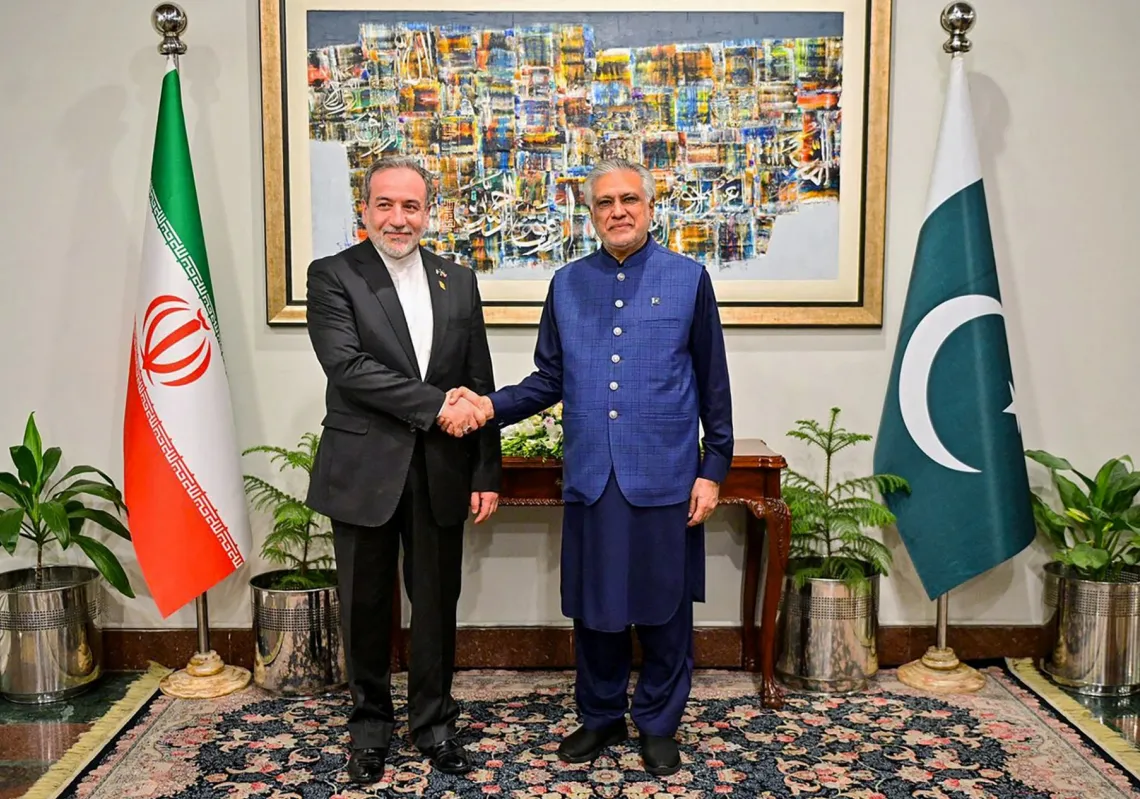"في وسط الفاجعة، وحدها اللغة الأم لا تكذب"، كتب بول تسيلان. لكن ماذا لو استيقظ شاعر يوما ليجد أنه ليس فقط لا يملك لغته الأم، بل أي لغة أخرى؟ لهذه المأساة كرس الشاعر والباحث الفرنسي أدريان فينك (1930 – 2008) روايته "الأحبس" التي كتبها باللغة الألمانية ولجأ فيها إلى شخصيتين رئيستين لسرد قصتها: الراوي الشاهد على المأساة الذي ولد في مقاطعة الألزاس قبل عام 1914، والشاب فرنسوا، الضحية، الذي ولد عام 1930 في المقاطعة نفسها، وعانى طوال حياته القصيرة من هذه الحبسة التي فرضها التاريخ عليه.
الرواية التي نقلتها إلى الفرنسية ابنة فينك وزوجته، وصدرت حديثا في باريس عن دار "أرفوين" تحت عنوان "الرجل الذي لا لغة له"، تستمد فتنتها العالية وأهميتها القصوى ليس فقط من قصتها وموضوعها، بل أيضا من طريقة تشييدها على شكل مقابلة مثيرة بين عناصرها السيرذاتية ونصوص متفرقة، بين اللغات الثلاث الفاعلة في سرديتها: الألمانية، الفرنسية والألزاسية، وبين الرواية نفسها والقصائد المقترحة في نهايتها، وقد كتب فينك معظمها باللغة الألزاسية كفعل "مقاومة بواسطة اللغة".
خصوصية
عمل فريد من نوعه إذن، ينير بكل خصوصياته التجربة الرهيبة والمجهولة لأبناء مقاطعة الألزاس التي تنازعتها ألمانيا وفرنسا على طول تاريخهما الدموي، من دون الاكتراث لرأيهم، وعواقب هذا التنازع على الناجين منهم، الذين وجدوا أنفسهم في كل مرة محرومين ليس فقط من اللغة الألمانية أو الفرنسية، وفقا إلى الفاتح، بل خصوصا من روحهم بالذات، المجسدة بلغتهم الأم، الألزاسية، التي كان ينظر إليها الطرفان المتنازعان بعين الاحتقار. حرمان أدى إلى تمزق هوياتي مخيف، لأنه "إذا لم تعد الكلمات والكينونة، الكلمات والأشياء، تتطابق، تصبح الأزمة وجودية بعمق".
في معرض تصنيفه هذا العمل، تحدث فينك مرارا عن "خرافة ذاتية" (autofiction). لكن مع أن الخرافة فيه تسمح بكشف مدهش للحقائق المبني عليها، إلا أن المنحى السيرذاتي يمسك بها بإحكام ويفيض منها باستمرار، ليبدو النواة الأساس للقصة المسرودة فيه. وفعلا، الشخصيتان المركزيتان اللتان تشكلان ركيزة هذه الخرافة هما في الواقع صنوان للكاتب. فالراوي لا يتقاسم معه فقط موطن الولادة، الألزاس، بل أيضا مهنة التدريس ووظيفة الشاهد> والشاب فرنسوا لا يتقاسم معه فقط تاريخ ميلاده ومكانه (قرية هاغنباخ)، بل أيضا دعوته الشعرية، ومعاناته اللغوية وأزمته الوجودية، إضافة إلى حمله اسما ثانيا يرتبط بعائلة أمه (هارتمان).
أما النصوص المتفرقة التي توقع سردية الراوي المرصودة لحياة فرنسوا القصيرة، فتحضر على شكل كولاجات فيها، وتتألف من أسفار أخبار قديمة (سِفر أخبار بيتر هاغنباخ)، ومذكرات، كتلك التي خطها فيليب لو بون عن عهد فيليب الصالح، دوق بورغوندي، من حكايات وأساطير ألزاسية وأقوال تاريخية، من مقالات صحفية وتقارير خاصة بالدعاية النازية، من أبيات شعرية شعبية وأغان ألزاسية، ومن تدوينات موسيقية وقصائد لفرنسوا.
مواد تحضر بالألمانية والفرنسية والألزاسية ضمن مونتاج حاذق، غايته إنجاز عمل قائم على الذاكرة، تؤدي الكتابة فيه وظيفة الضامن لعدم النسيان. ففي مكان ما من الرواية، يقول الراوي إنه يكتب "كي لا ينسدل بسرعة على كل شيء ستار النسيان". هذا التوتر بين ذاكرة ونسيان لا يهيكل فقط كل سرديته، بل أيضا الرواية بجميع عناصرها المتفرقة.