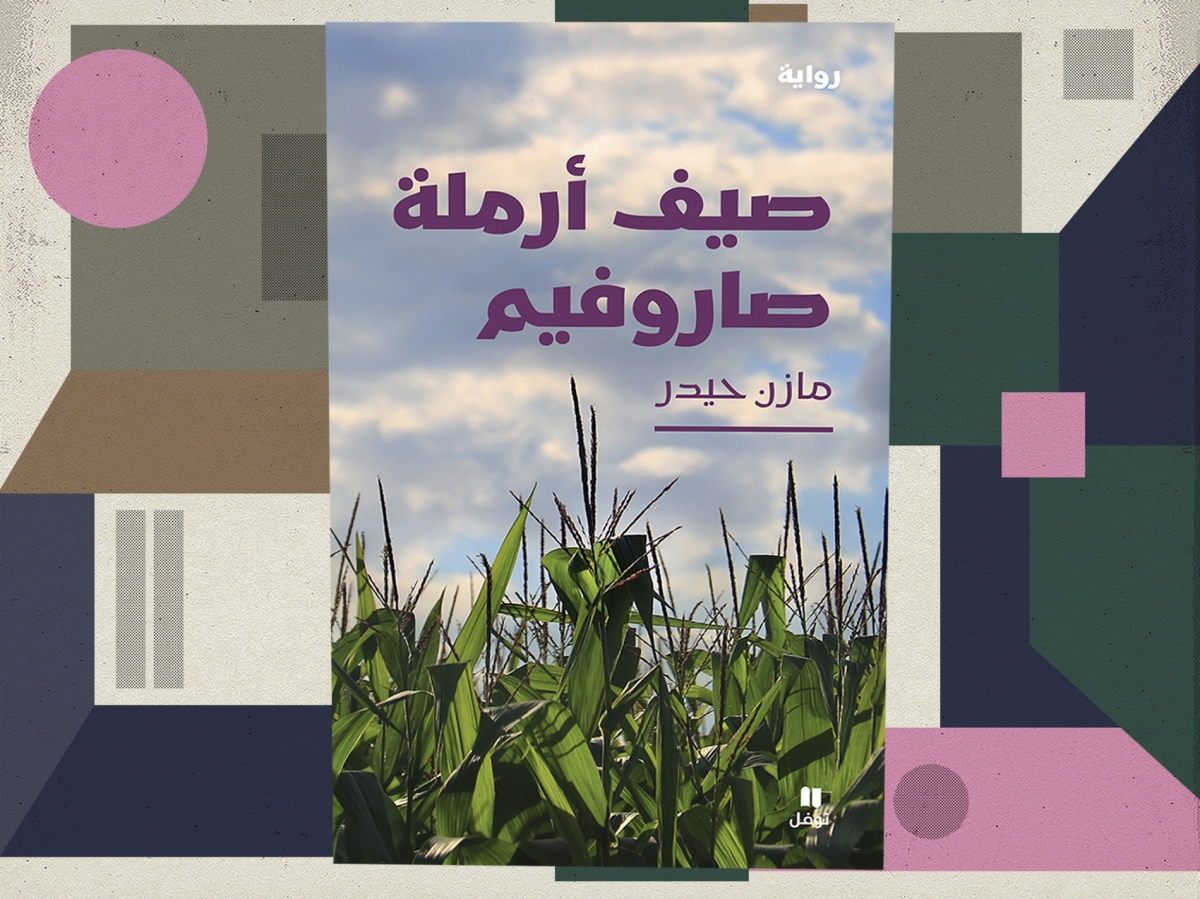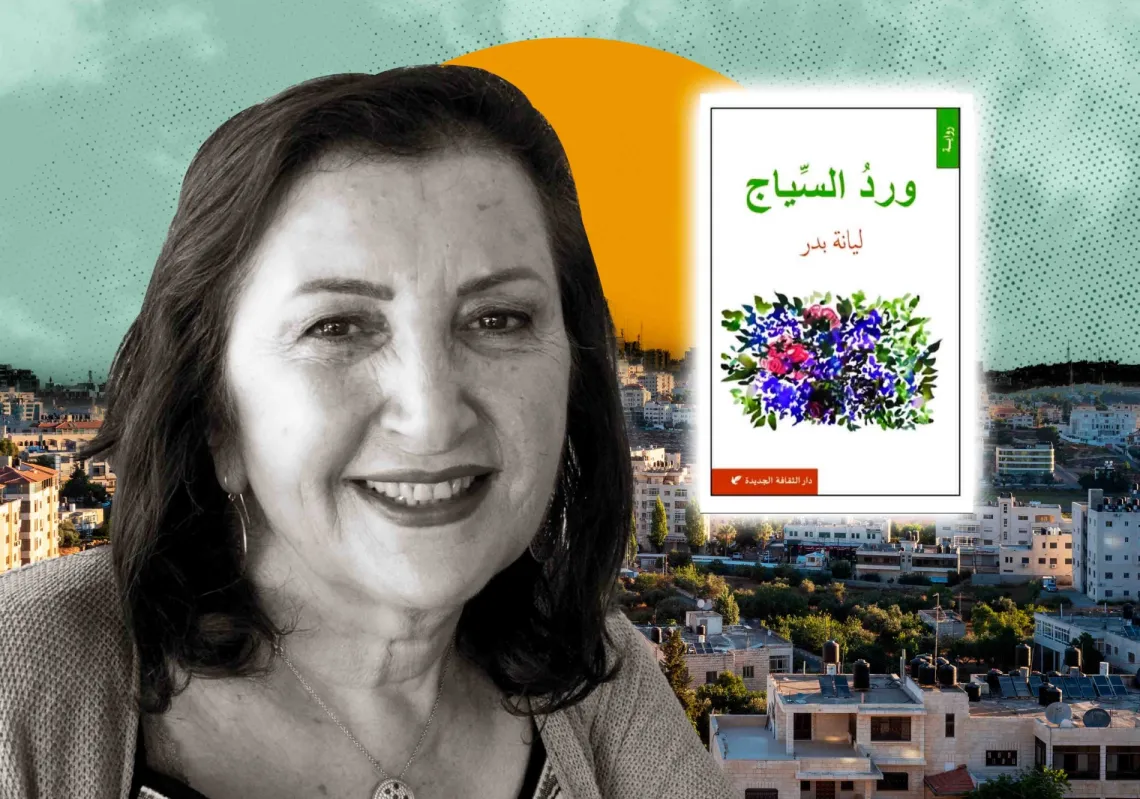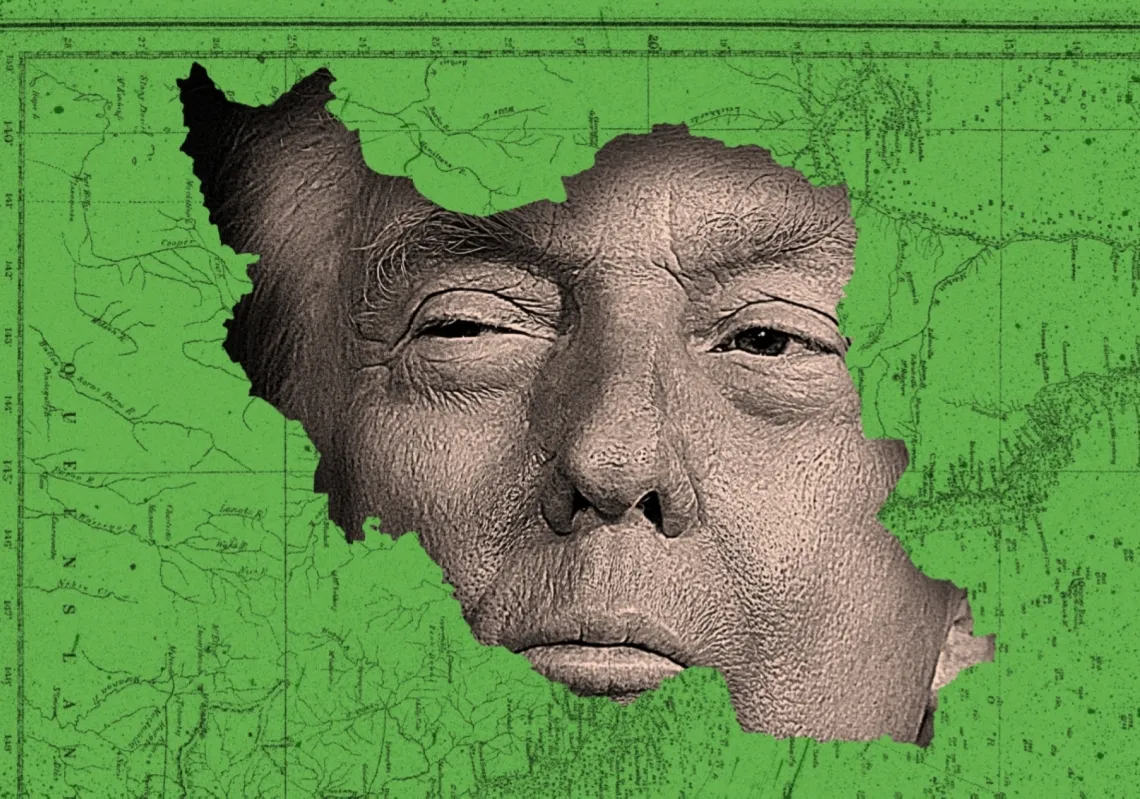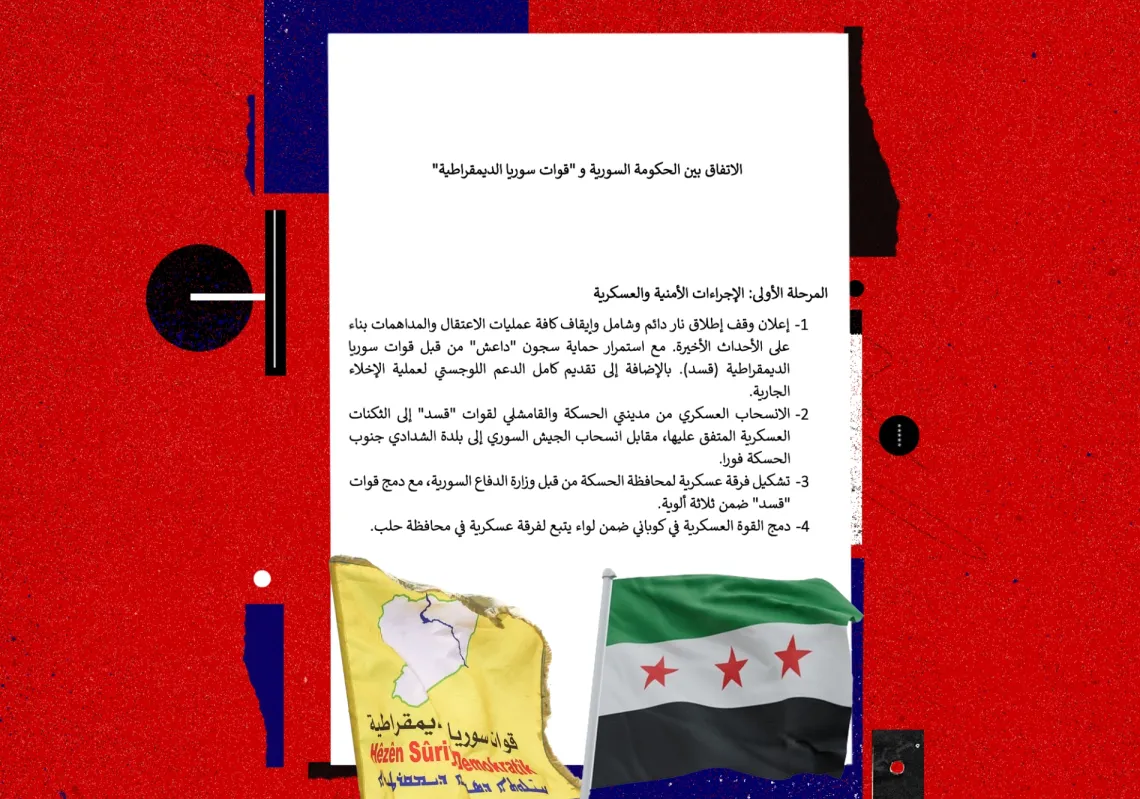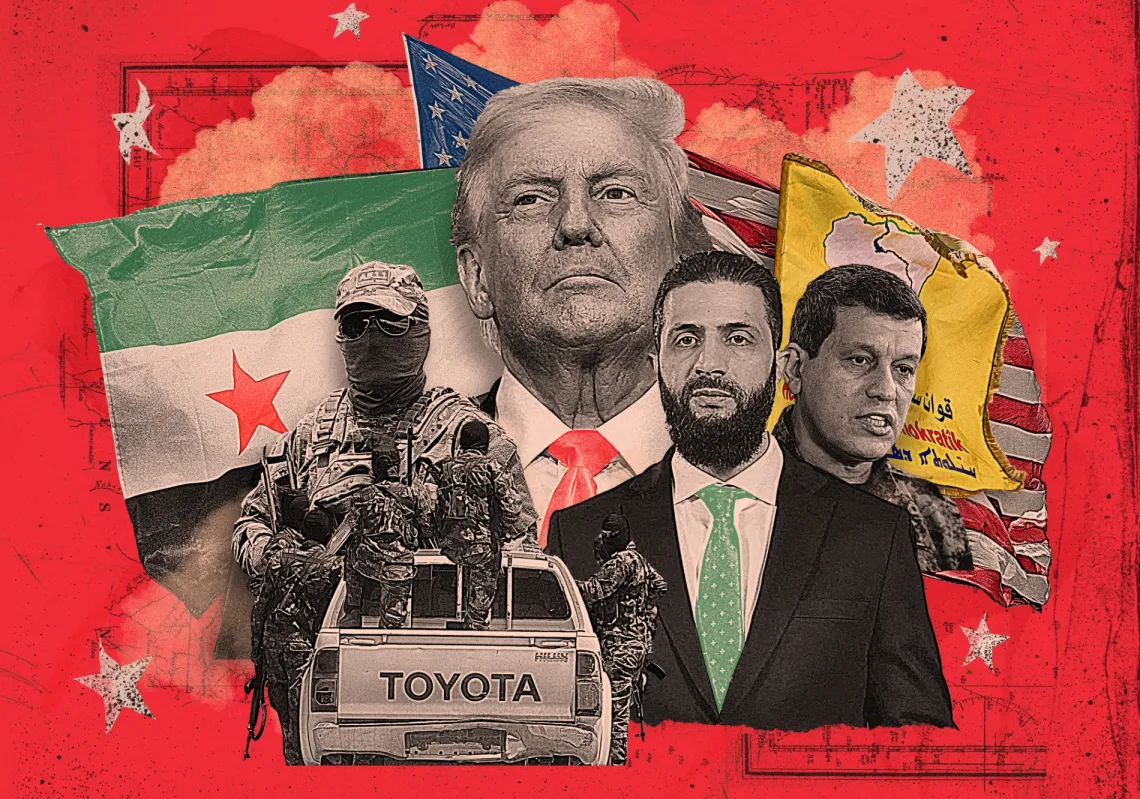ينتمي الروائي اللبناني مازن حيدر (من مواليد بيروت، 1979) إلى جيل من الكتاب الذين يعاينون الذاكرة والواقع من مسافة تأمل هادئة، ويقتربون من الحرب من زواياها الصامتة وآثارها الجانبية، وما تتركه من شروخ خفية في تفاصيل الحياة اليومية. في روايته "صيف أرملة صاروفيم"، تظهر الحرب كظل طويل يمر فوق الجدران والوجوه والخرائط القديمة. تمضي الرواية في اتجاه الكشف عن آثار العنف: ما تراكم من محو، وقلق، وأسئلة لا تجد جوابا مباشرا.
ضمن هذا المناخ، تتخذ الشخصيات مواقعها في الهامش، فتبدو ككائنات تحرس الأسرار أو تسعى إلى فهمها. من هنا، تطرح الرواية علاقتها بالتراث والهوية والذاكرة، داخل بنية سردية مشدودة، تتسع للتأويل وتنطوي على توتر داخلي دقيق.
تدور أحداث "صيف أرملة صاروفيم" (دار نوفل/ هاشيت أنطوان، بيروت 2025)، في قرية عين سرار الجبلية، خلال صيف عام 1989، في ذروة "حرب التحرير" التي كانت تشتعل في العاصمة بيروت. تشكل هذه القرية فضاء شبه معزول، لكنه مشحون بالتاريخ والقلق، حيث أن البطلة التي تحمل اسما غير شائع لأنثى، أسامة، تجد نفسها نازحة إلى منزل خالها، لتقيم فيه مؤقتا وتبدأ عملا كمعلمة لطفلين من نازحي الساحل. تتصاعد الحبكة بهدوء، عبر سلسلة من الإشارات الغامضة والرموز المحفورة على شواهد القبور، التي تقود إلى أسئلة حول اختفاء الآثار وتحولات المكان. وتظهر منذ البداية نبرة الغموض المحيط بالمكان، كما في هذا المقطع: "ها هو مزار المنعطف الأول لجهة البلدة. وها هو المزار الثاني، حاضنا شخص مار شربل تزينه الزهور البيضاء. شجرة السنديان المعمرة، عمود الكهرباء وإعلان المخيم الصيفي. هذه قلعة مار قرياقوس ونقطة ضبط الأمن المستحدثة... وها هي في نهاية المطاف لافتة عين سرار الزرقاء ترحب بكم!".