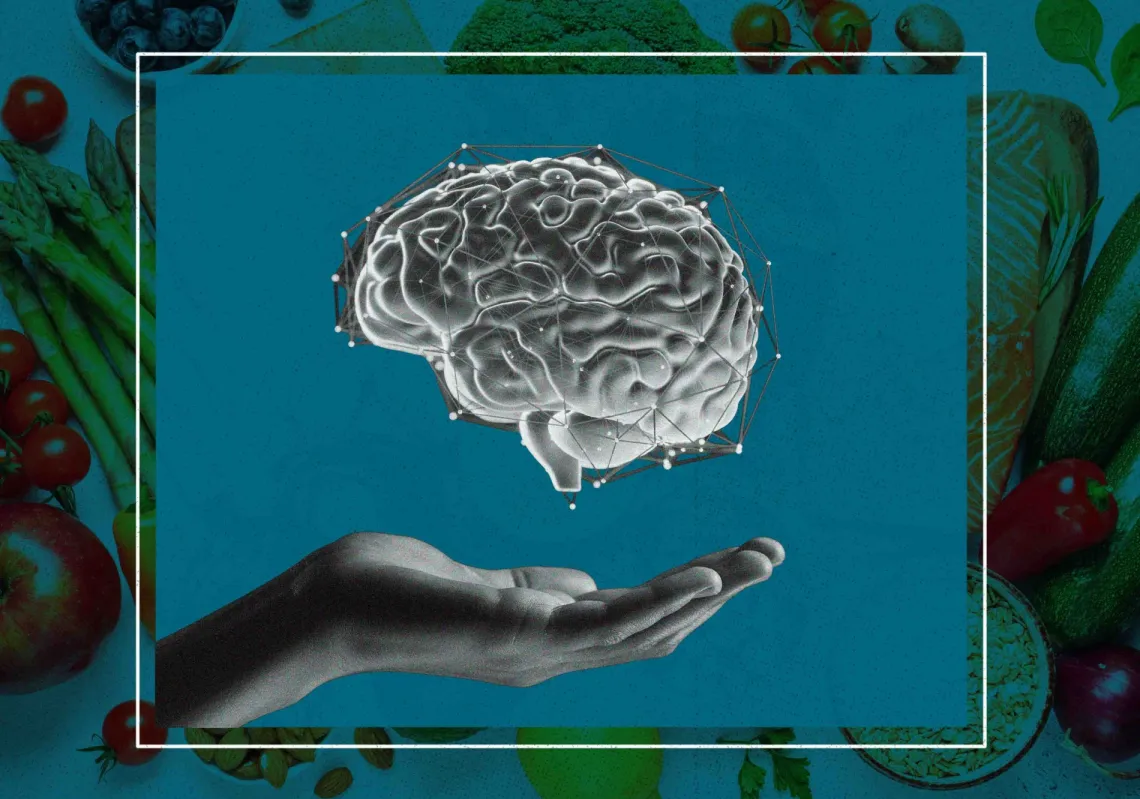شكلت البنية القبلية عاملا رئيسا في تكوين هوية المنطقة العربية في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من اختلاف التسميات التي طرأت على أهالي المنطقة فإن السمة التاريخية التي يمكن رؤيتها ما بين السطور هي "البدو"، فهم سكنوا المنطقة قبل الميلاد، يغادر بعضهم ويأتي آخرون، وحكمت تحركاتهم الغايات الاقتصادية وعوامل البقاء، إضافة إلى الانتقالات القسرية بفعل الحروب والصراعات فيما بينهم من جهة، ومع الطارئين على المنطقة من جهة أخرى (غزاة، إمبراطوريات).
وعلى الرغم من التنقلات الكثيرة، فإنها لم تكن جذرية، بمعنى الانتقال التام للعائلة البدوية الواحدة، فبقاء البعض منهم في منطقة يفتح الباب أمام التقارب والتزاوج بينهم وبين عائلات أخرى، ما يعني تداخلا تُبنى عليه قرابة الدم، ويؤسس لتحالفات عائلية ستكون ذات تأثير كبير على القوى المتعاقبة في المنطقة، ليصار لاحقا إلى إطلاق تسميات أخرى على بعض العائلات البدوية مثل القبيلة كحامل رئيس، والعشيرة كحامل أصغر. التسميات الثلاث بُنيت على أساس حالة الترحال المستمرة للبدو، أو الحالة الحضرية (الزراعية) للقبيلة والعشيرة.
مع عصر الإسلام زادت الهجرات العائلية بين منطقة الشام والجزيرة العربية، إضافة إلى مصر وجغرافيا واسعة وصلت إلى الأندلس وحدود الصين، نفوذهم يقوى ويقل بحكم التداخلات مع السلطات، فمثلا زمن الأمويين كانت للعشائر قوة وتأثير على القرارات السياسية والاجتماعية، في حين تراجع بشكل ملحوظ النفوذ زمن العباسيين، فكان للفرس في منطقة الشام قوة أكبر، ومع الزمن والحروب التي دخلت فيها المنطقة بات لدى عائلات البدو (الذين باتوا يُعرفون بالقبيلة والعشيرة) قدرات وهوامش للدخول واللعب في عالم السياسة والتحالفات العسكرية مع تلك القوى المتعاقبة على المنطقة، هذه القدرات والهوامش خلقت في الوقت نفسه فجوات وخلافات داخلية، فقسمت القبيلة والعشيرة من الناحية السياسية والعسكرية، وجعلتها أكثر هشاشة في مواجهة الرغائب السياسية للسلطات.