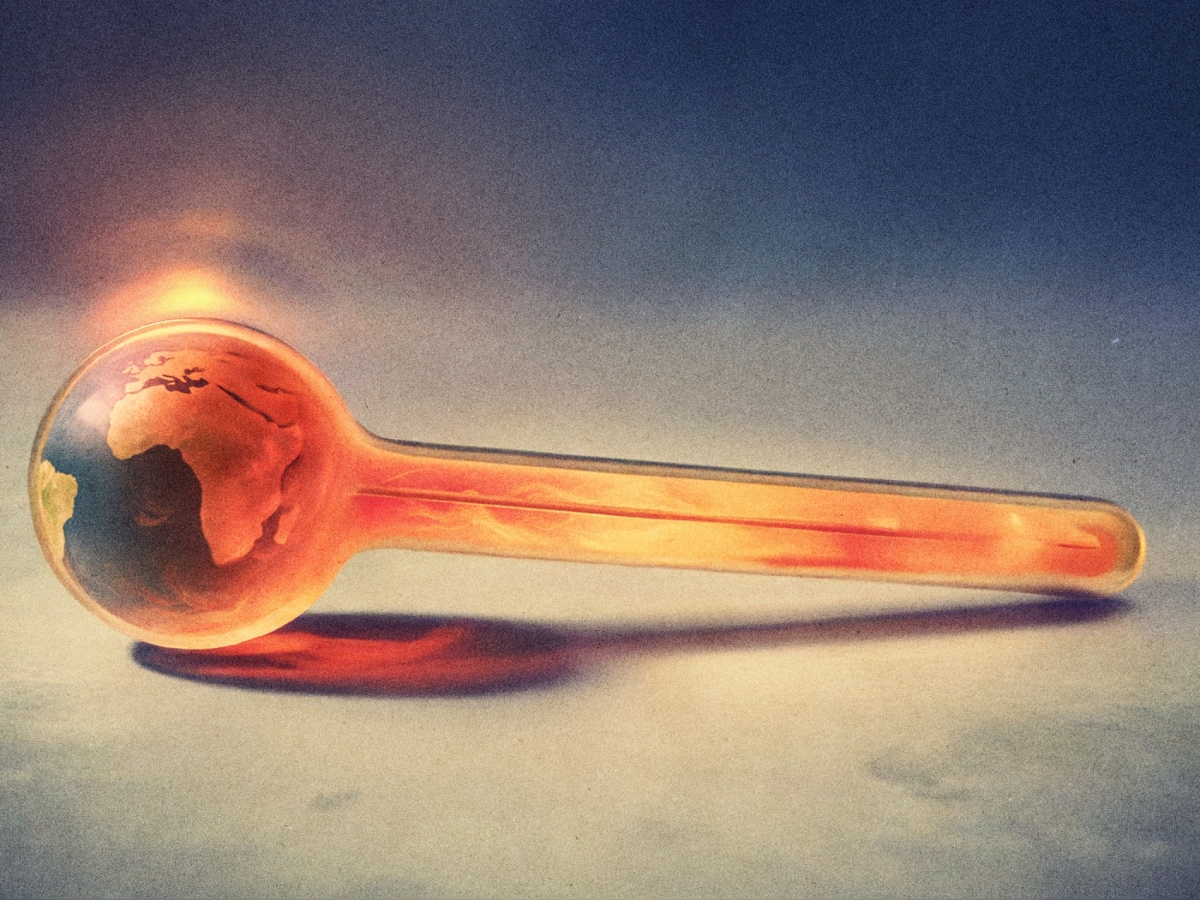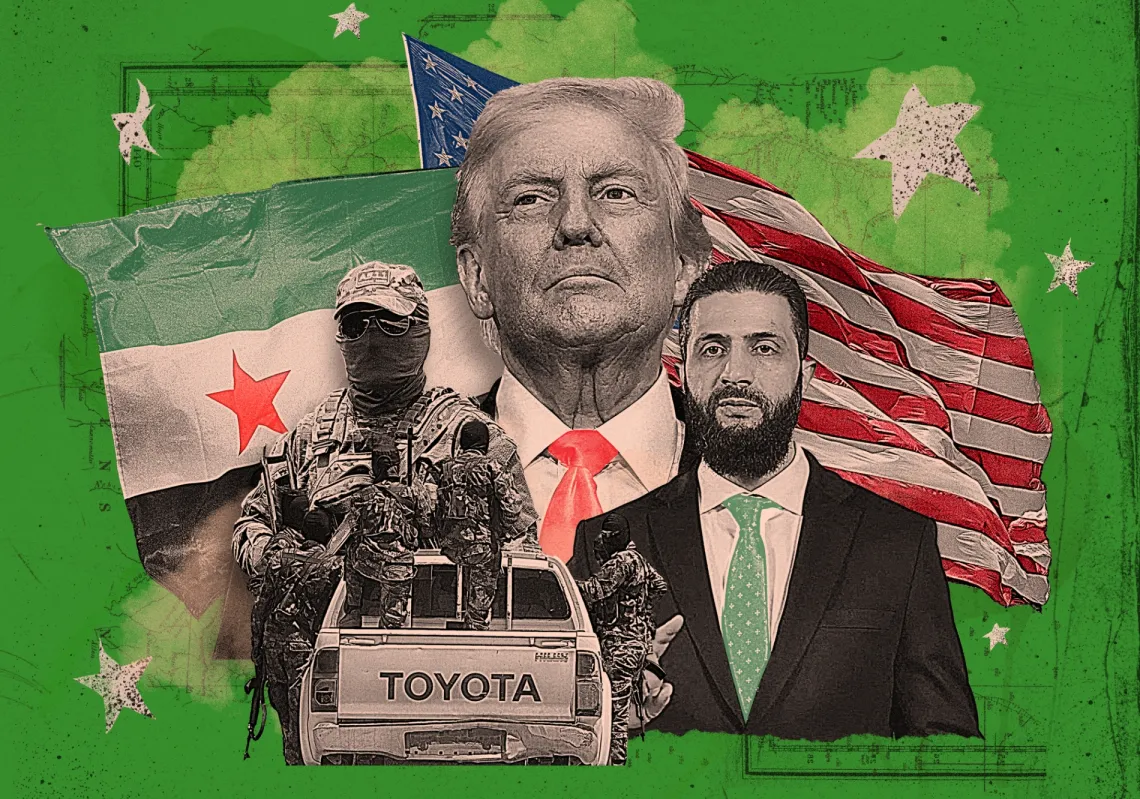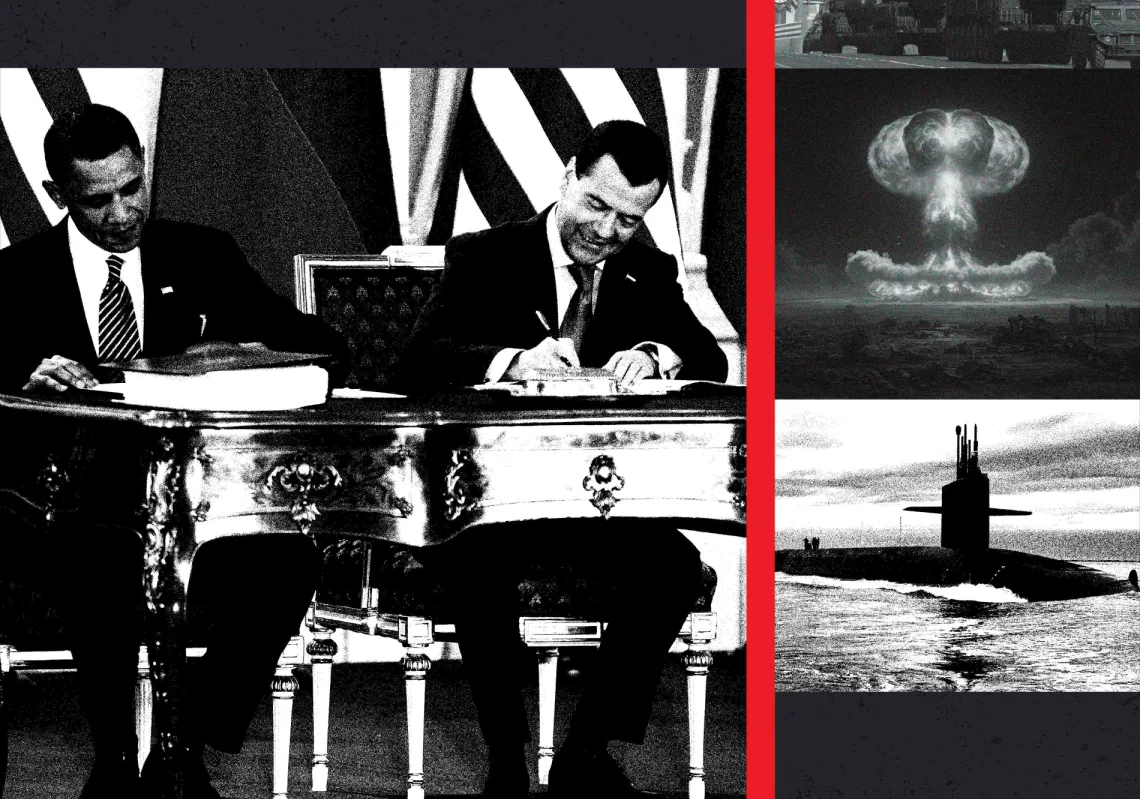يعرف الجميع الآن أن المناخ يتغير. لم يعد الأمر جدلا علميا أو فرضية محل نقاش، بل حقيقة تتكرر أمامنا كل صباح، في حرائق الغابات، وانحسار الجليد، وخرائط الحرارة التي تصبغ الكوكب بالأحمر القاني. ومع ذلك، لا شيء يتغير حقا. العالم يزداد وعيا، لكنه لا يتحرك بالسرعة التي تتطلبها الأزمة التي صنعها بيديه. تعقد الحكومات مؤتمرات، وتعلن الشركات "حيادا كربونيا" بعد عقود، فيما عقارب الزمن المناخي تمضي بلا انتظار. بلغ العالم لحظة غريبة في تاريخ البشرية نمتلك فيها المعرفة الكاملة تقريبا عما يحدث، ولدينا الأدوات والتقنيات لتغيير المسار، لكننا محاصرون بعجز جماعي يشبه الإنكار. إذ أصبح العالم يكتفي بمشاهد الكارثة وتحليلها، بينما تتسع أمامنا الفجوة بين الإدراك والفعل.
من هذا الواقع القاتم ينطلق تقرير دولي جديد، يحذر من أن الأرض تسير في طريق خطير، لكنه طريق لا يزال في الإمكان تغييره. فالعلم – على الرغم من نبرته التحذيرية – لا يزال يرى بصيص أمل، شريطة أن يتحول الإدراك إلى فعل، وأن تترجم المعرفة إلى إرادة سياسية واقتصادية حقيقية قبل أن تغلق نافذة الإنقاذ الأخيرة.
وتشير بيانات التقرير الى أن عام 2024 كان العام الأشد حرا في السجلات البشرية، وربما الأشد على مدار 125 ألف سنة عام. فالمؤشرات الكوكبية التي اعتمد عليها التقرير – وعددها 34 مؤشرا يعبر كل منها عن إحدى "علامات الحياة" لكوكب الأرض – تظهر أن 22 منها وصلت إلى مستويات قياسية جديدة. وهذا يعني، بلغة العلم الباردة، أن الكوكب قد دخل فعليا مرحلة الخطر البيئي العميق.
لكن التقرير لا يتوقف عند التحذير، بل يقدم تحليلا سببيا لما يسميه الباحثون "المسار السريع نحو الفوضى المناخية"، وهو وصف دقيق يعبر عن تفاعل معقد بين عوامل طبيعية وبشرية متشابكة من تراكم الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي إلى فقدان الغطاء الجليدي، ومن اضطراب التيارات البحرية إلى ارتفاع حرارة المحيطات واتساع موجات الجفاف والحرائق في القارات. هذا التفاعل المتسلسل، كما يوضحه التقرير، لا ينتج آثارا متفرقة، بل سلسلة مترابطة من الانهيارات الجزئية في منظومات المناخ، تؤثر في أنماط الأمطار، ومستويات البحار، وخصوبة التربة، واستقرار المجتمعات البشرية في آن واحد.
ويقدر العلماء في التقرير أن غياب استراتيجيات فعالة للحد من هذه التغيرات سيؤدي خلال العقود المقبلة إلى أخطار متسارعة تهدد الأنظمة السياسية والصحية والبيئية في مختلف أنحاء العالم. فالخطر المناخي لم يعد مسألة بيئية صرفة، بل أصبح تحديا بنيويا يتعلق بقدرة الحضارة البشرية على الصمود أمام اضطرابات مناخية متزايدة القوة والامتداد. فارتفاع درجة حرارة الأرض بما يتجاوز عتبة الدرجتين المئويتين سيؤدي – وفق النماذج المناخية الحديثة – إلى مضاعفة الظواهر المتطرفة، من أعاصير وفيضانات وحرائق، وإلى فقدان هائل في التنوع الحيوي، وتراجع إنتاج الغذاء في مناطق شاسعة من العالم. هذه السيناريوهات ليست احتمالات بعيدة، بل مؤشرات بدأت تتجلى في مشاهد واقعية خلال عامي 2024 و2025، كما توثقها البيانات التفصيلية التي يعرضها التقرير.