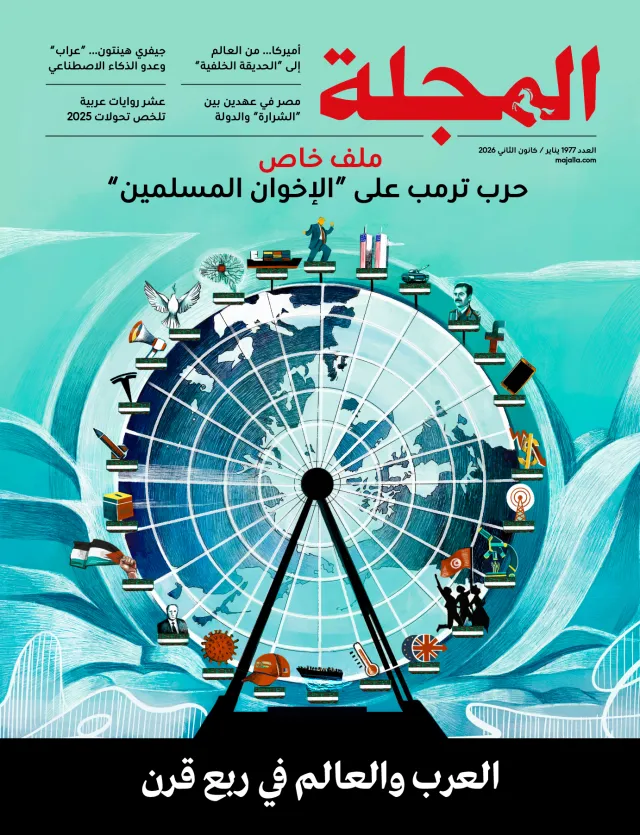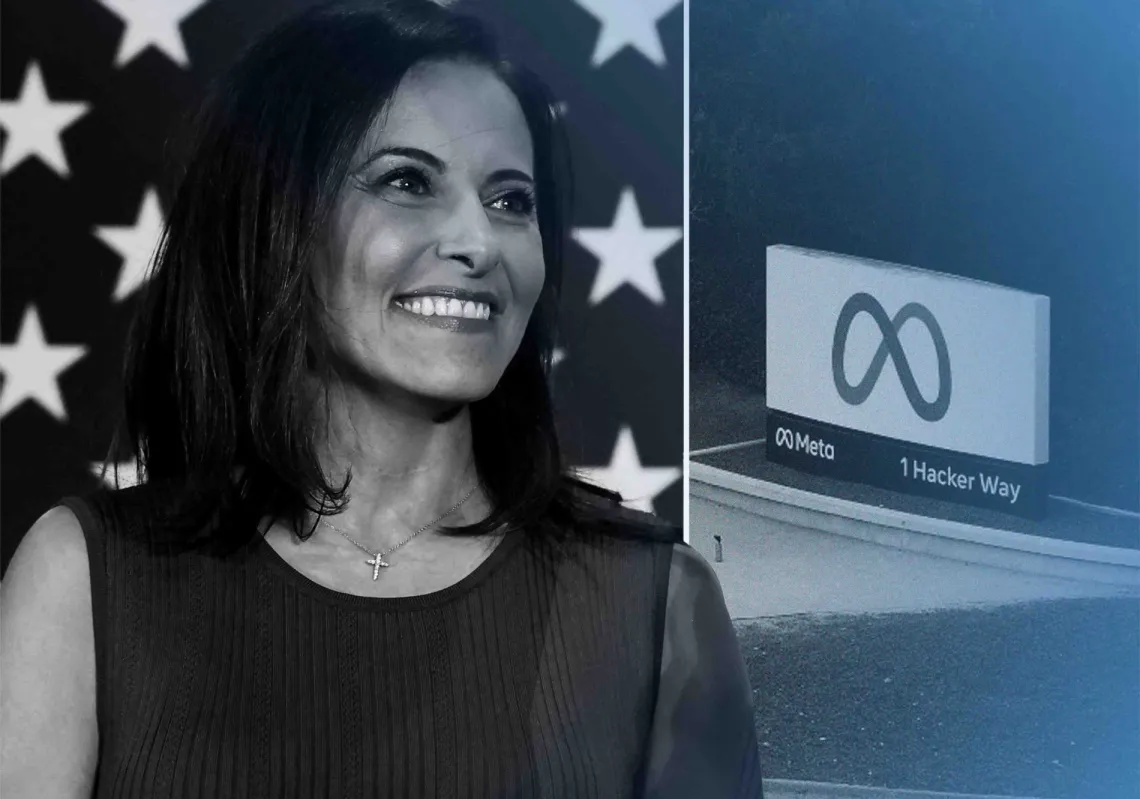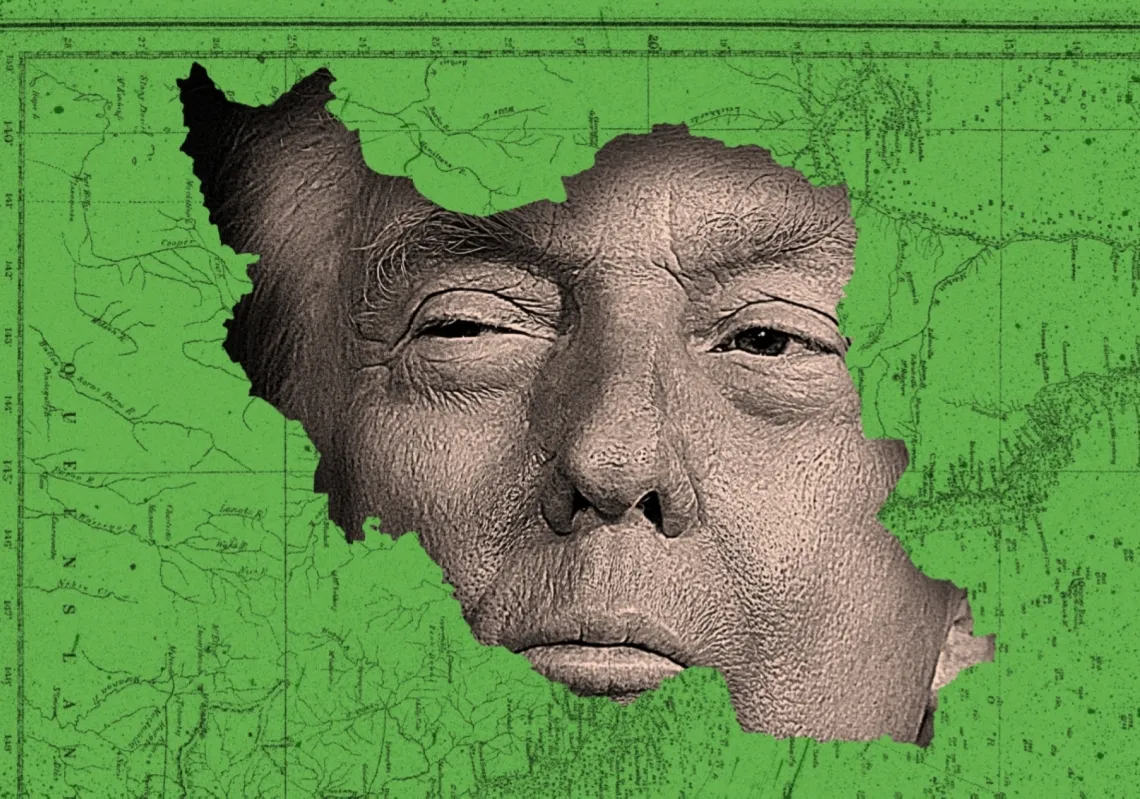لن يتحقق السلام في السودان بالصدفة، أو عبر تسوية سياسية تُصاغ تحت ضغوط أجنبية، أو بجولة جديدة من مساومات وصفقات النخب. فالأمر يتطلب أكثر من مجرد مفاوضات. إنه يحتاج إلى نظام سياسي مبني على السيادة وإصلاح للقطاع الأمني ومساءلة وطنية. ما يحتاجه السودانيون هو مواجهة الأسئلة الراهنة الصعبة.
إذا أراد السودانيون إنهاء الحرب الكارثية وتجنب الانزلاق نحو اللادولة، يجب على المجتمع السياسي مواجهة خمسة أسئلة أساسية بصدق وشجاعة. معالجة هذه الأسئلة ليست ترفا أكاديميا، بل هي الأساس لبناء السلام واستعادة استقرار الدولة. الاستمرار في تجنبها لم يعد خيارا، وأي عملية سياسية تتجنبها هي استسلام متعمد للتفكك والصوملة.
تتلخص هذه الأسئلة الخمسة في الآتي:
· ماذا نصنع بالجيش السوداني؟
· ماذا نصنع مع قيادة الجيش الحالية؟
· ماذا نفعل بميليشيا "قوات الدعم السريع"؟
· كيف نتعامل مع الحركة الإسلامية في السودان؟
· ماذا نفعل بشأن الأجندات الخارجية والإقليمية التي تغذي الحرب؟
لا يمكن تأجيل هذه الأسئلة إلى ما بعد الحرب، لأن الإجابة عليها حاسمة، وتجنبها هو ما قاد السودان إلى الحرب أصلا.
1. ماذا نصنع بالجيش السوداني؟
سيظلّ للسودان جيش، هذا أمر لا جدال عليه. فوجود الدولة الحديثة يعتمد على امتلاكها قوة نظامية تحتكر أدوات العنف المشروع داخل حدودها، وهو تعريف الدولة في الفكر السياسي من ماكس فيبر إلى كلاوزفيتز. الجيش ركن بنيوي في هيكل الدولة، وفي غيابه تنزلق الدولة إلى كانتونات مسلحة وميليشيات متناحرة وأمراء حرب. دور الجيش في صورته الصحيحة هو أن يحمي النظام السياسي ولا يصادره، وأن يصون الدولة ولا يحكمها. السؤال الحقيقي ليس إن كان يجب أن يكون للسودان جيش قوي، فهذا أمر مفروغ منه، السؤال هو: أي جيش نريد؟ وبأي عقيدة وقيادة واقتصاد وإطار مساءلة.
كان الجيش السوداني، عبر تاريخه، مؤسسة دولة وفاعلا سياسيا في آنٍ واحد؛ يتدخل في الحياة العامة وينفذ الانقلابات. هذا التداخل أضعف الجيش نفسه قبل أن يضعف الدولة، وأفقده صفة الحياد. ولكن الجيش لم يُخلق سياسيا بطبيعته، بل جرى تسييسه عبر عقود من تراكم النزعات السلطوية، والتلاعب السياسي والأيديولوجي وضعف أنظمة الحكم المدنية.
إصلاح الجيش اليوم ليس انتقاما، بل هو عملية إنقاذ ذات غايتين: إنقاذ الدولة من التفكك، وإنقاذ المؤسسة العسكرية من الانهيار المؤسسي، عبر استعادة احترافيتها وتثبيت دورها الطبيعي. يتطلب هذا إطارا وطنيا، حيث تحدد السلطة المدنية أهداف الأمن القومي، ويوكل للمؤسسة العسكرية تنفيذها.

ولتحقيق ذلك، لا بد من بناء أسس واضحة منذ الآن، تشمل:
· إعادة هيكلة مهنية شاملة: تحديث نظم التدريب، واعتماد التوظيف والترقي على أسس الكفاءة ورفض دعوات الهيكلة الإثنية والجهوية.
· رقابة مدنية وطنية: تتحقق عبر توافق وطني ودستور دائم يحدد بوضوح موقع الجيش في جهاز الدولة وخضوعه لإسراف السلطات المدنية المنتخبة.
· تنظيم النشاط الاقتصادي العسكري: تحديد حدود الاستثمار العسكري قانونيا، وإخضاع الشركات العسكرية للرقابة والشفافية لمنع تضارب المصالح.
هذه التدابير ليست عقابا للجيش، بل شرط ضروري لإنقاذ الدولة وضمان قيام جيش وظيفته الحماية وليس الوصاية، وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية مستقرة.