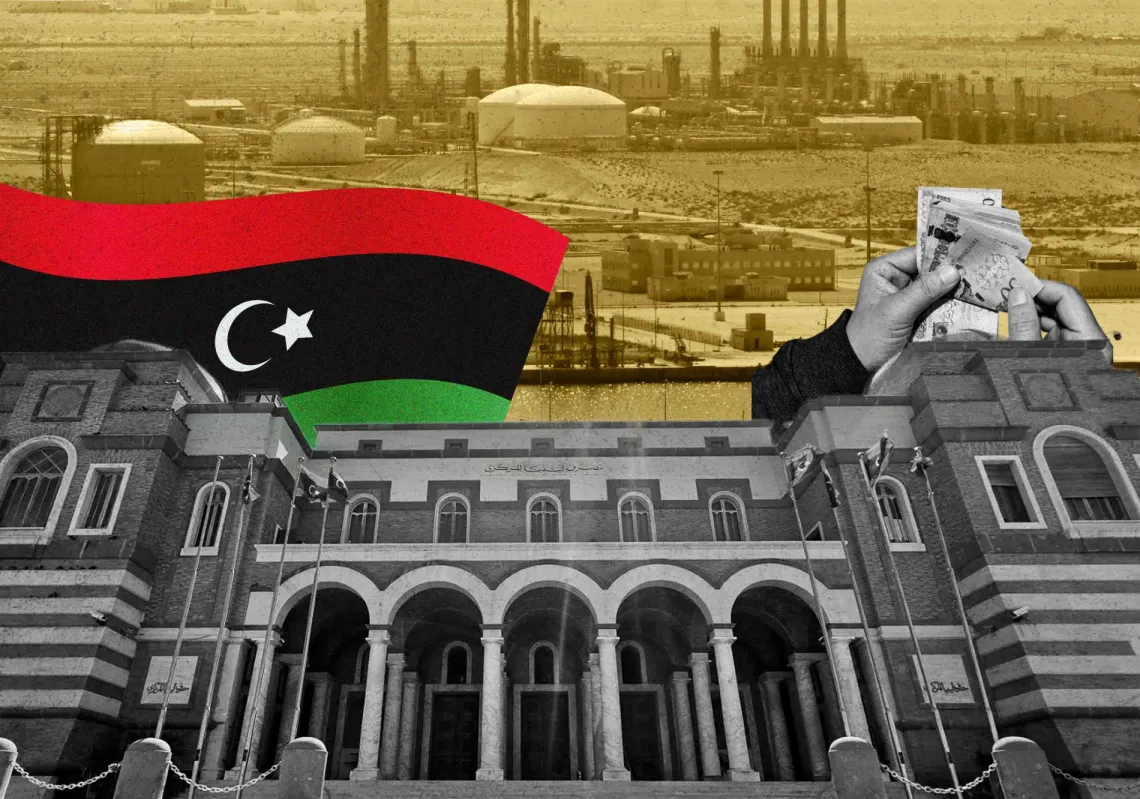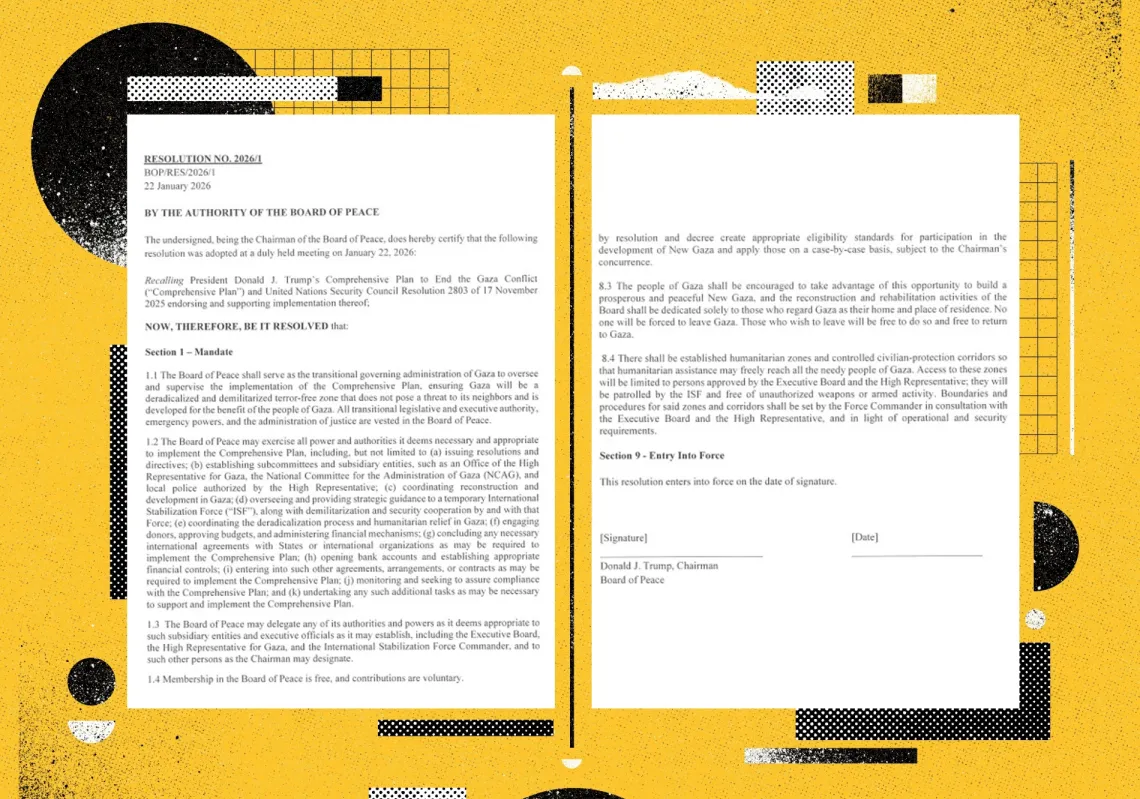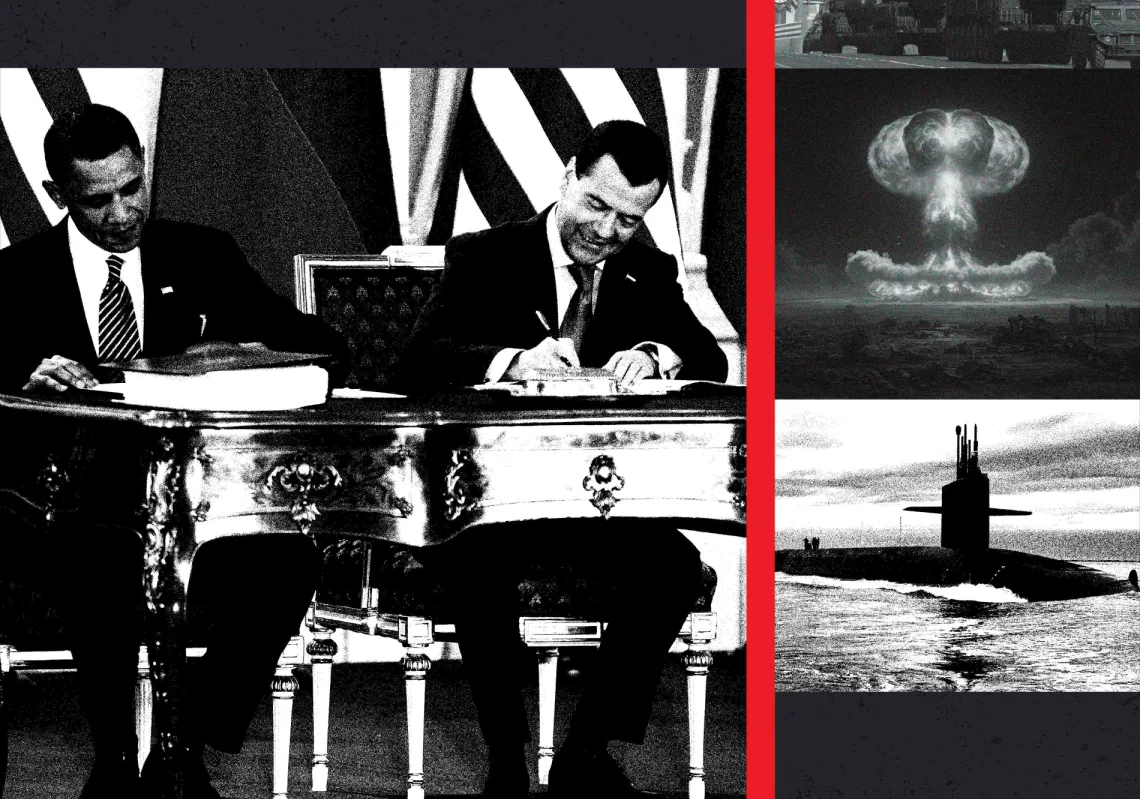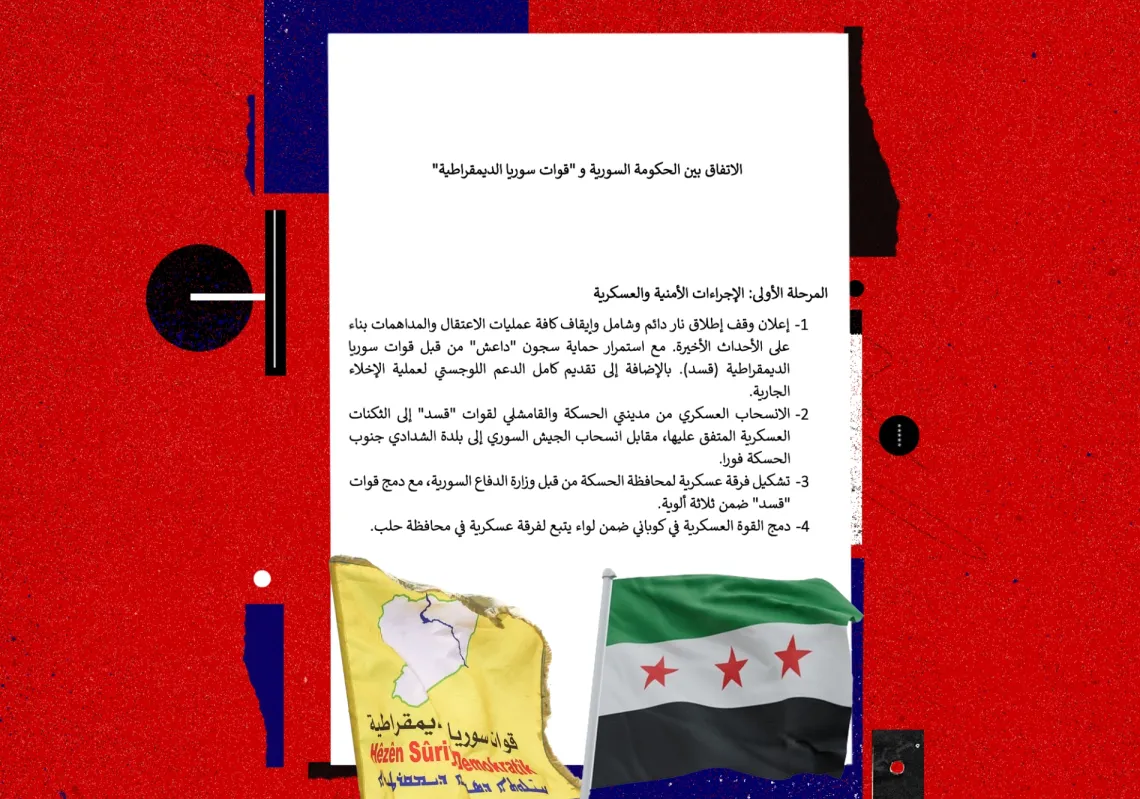منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل/نيسان 2023، انفتحت البلاد على واحدة من أعقد أزماتها وأكثرها مأساوية في العصر الحديث. ملايين النازحين واللاجئين، مجاعة متعمدة يتم استعمالها كسلاح حرب، تضعضع أركان مؤسسات الدولة، وصراع مسلح يتغذى على الولاءات الإثنية والجهوية.
في مواجهة هذا الواقع، لجأ كثير من السودانيين إلى التاريخ، باحثين عن مقارنات ومقاربات، فاستدعى بعضهم الثورة المهدية، ودولة الخليفة عبد الله التعايشي، ليسقطوا وقائعها في مقاربة مع جرائم "ميليشيا الدعم السريع" الحالية، وهو ما أثار الكثير من اللغط والنقاش السياسي في وسائل التواصل مؤخرا. غير أن هذا الإسقاط يتم عبر مغالطة معرفية، تجعل من أحداث القرن التاسع عشر، مرآة حرفية لصراعات القرن الحادي والعشرين، من دون انتباه كافٍ للفوارق الزمنية والسياقية.
لتناول هذا التاريخ، لا بد من الفصل بين مرحلتين مختلفتين، الثورة المهدية (1881–1885) التي جسدت لحظة تحرر وطني جامعة، والدولة التي ورثها الخليفة عبدالله التعايشي (1885-1898) والتي تحولت إلى كيان سلطوي قائم على المحسوبية والقمع.
وُلد محمد أحمد المهدي عام 1844 في شمال السودان، ونشأ في بيئة متأثرة بالتصوف والطرق الدينية. منذ شبابه كان ناقدا لفساد الحكم التركي–المصري، وكثرة الضرائب التي أنهكت الناس. أعلن مهدويته في 1881، فالتف حوله السودانيون من مختلف القبائل، ليصوغ خطابا جمع بين البعد الديني والبعد التحرري.
استطاعت الثورة أن توحّد بين فئات شديدة التنوع في مواجهة الاستعمار، وأن تحقق نصرا هائلا بتحرير الخرطوم في يناير/كانون الثاني 1885 وقتل الجنرال البريطاني غوردون، لتصبح أول حركة تحرر أفريقية كبرى في الحقبة الاستعمارية، تنتصر في عهد التدافع على أفريقيا (The Scramble for Africa) والذي دشنه "مؤتمر برلين" للقوى الاستعمارية في عام 1884.
غير أن وفاة المهدي بعد شهور قليلة فتحت الباب أمام تحولات حاسمة. تولى الخليفة عبد الله التعايشي الحكم، وكان هو أول من بايع المهدي في بداية ثورته، بل إن مصادر كثيرة تذكر أنه لعب دورا حاسما في إقناع المهدي بإعلان مهدويته، وساعده بعد ذلك في تثبيت دعوته، إلا أن شخصية الخليفة اتسمت بحدة الطبع وكثرة الشكوك، وقد سعى لتثبيت سلطته عبر القمع والاستبداد، ووراثة الخطاب المقدس الذي نسب إليه العصمة، وجعل طاعته واجبة كما لو كانت طاعة للمهدي نفسه، وهو ما كان قد أقره له المهدي في منشور شهير عام 1883.
أدار الخليفة الدولة بمنطق يعتمد على الولاءات القبلية، اعتمد فيه على تقريب أهله من قبائل البقارة، وتو، ما أثار حفيظة مجموعات أخرى مثل الجعليين والشايقية في شمال السودان. ولجأ الخليفة عبدالله إلى فرض الضرائب الباهظة، وهو ما أثار نقمة الناس عليه، كما أدى إهمال الزراعة إلى مجاعة سنة (1889-1890) التي قتلت مئات الآلاف. تفشت الأوبئة، وتراجعت التجارة بفعل العزلة التي فرضتها الدولة.