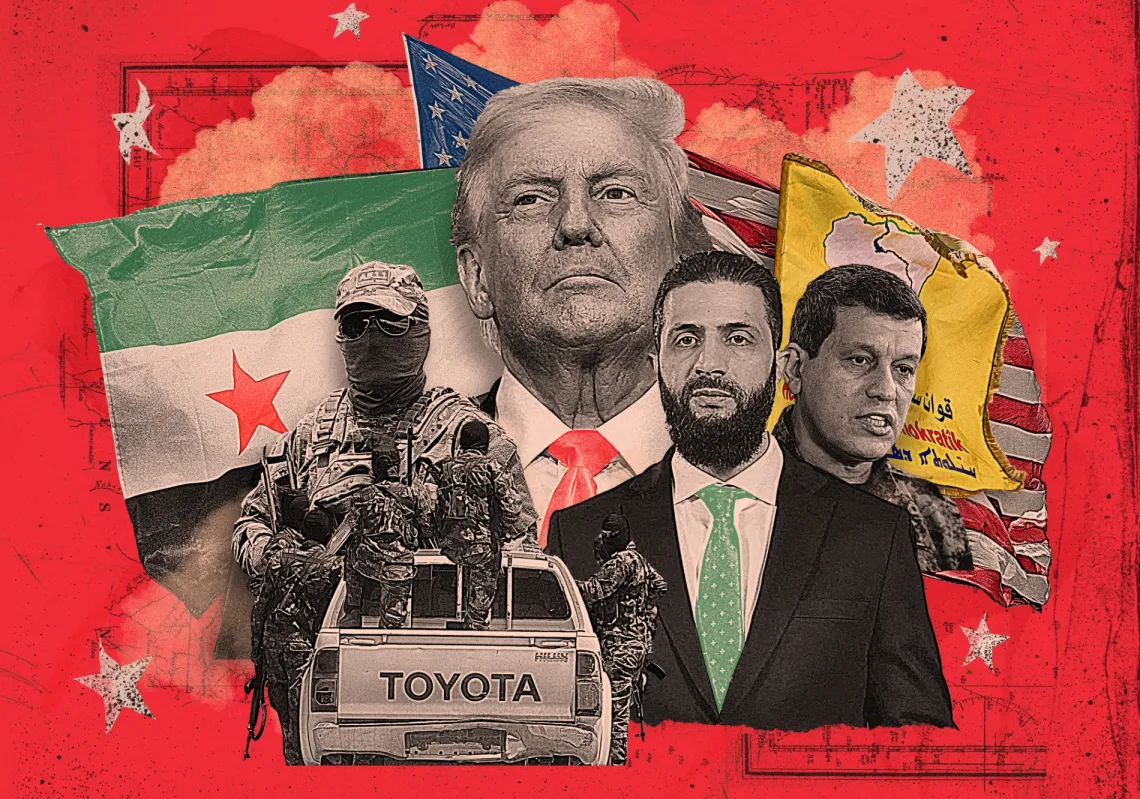خلال حرب الإبادة التي لم تتوقف رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصوري عن وقف إطلاق النار، تعاظم التضامن الإنساني في دول العالم رفضا للمجازر ولعمليات القتل الممنهجة والتصفية الشاملة للبشر والحجر في قطاع غزة.
صاحب الغضب على جرائم الاحتلال الإسرائيلي تنامي شعور قهري بضرورة التحرك لفعل شيء من شأنه أن يفضح هذه الجرائم. وفي سياق مواز، إنما لا يقل أهمية في سياق نشاطات المقاطعة والتظاهر والاحتجاج السياسي، استدعي الأدب والفن لتعزيز سردية الضحية في كشف زيف سردية الجلاد. فالأصوات التي تكتب من غزة وتلك التي تصور وترسم وتسجل المعاناة خلال حرب الإبادة قادرة على تقديم شهادات حية وموثقة من قلب اللهب. وفيما تكمن قوة هذه النصوص أو الأعمال الفنية في أنها تصهر ذاتها من أتون الإبادة وتصوغ أدواتها من فوهة البركان، إلا أن عمليات ترويجها وربما "تسويقها" عكست "مغالاة" افتقرت للحس الأدبي والفني، بل وعملت أحيانا على تجاهلهما بغية تأكيد مشروعية النتاجات الأدبية والفنية المتبناة وفق منظومة وشبكة متداخلة من العلاقات العامة والشخصية.
صورة مغلوطة
وبدلأ من أن يصبح الفن والأدب هو حامل حكاية الناجين، صارت خطابات التضامن ومروجوها وربما العاملين فيها هي حاملة هذين الأدب والفن. في هذه العملية تطورت صناعة جديدة تكمن في صناعة أدب وفن الإبادة ليس وفق ما ينتجه الكتاب الحقيقيون أو الفنانون العاملون في غزة تحت النيران، بل وفق أسس ومعطيات يصوغها المروجون ضمن "ماكينة" صناعة التضامن، التي ليست في الحقيقة إلا رومانسية وعاطفة بحتة في التعاطي مع الإبادة الجارية، ويمكن لمن عاش الإبادة، مثلما فعلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى منها، أن يقول إنها رومانسية محمودة مع ذلك.
إلا أن هذه الخطابات مست جوهر الإبداع الفلسطيني وكنهه، وقدمت صورة مغلوطة في الكثير من السياقات عن المنتج الفني والأدبي في قطاع غزة. يكمن جوهر التضامن في التعبير عن الغضب مما يجري وإعلان مساندة الضحية، لذلك وبغية تحقيق أكبر قدر من الفعالية يوظف كل شيء، والكتابة والفنون البصرية والسمعية هما الأقدر على تقديم حياة الناس ببعدها الإنساني. وهذا الفهم هو الذي دفع بعد فترة من حرب الإبادة إلى الالتفات للمنتج الأدبي والفني في غزة وتقديمه ضمن خطاب التضامن كشاهد على الإبادة.