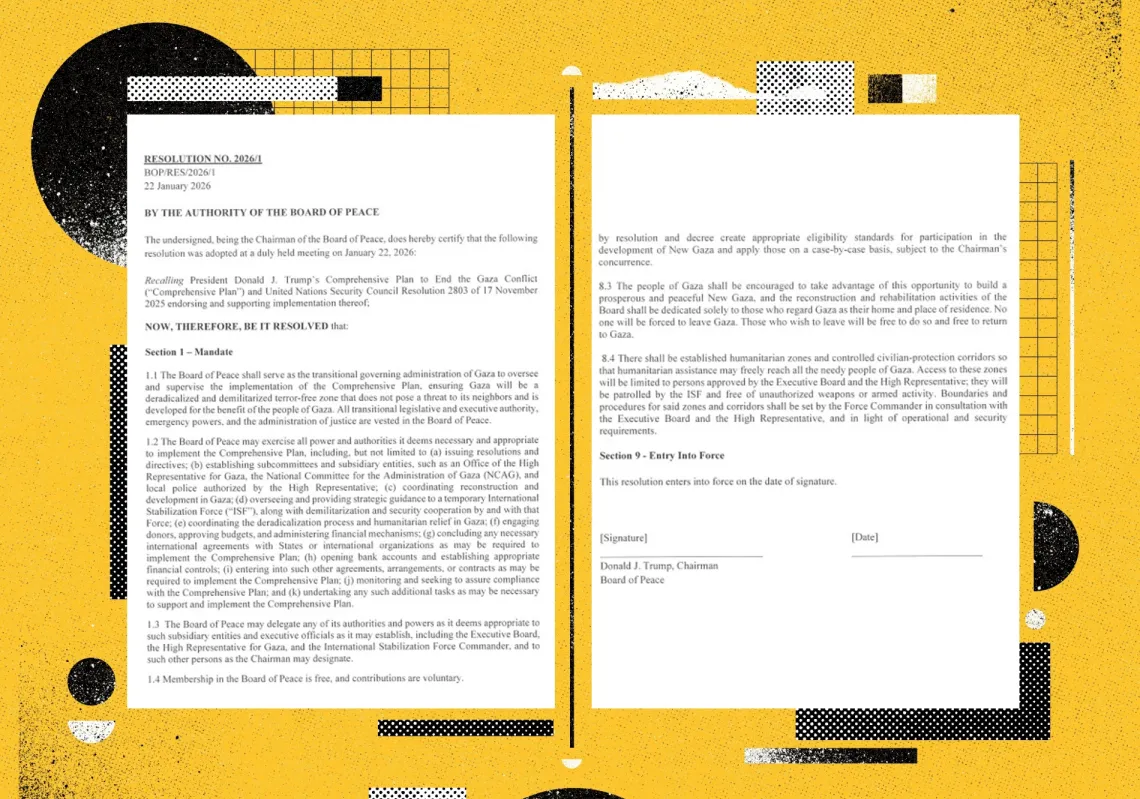قبل أربعة عقود تأسّست "حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين" (حماس)، مع مطلع الانتفاضة الأولى (1987-1993)، بيد أن ذلك لا يعني أنها نشأت من فراغ، إذ إنها انبثقت من جماعة "الإخوان المسلمين" في فلسطين، وتطورت كامتداد لها، من جهة البنية والممارسة والتفكير السياسي والتركيبة القيادية.
وقد يكون ذلك هو ما يفسّر إلى حد كبير الشعبية التي حازتها تلك الحركة، بحيث تمكنت من منافسة حركة "فتح" التي سبقتها بأكثر من عقدين، على القيادة والمرجعية والسلطة، في فترة زمنية بسيطة، في حين لم يستطع أي فصيل فلسطيني ذلك، ولا حتى بقية الفصائل جميعها.
التباسات التأسيس
ثمة مسألتان يفترض لفت الانتباه إليهما أيضا، الأولى، أن تلك الحركة لم تنخرط في الكفاح المسلح الفلسطيني، الذي انطلق في منتصف الستينات، فقد حصل ذلك بعد 22 عاما، في حين كانت قبل ذلك تركز على العمل الدعوي-الديني، باعتباره بمثابة "الجهاد الأكبر"، مقابل "الجهاد الأصغر" الذي كانت تقوم به "فتح" وباقي الفصائل الفلسطينية. والثانية، أن تلك الحركة لم تنضو في الإطار الجامع للحركة الوطنية الفلسطينية، أي في "منظمة التحرير"، بل إنها عدت نفسها بديلا لها على كافة المستويات، مع كل تلك التعقيدات والتداعيات السلبية التي نجمت عن ذلك، والتي عكست نفسها، فيما بعد، في الخلافات الداخلية، وفي التنافس والتنازع بينها وبين "فتح"، بدلا من التركيز على القواسم المشتركة.
وكما هو معلوم فإن هذا الوضع أدى لاحقا إلى انقسام النظام السياسي الفلسطيني، بين سلطتي "حماس" في غزة، و"فتح" في الضفة، الذي استنزف جزءا كبيرا من الطاقة الكفاحية لشعب فلسطين، وقيد إمكان تطور حركته الوطنية، وحد من قدرته على مواجهة التحديات الإسرائيلية.
ولعل أهم ما يجب إدراكه أن ولادة "حماس" أحدثت انشقاقا عموديا في الحركة الوطنية الفلسطينية التي باتت بمثابة حركتين، مع قيادتين ومرجعيتين، على أساسين وطني وديني، وهو أمر لم تعرفه الحركة الوطنية الفلسطينية في تاريخها، رغم خلافاتها السياسية، قبل النكبة وبعد النكبة.
ففي مراجعة تجربتها، في السياسة والمقاومة والسلطة، يمكننا ملاحظة أن "حماس" لم تحسم بين كونها حركة سياسية أو حركة دينية، ولا في طبيعتها بين كونها حركة وطنية، أو حركة للإسلام السياسي، أو بين مكانتها كحركة تحرّر أو سلطة، وأي جانب من الجوانب الثلاثة المذكورة يغلب على الآخر، لأن لكل طابع متطلباته، ووظائفه، واستهدافاته.
ومع الاعتراف بحق أي شخص، أو جهة، أو كيان سياسي، في انتهاج أية خلفية فكرية إلا أن المسألة هنا لا تتعلق بهذا الحق، ولا تمسّ به، بقدر ما تتعلق بجدوى أو مغزى تأكيد "حماس" طابعها، أو تمييز نفسها، كحركة إسلامية، كأن هذا التميز يحجب الإسلام عن الفصائل الأخرى، أو يخرجها منه، علما أن الخلفية الإسلامية حاضرة في فكر "فتح"، مثلا، بما لا يقل عن حضورها لدى "حماس"، مع تمسكها بكونها حركة سياسية وطنية لكل الشعب الفلسطيني، من دون أي تمييز.