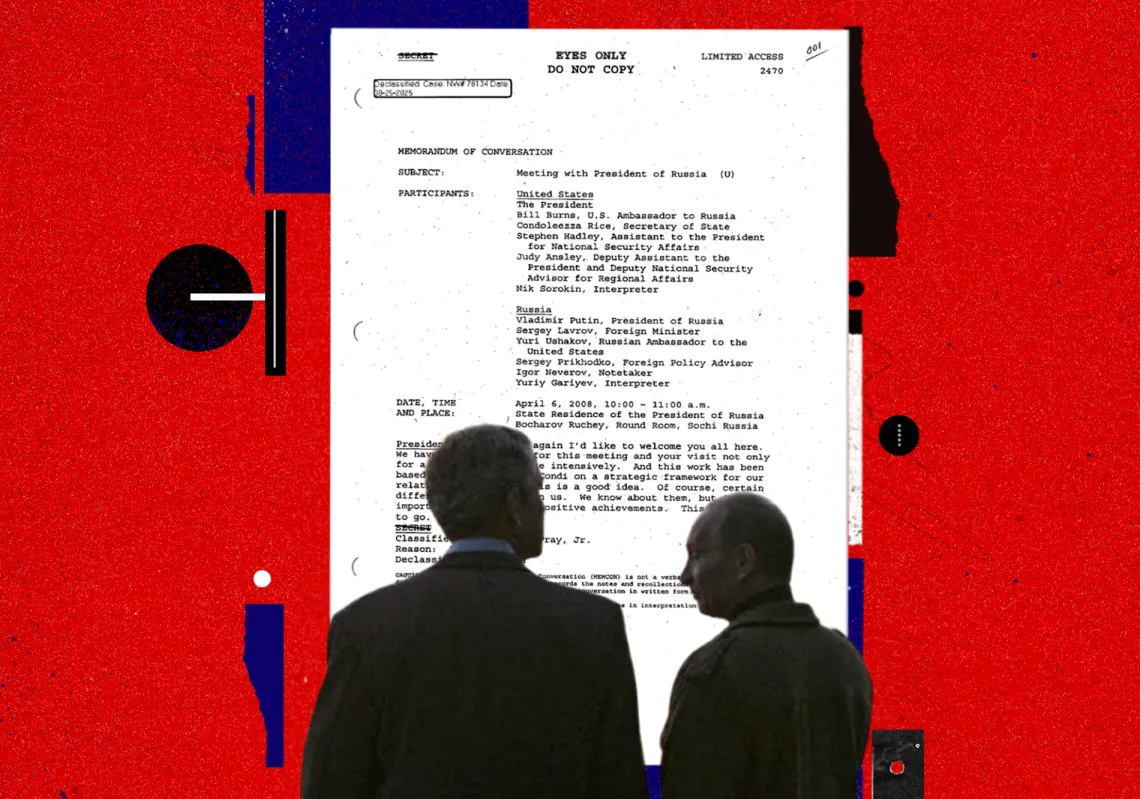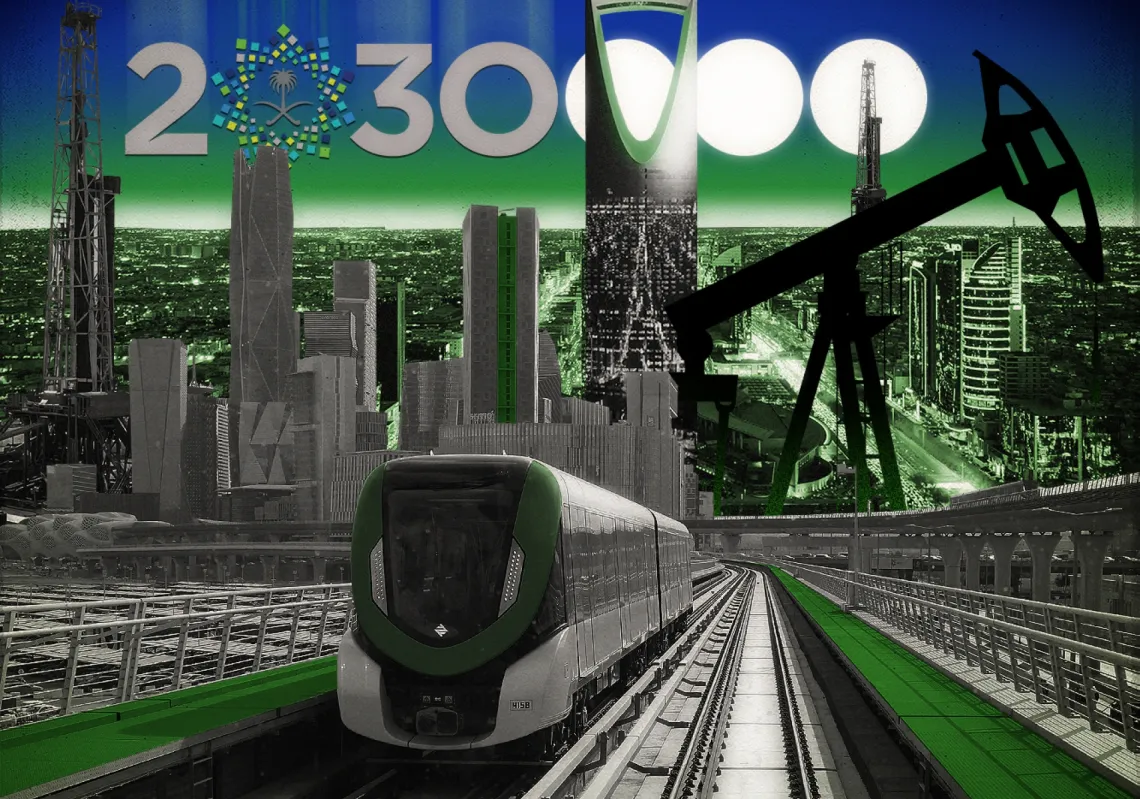عندما أعود إلى اللحظات الأولى من بدء التحشيد، لإسقاط نظام حكم صدام حسين، والتي عايشتها بكل تفاصيلها من داخل العراق، كانت مشاعرنا تطغى بقوة على أي تفكير، بما يمكن أن يكون العراق من دون حكم "البعث". كان الأمل ولا شيء غير الأمل والأحلام، بأن نشهد هذه اللحظة التاريخية.
المفارقة أن الرغبة بالخلاص من الحكم الدكتاتوري، كانت مشحونة بالآمال بمستقبل أفضل. كيف لا تكون كذلك، وقد كنا نعيش في نظام شمولي، كما وصفته حنا آرندت، حوّلنا إلى ذرات هائمة تعيش ليومها، وتفقد كل اهتمام بالشأن العام أو المستقبل، وكان الأمل في الإصلاح ميتا في داخلنا.
ولكن، لم نكن نتوقع أنه بعد أكثر من عشرين عاما على سقوط الدكتاتورية وتبني نظام "ديمقراطي" لنعود إلى الهواجس نفسها بشأن مستقبل ينتظر العراق، وهل هناك أمل في إصلاح ما أفسدته طبقة حاكمة، فشلت في تجاوز أخطاء الدكتاتورية، ورسخت سطوتها ونفوذها بقوة السلاح والمال السياسي والدعم الخارجي. ولننتقل من دكتاتورية الزعيم والقائد الأوحد، إلى حكم الزعامات بغطاء "الشرعية الانتخابية".
بينما كنتُ أستذكر سنتين بعد العشرين عاما على تغيير النظام السياسي في العراق، استحضرتُ مقولة امرأة من جنوب العراق، ومن عائلة نالت نصيبها من الإعدام والتهجير والحرمان في زمن الدكتاتورية، إذ اختزلت تلك المرأة سردية سنوات التغيير عندما سُئِلَت: "ما رأيكِ بنظام صدّام؟". قالت: "صدّام قتل أولادنا، دمّرنا، جوّعنا، هجّرنا". وعندما سُئِلَت: "ما رأيكِ بِمَن يحكم اليوم؟". أجابت: "صخَّم الله وجههم، لأنهم بيّضوا وجه صدّام".
على الرغم من أن موقفي من إسقاط النظام الدكتاتوري لم يتبدّل، إذ لو عاد بنا الزمان إلى التاسع من أبريل/نيسان 2003، مع علمي المسبق بأن يكون حالنا على ما هو عليه اليوم، لما ترددتُ لحظة واحدة بالقول: "ليحدث ما يحدث، ولا نبقى تحت رحمة نظام حكم دكتاتوري شمولي". لكن لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن أجد كلمات تعبّر عن الخيبة والخذلان التي سببتها تراكمات أخطاء الطبقة السياسية بفسادها وفشلها، والتي جعلتنا نشعر بضياع دولة بأكملها، وبات حلم كل عراقي أن يعيش في ظل دولة بمعناها الحقيقي، لا دولة تحكمها مافيات وميليشيات.