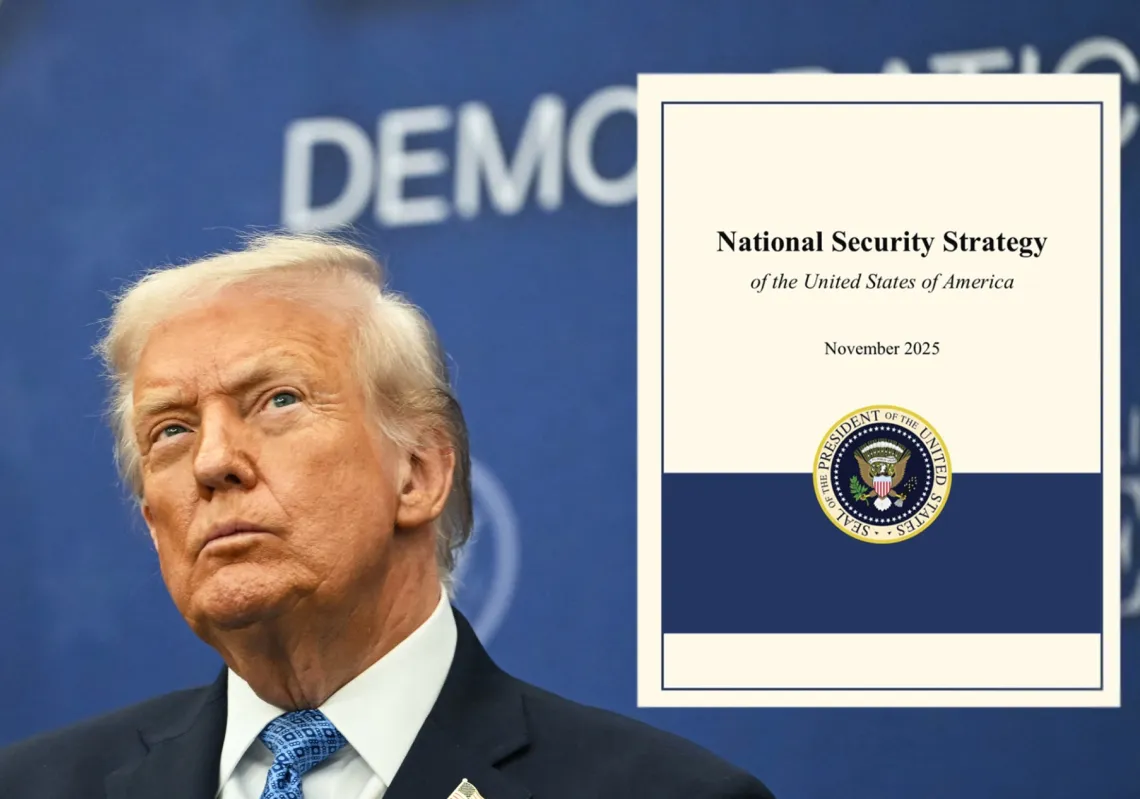في سجلات الدبلوماسية الدولية الحديثة، ثمة تطورات قليلة قادرة على حمل الثقل الرمزي والعملي للانسحاب الهادئ لقوة عظمى، لا سيما بعد أن وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب في دافوس الميثاق التأسيسي لـ "مجلس السلام" الذي أنشأه. وبينما تمضي الولايات المتحدة في خروجها من 66 منظمة دولية (31 كيانا تابعا للأمم المتحدة و35 هيئة عالمية أخرى) فإنها لا تقلص عضويتها في تلك الهيئات فقط، بل سيرخي انسحابها بظلال تمتد أبعد من ذلك بكثير. إنها تفكك ركائز أساسية للهيكل الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، والذي ساهمت ذات يوم في تصميمه وإضفاء الشرعية عليه ودعمه.
إن الاحتضان المتجدد لشعار "أميركا أولا" في ظل إدارة ترمب (الذي يستهدف المؤسسات التي تتعامل مع تغير المناخ والتجارة والتنمية والقانون الدولي) لا يشكل قطيعة مفاجئة بقدر ما هو تسارع لمسار طويل الأمد أشار إليه علماء العلاقات الدولية منذ فترة طويلة: التآكل التدريجي لنظام أحادي القطب يتمحور حول القيادة الأميركية وظهور عالم متعدد الأقطاب، يدور بشكل متزايد حول فضاءات النفوذ الإقليمية.
ورغم ما قد تحمله هذه اللحظة من زعزعة للاستقرار بالنسبة لأنصار التعددية، فإنها قد تنجلى عن فرصة لطالما أرجأها المجتمع الدولي: فرصة الاضطلاع بإصلاح جوهري لنظام دولي يتزايد اختلاله وشلله، مما يحول دون قدرته على الاستمرار. والسؤال المُلحّ الآن: هل يمتلك العالم الإرادة السياسية لاغتنام هذه الفرصة، أم إن الانسحاب الأميركي سيعجل ببساطة من انحدار النظام نحو حالة من التهميش؟
وُضع الأساس الفكري لهذا التحول في السياسة بوضوح في استراتيجية الأمن القومي الأميركي لعام 2025، التي صدرت في عهد الرئيس ترمب، التي تبيّن أن الانسحاب من المنظمات الدولية لم يكن نوعا من الاندفاع أو التهور، بل هو تنفيذ مدروس لعقيدة متماسكة، وإن كانت مثيرة للجدل. ترفض هذه الاستراتيجية النزعة الدولية الواسعة القائمة على القيم، وتُعلي من شأن المصالح الوطنية الضيقة، معلنة أن "أيام الولايات المتحدة التي كانت تدعم النظام العالمي برمته كمحيط لا ينفذ قد ولّت من غير رجعة"، مما يعني إعطاء الأولوية للسيادة والقوة الاقتصادية والهيمنة الإقليمية على حساب الحفاظ على نظام دولي ليبرالي. ويترجم هذا على أرض الواقع إلى علاقات ثنائية قائمة على المصالح المتبادلة، وشكوك عميقة تجاه القيود القانونية والمؤسسية الدولية.
وفي حين صورت استراتيجيات الأمن القومي السابقة المؤسسات العالمية كمنصات لا غنى عنها لحل المشكلات الجماعية، فإن استراتيجية الأمن القومي لعام 2025 تصورها كساحات يتضاءل فيها النفوذ الأميركي، أو حتى يُقوّض فعليا، من خلال الأيديولوجيات المتنافسة. ويتردد صدى هذا المنظور في وصف الرئيس ترمب المتكرر لمنظمات مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، بأنها "بيروقراطيات عالمية" لا تتوافق مع جوهر الأولويات الأميركية.