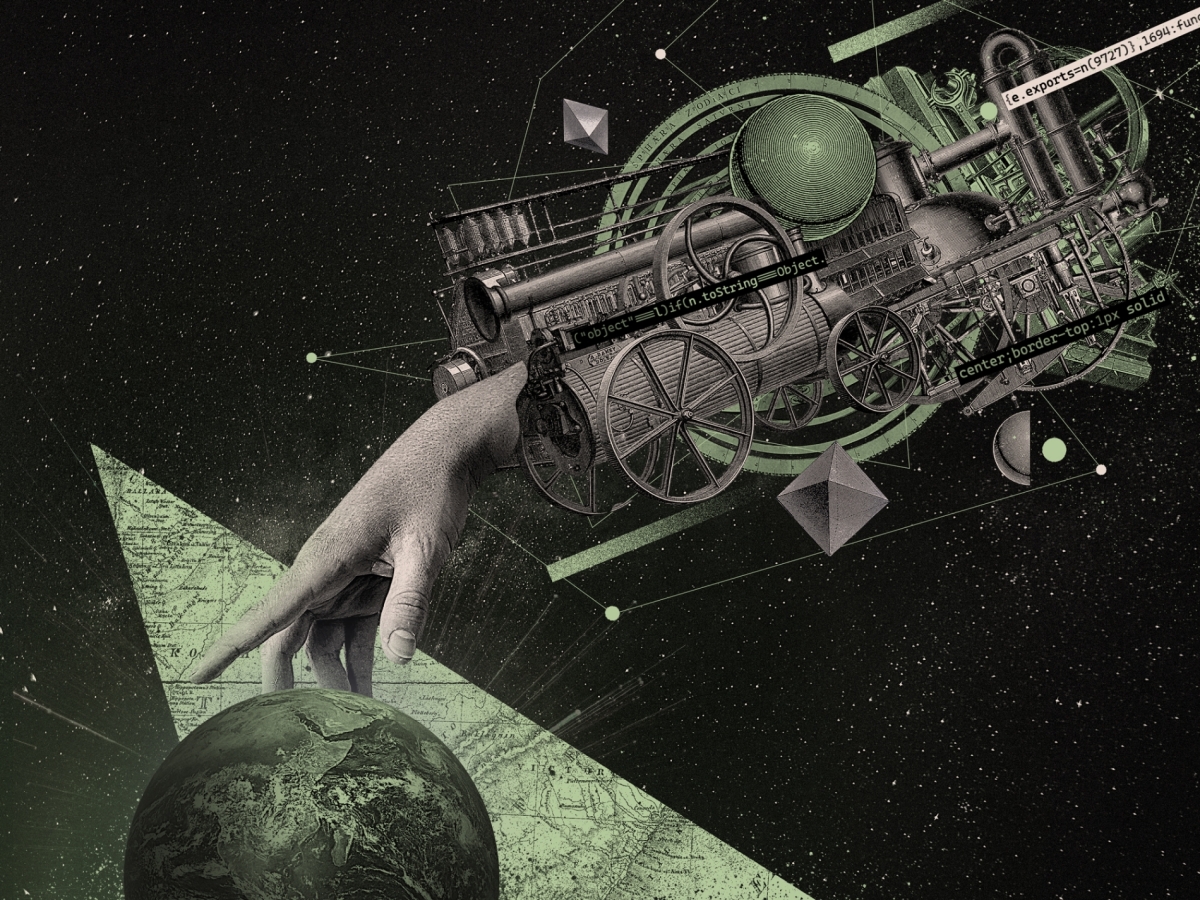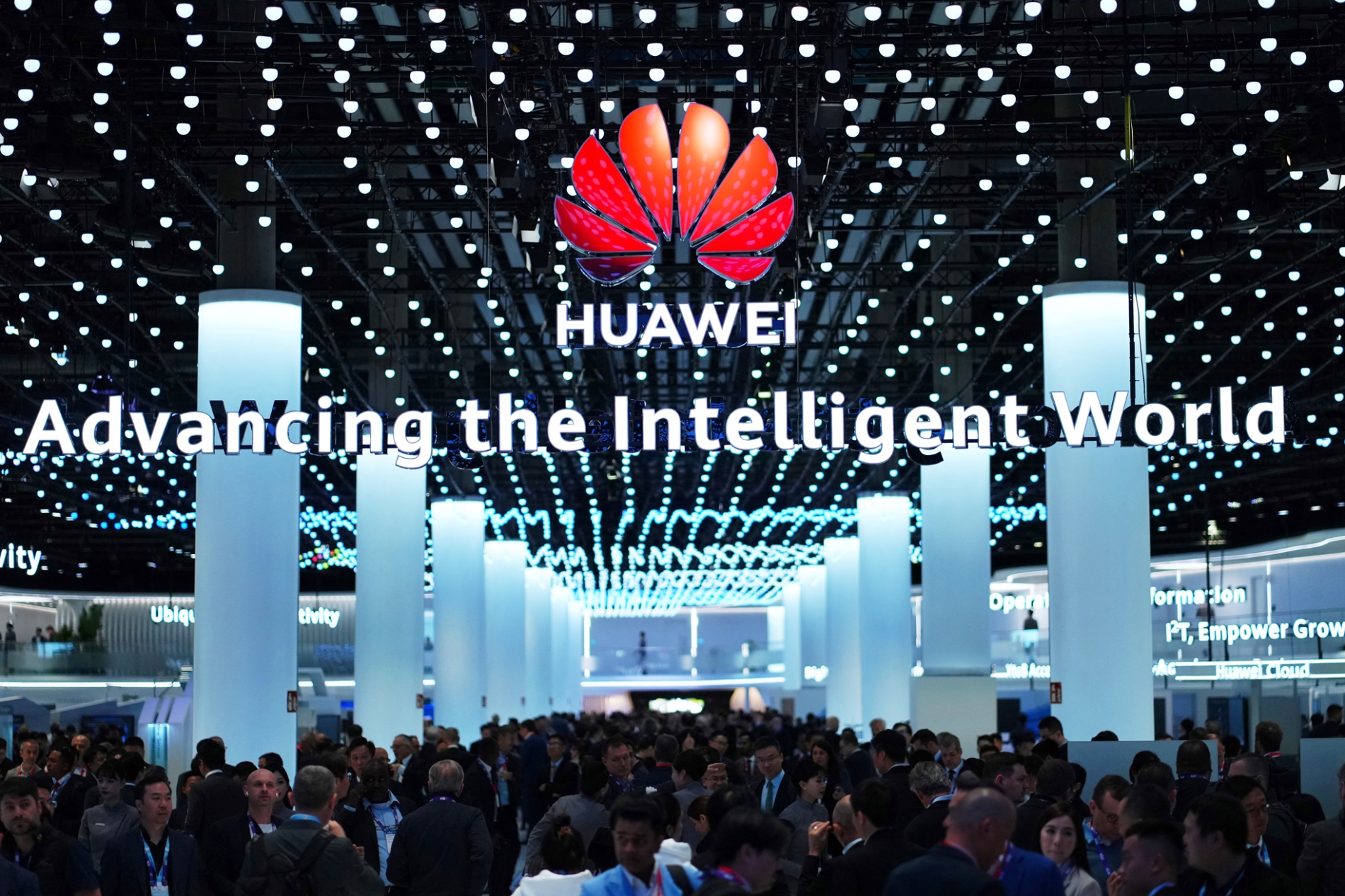تمثل دول الخليج حلقة محورية في استراتيجيا الصين التكنولوجية والاقتصادية، خاصة في تلك المرحلة التي تتسم بتصاعد القيود الغربية على تدفقات رأس المال والتقنيات المتقدمة.
فالصناديق السيادية الخليجية تعد من الأكبر والأكثر سيولة على مستوى العالم، إذ تدير مجتمعة أصولا تتجاوز 4 تريليونات دولار، مما يمنحها قدرة استثنائية على الدخول في استثمارات طويلة الأجل وعالية الاخطار نسبيا، وهو ما تحتاجه الصناعات التكنولوجية الثقيلة مثل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والبنية التحتية الرقمية. ويبرز في هذا السياق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تجاوزت أصوله 913 مليار دولار ويقود تحولات كبرى في قطاعات التقنية والطاقة والنقل، إلى جانب جهاز أبو ظبي للاستثمار، الذي يدير ما يقارب تريليون دولار ويعد من أكثر الصناديق خبرة في الاستثمار الاستراتيجي العالمي. بالنسبة إلى بكين، لا تمثل هذه الصناديق مجرد ممول مالي، بل تمثل شريكا قادرا على توفير رأس مال مستقر يعوض جزئيا القيود الأميركية والأوروبية المتزايدة على تمويل الشركات الصينية العاملة في المجالات الحساسة.
ولا تقتصر جاذبية الخليج للصين على العامل المالي وحده، بل تمتد إلى كونه من أسرع الأقاليم عالميا في تبني الحلول الذكية والتقنيات الناشئة على نطاق واسع. فدول الخليج، بحكم طبيعة مدنها الحديثة، وكثافتها السكانية المنخفضة نسبيا، وقدرتها على اتخاذ القرار المركزي السريع، تشكل بيئة مثالية لاختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في مجالات مثل النقل الذاتي، والمدن الذكية، وإدارة الطاقة، والخدمات الحكومية الرقمية.
مزيج نادر
وقد وضعت الإمارات هدفا طموحا يتمثل في أن يشكل النقل الذاتي ربع إجمالي حركة النقل في حلول عام 2030، فيما تسعى السعودية إلى إدخال هذه التقنيات بنسبة 15 في المئة في مدنها الكبرى ضمن الإطار الأشمل لـ"رؤية 2030". هذه الطموحات تفتح الباب واسعا أمام الشركات الصينية، التي تمتلك خبرة عملية كبيرة في نشر حلول جاهزة ومجربة على نطاق واسع داخل السوق المحلية الصينية، من دون التعقيدات التنظيمية التي تواجهها غالبا الشركات الغربية.
وبذلك، يوفر الخليج لبكين مزيجا نادرا من التمويل، وسرعة التبني، وسهولة التوسع، مما يسمح للصين بتحويل تقنياتها من مجرد منتجات محلية إلى معايير تشغيلية مطبقة دوليا.
وعلى المستوى الجيوسياسي الأوسع، تسهم هذه الشراكات في تعزيز مبادرة "الحزام والطريق" عبر إضافة بعد تكنولوجي رقمي إلى الممرات التجارية التقليدية، مما يوسع النفوذ الصيني من آسيا مرورا بالشرق الأوسط وصولا إلى أوروبا وأفريقيا، ليس فقط عبر الموانئ والسكك الحديد، بل أيضا عبر البنية التحتية الرقمية ومنصات الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، فإن هذه العلاقة ليست أحادية الاتجاه. فبالنسبة إلى دول الخليج، لم يعد التعاون مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي مسألة تنويع شراكات أو موازنة علاقات دولية فحسب، بل أصبح ضرورة اقتصادية مرتبطة مباشرة بتحقيق رؤاها التنموية الطويلة الأجل.