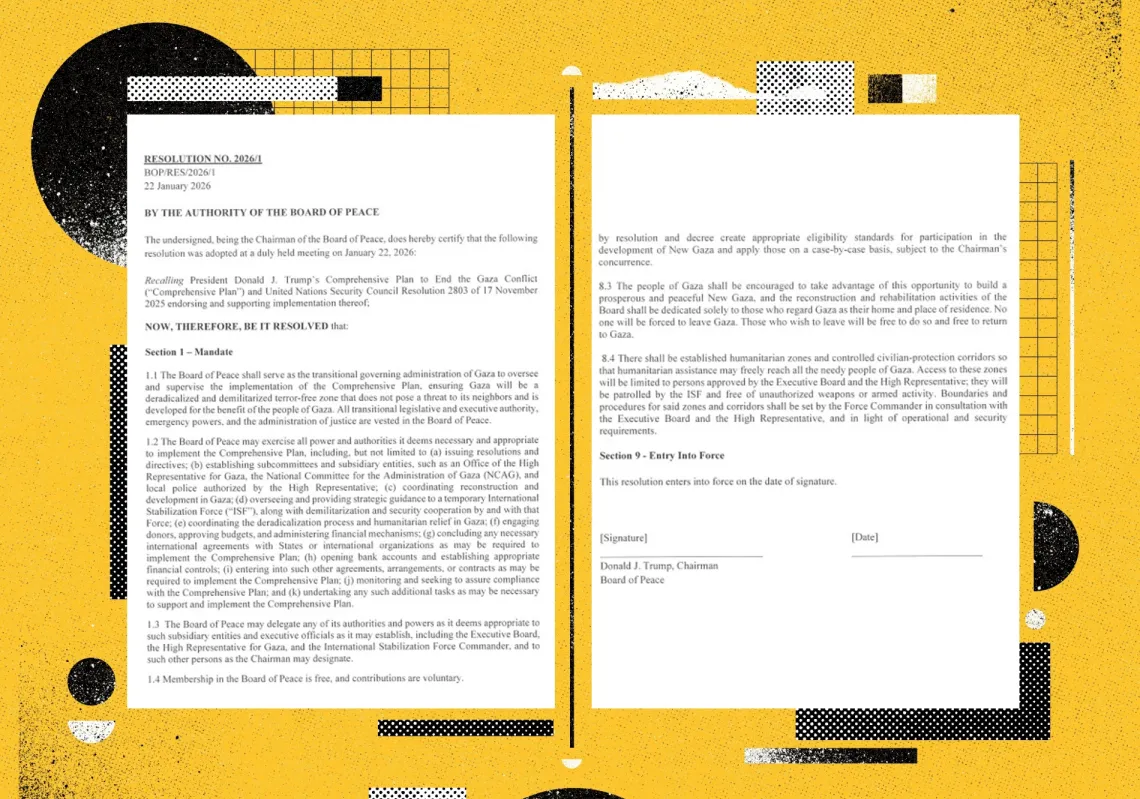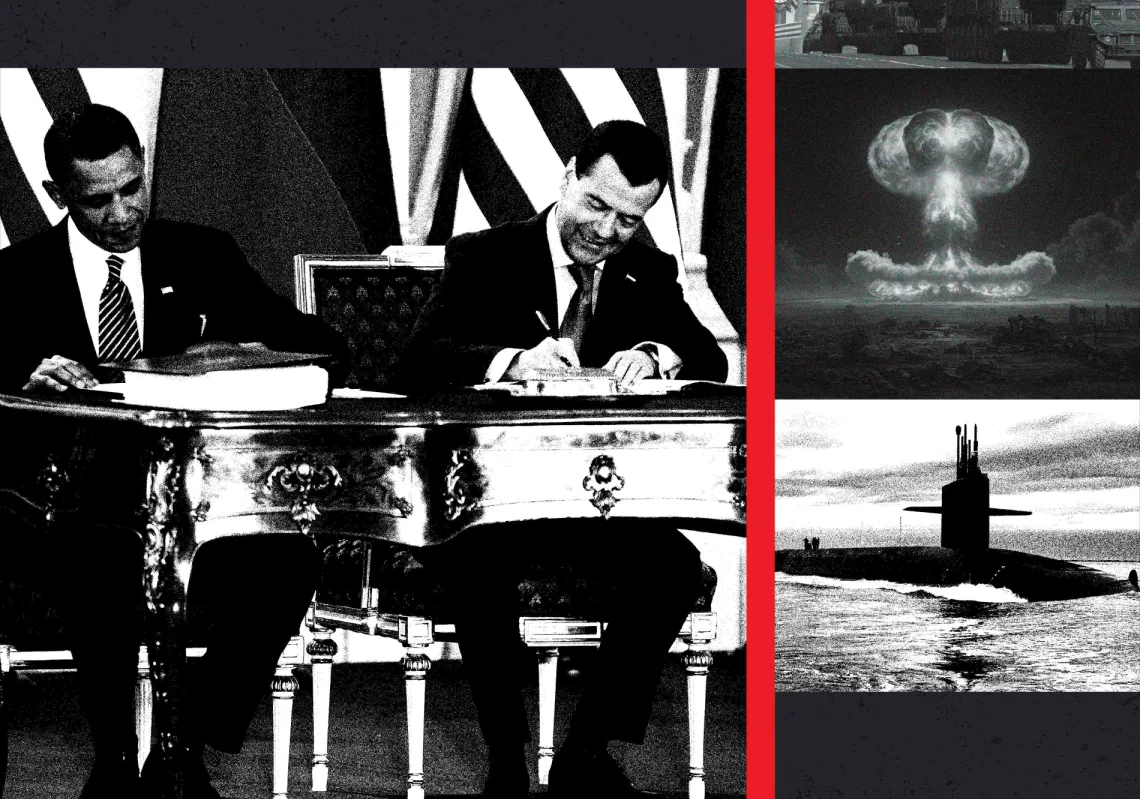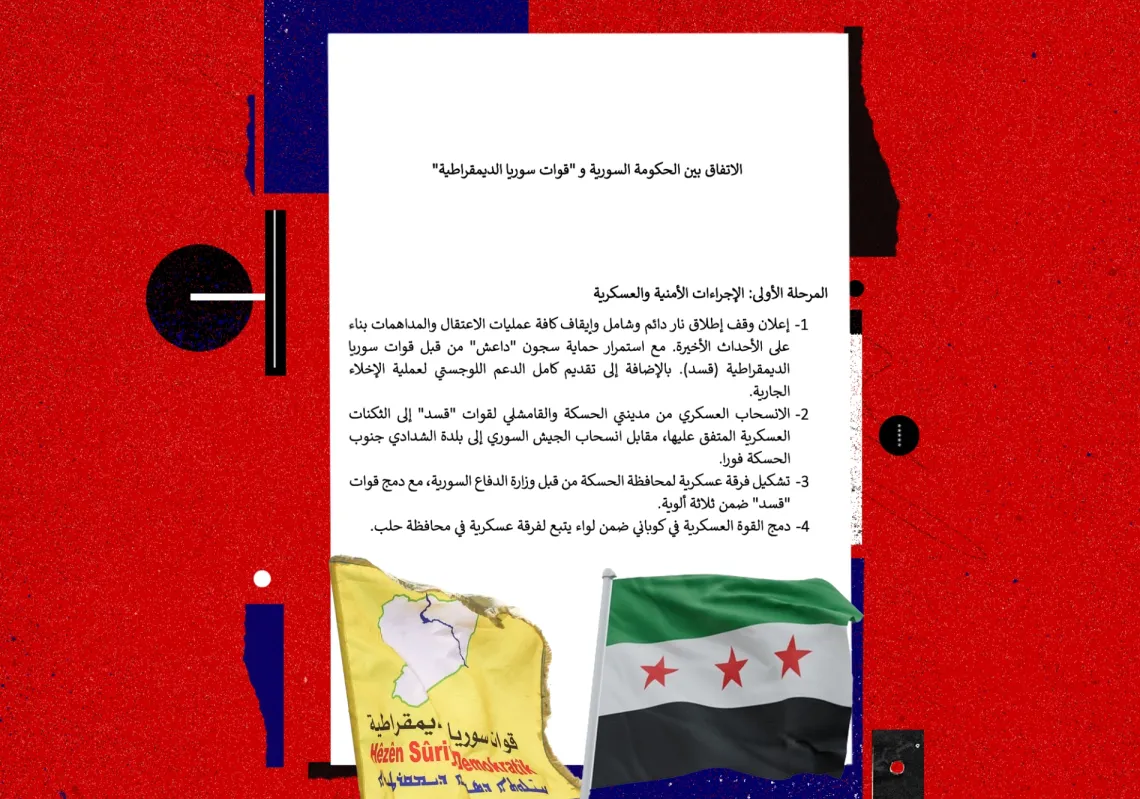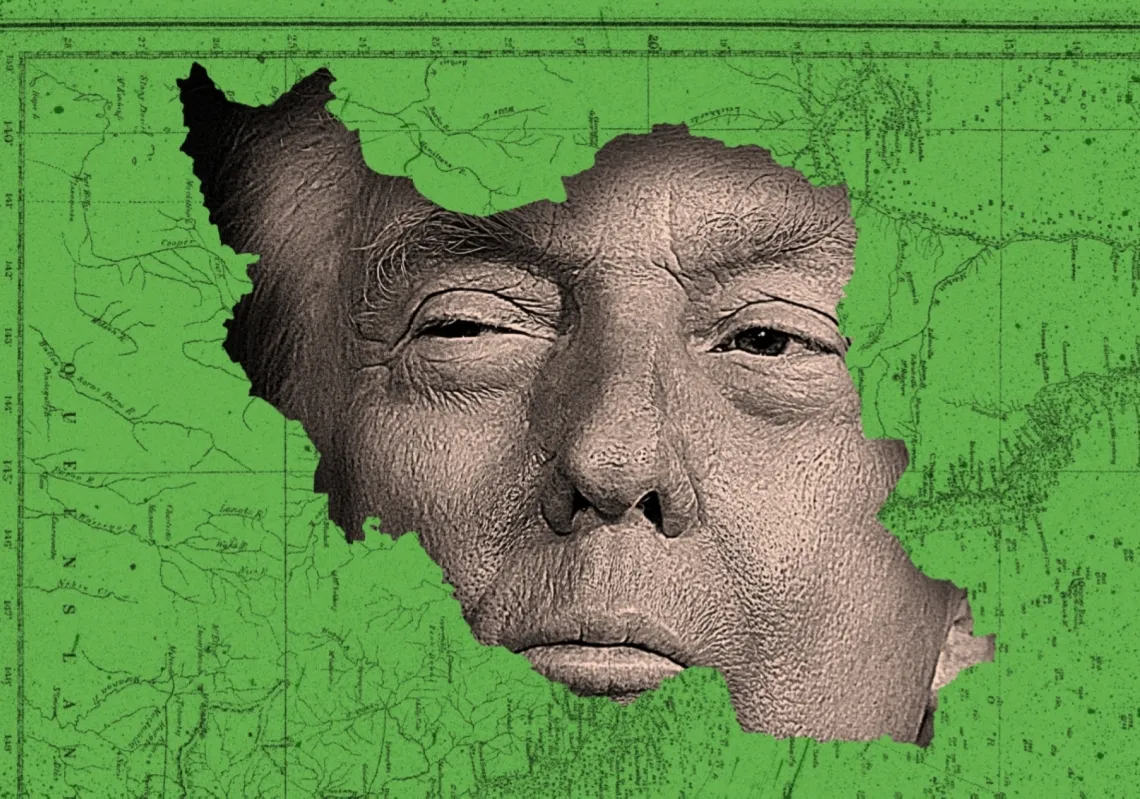يركز الباحث والكاتب العراقي الدكتور رشيد الخيّون على قضايا التراث الثقافي والفلسفي العربي الإسلامي، في أفقه الرحيب، بعيدا من التعصب والتقديس، ويتناوله تناول الناقد، رابطا بينه وبين الحاضر.
الخيّون، الحاصل على دكتوراه في الفلسفة العربية الإسلاميَّة، مارس التدريس والإشراف الأكاديمي، ونال جائزة الملك عبد العزيز في الدراسات التاريخية عن كتابه "أثر السود في الحضارة الإسلامية" عام 2017. صدر له نحو ثلاثين كتابا، منها "صرعى العقائد المقتولون بسبب ديني" و"العقاب والغلو في الفقه والتراث الإسلامي" و"جدل التنزيل" و"مذهب المعتزلة من الكلام إلى الفلسفة" و"100 عام من الإسلام السياسي بالعراق (جزآن)" وغيرها.
حصل عن تحقيق مخطوط "أخبار النساء" لأسامة بن منقذ على جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الـ 19 عن فرع تحقيق المخطوطات، التي أعلنت أخيرا، ومن هناك جاءت بداية حديثه الى "المجلة".
حصلت على جائزة الشيخ زايد للكتاب لتحقيقك كتاب "أخبار النساء" بتكليف من مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث، الجهة المالكة لهذا المخطوط الفريد. ماذا تخبرنا عن هذه التجربة؟
كان مخطوط "أخبار النساء" من المفقودات، وقد نوهت في مقدمة التحقيق، أن المصادفة هي التي انتشلت الكتاب مِن الضياع، ووصل إلى خزانة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات بالرياض بفضل شخص أفغاني جمع مجموعة كبيرة من الأوراق، وهو لا يعرف عنها غير أنها قديمة، حملها في كيس وعرضها للبيع، فاشتراها الباحث والمحقق الباكستاني أحمد خان، الذي توفى أخيرا، وهو الآخر لا يدري أنها كتاب أُسامة بن منقذ "أخبار النساء"، وبعد تصفحه لها، وجدها خاصة بالنساء كاملة، وظهر أنها مخطوط كتاب "أخبار النساء" للأمير الأديب والفارس أسامة بن منقذ، الذي عاش بين القرنين الخامس والسادس الهجريين.