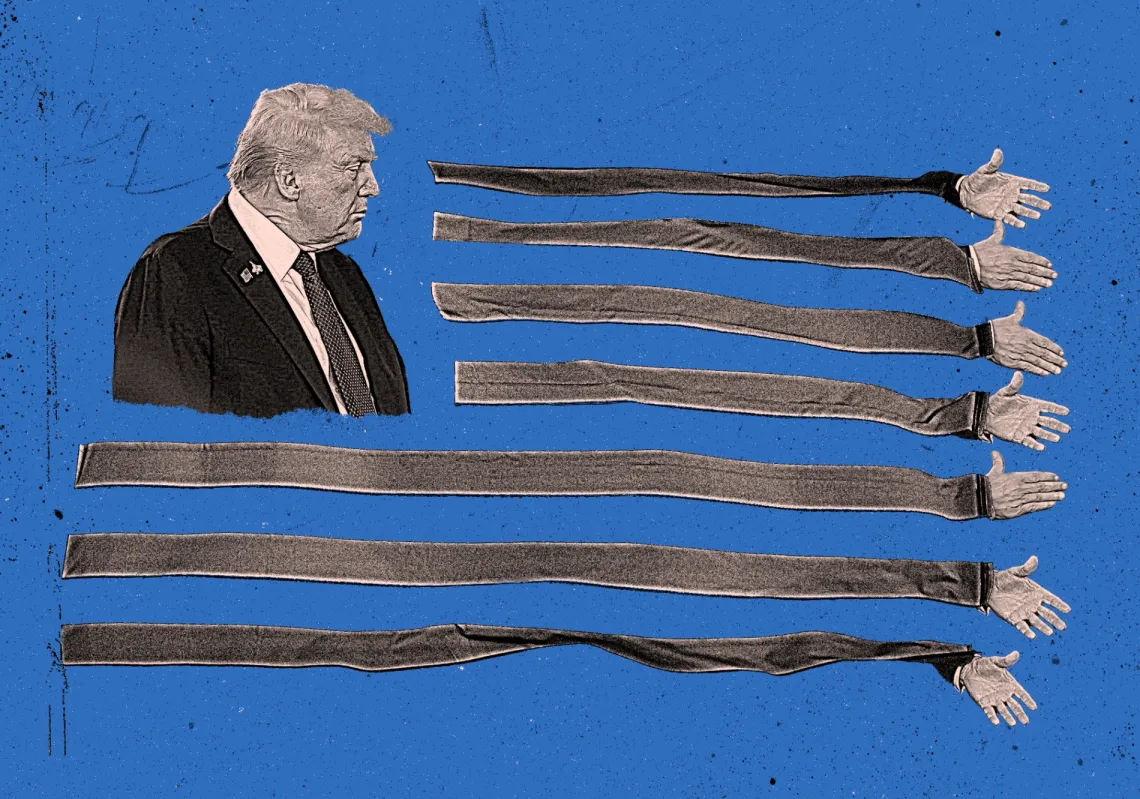تستدرجنا رواية "الاستدارة الأخيرة" للكاتب الكويتي أحمد الزمام منذ صفحاتها الأولى إلى عالم تتقاطع فيه الأساطير العائلية مع القلق الفردي، ويعاد فيه تشكيل الزمن واللغة على نحو دائري.
تدور أحداث الرواية حول فتاة صغيرة تنتمي إلى قبيلة تعيش على أطراف الصحراء، تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد أن تفقد والدها الزعيم، فتجد نفسها وسط صراعات تتشابك فيها الطفولة مع السياسة، والمقدس مع الأسطوري، لتبدأ رحلة تحولها من طفلة خائفة إلى وارثة رمزية للزعامة، تقود جموع النسوة في طقس احتجاجي غامض أشبه بالقيامة، حيث يتقاطع فيها الحلم بالواقع، ويغدو الزمن دائرة مغلقة من التكرار والانكسار.
يتجاوز المؤلف بالسرد الحكائي حدود الحكاية ليصل إلى عالم وجودي ميتا-سردي، حيث تمثل كل استدارة رمزا للاعتراض، ويتكثف كل تفصيل بسيط ليغدو بؤرة للمعنى. ويفتح عنوان الرواية المجال أمام تأملات وجودية وسردية في آن، حيث تبنى الحكاية حول مركز خفي، ويتولد الدوران من نواة تنتج المعنى. فالاستدارة هنا تتجاوز كونها حركة دائرية أو شكلا هندسيا، لتغدو مسارا قدريا يحتضن تجربة الذات، ويمضي بها نحو مواجهة عميقة مع التجربة الحياتية والانتماء. هي صورة لوعي يلتف حول نفسه، ويتنقل بين الغريزة والفكر والعاطفة، في دوائر من الحيرة والقلق والتوق للخلاص. إنها اللحظة التي يشتد فيها الاضطراب الداخلي، ويدفع الكائن إلى حافة القرار.
تعيد الرواية، الصادرة عن دار "رشم" في الرياض (2024)، تدوين السلطة والتاريخ من منظور أنثوي، متجنبة الوقوع في فخ الخطاب النسوي التقليدي، حيث تقدم النساء ككائنات كونية حارسة للوعي الجمعي ومؤسسة للحكم، فتعاد كتابة التاريخ بأصابعهن، ويصان الوعي نفسه من خلالهن.
في مشهد الاستدارة الكبرى، تصبح الطفلة وارثة الزعامة، وتمثل اللحظة التي فيها تصطف العشيرة في دائرة حولها، وتجرد اللحظة من الذكورة السياسية، ليعاد فيها فهم الزعامة وفق تصورات جديدة للهوية والانتماء، فيها تكون المرأة، للمرة الأولى، "الماضي والشرط المستقبلي".