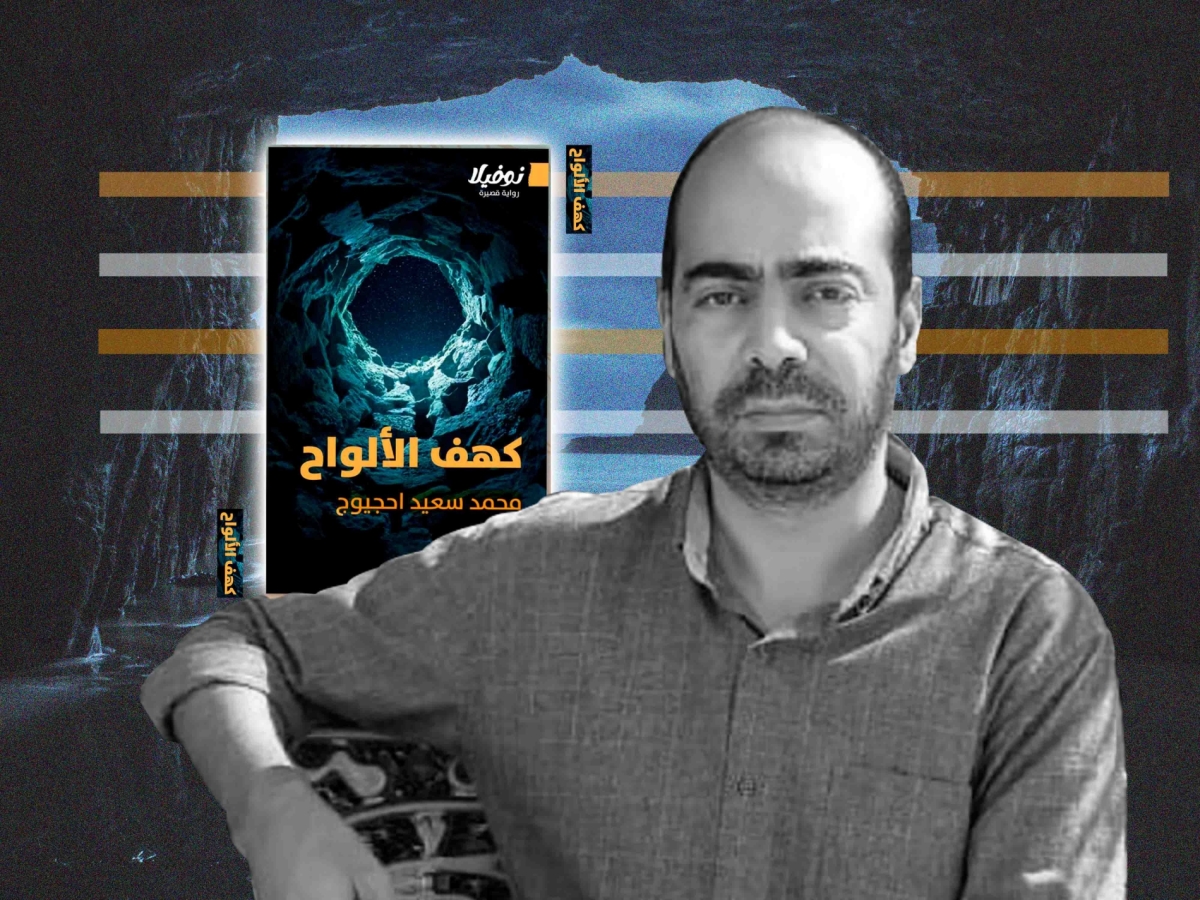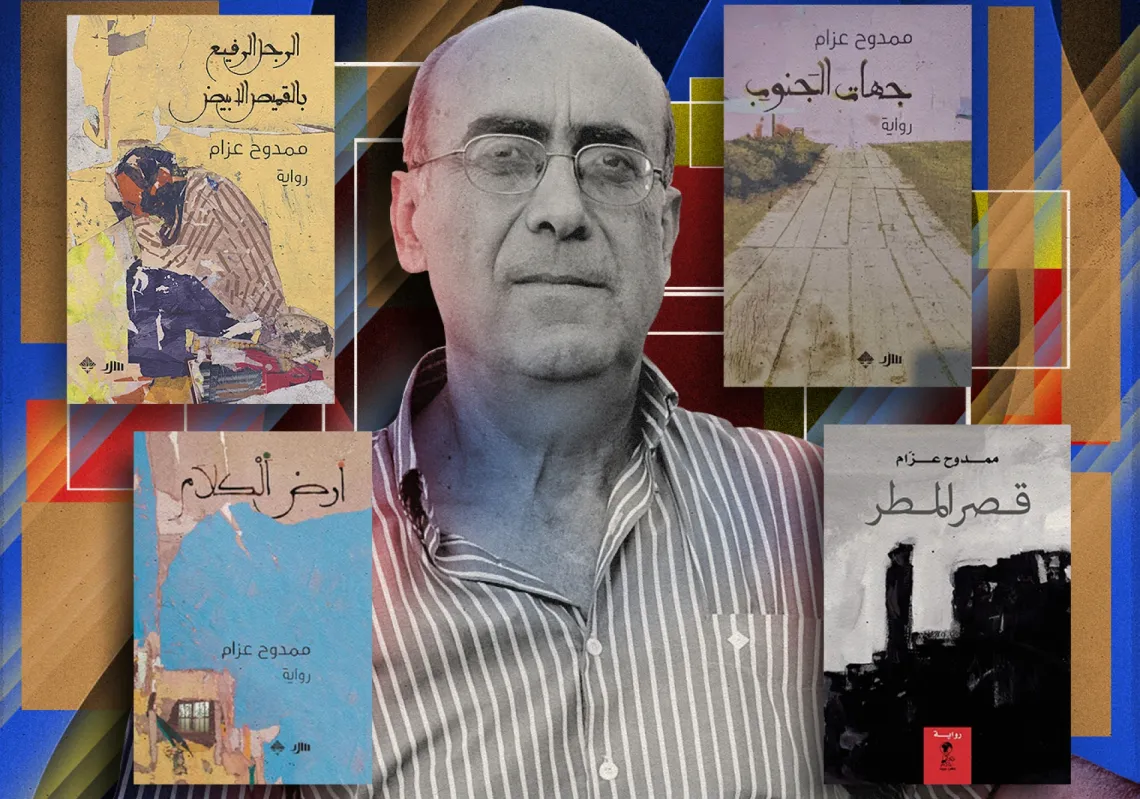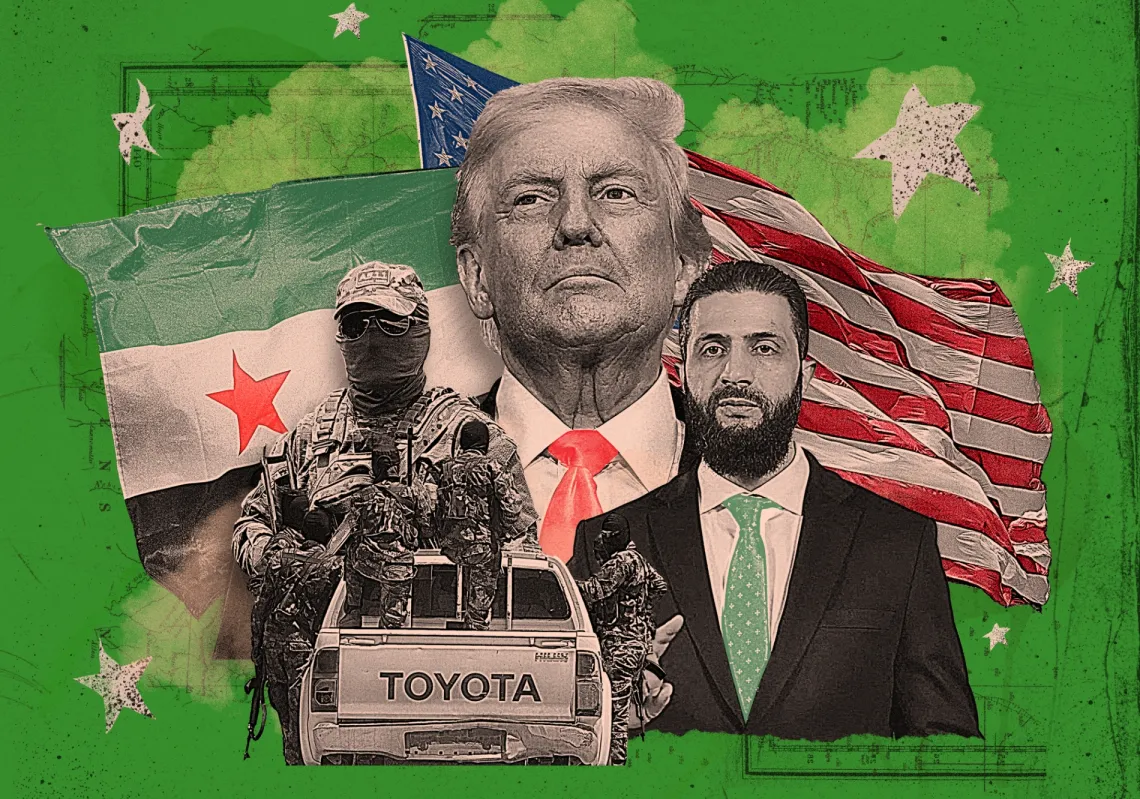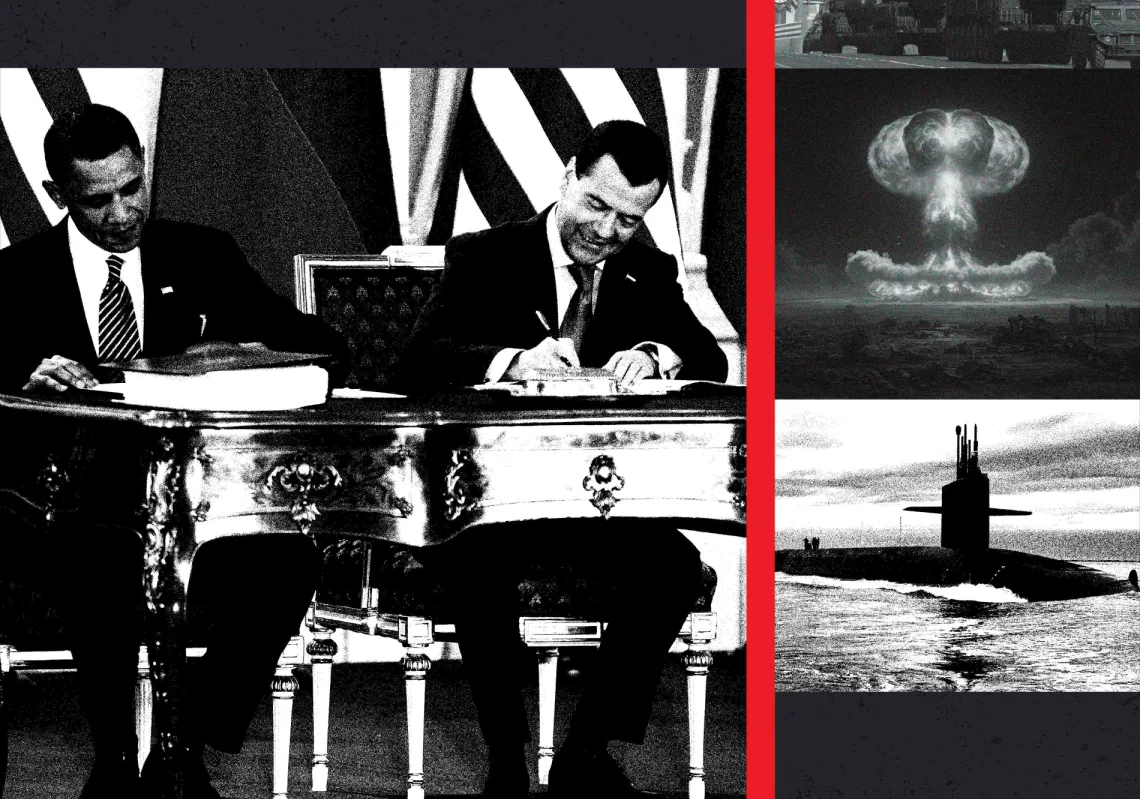في زمن يحتفى فيه بالروايات المسطحة والخيارات الآمنة، تحضر رواية الكاتب المغربي محمد سعيد احجيوج "كهف الألواح" كمفاجأة جمالية وفكرية، لا لكونها مجرد نص جيد بل لأنها، ببساطة، رواية مستحيلة: نص يخفي بنيته كأنه يلعب الشطرنج مع القارئ، يقايضه الحقيقة بالوهم، ويسائل فيه السرد ذاته. ولعل ما يضاعف من وقع المفارقة أن هذا العمل، الصادر عن "دار نوفل" (فبراير 2024)، لم يجد له موطئ قدم في أي جائزة عربية كبرى، ولم يحظ بانتباه نقدي يوازي جرأته البنائية والفكرية. في واقع الأمر، هو عمل يضع القارئ، كما الناقد، في امتحان عسير: هل نقرأ لنتسلى، أم لنتزعزع؟ هل نشيد بعمل ما لأننا نعرف صاحبه وناشره، أم لأنه يستحق الإشادة؟ هل تمنح الجوائز للنصوص المختلفة الجريئة في طرحها وبنائها ولغتها، أم بناء على معيار "الخيار الآمن"، الذي يفرضه الفهم المسطح والقراءات السابقة؟
سرد يهدم نفسه
من اللحظة الأولى، تعلن "كهف الألواح" رفضها لأي مسار سردي تقليدي، فهي رواية لا تروي، بقدر ما تقوض فعل الرواية ذاته. تتوزع الرواية على أربع حركات تحمل أسماء موسيقية: "سوناتا الرحيل"، "ساعي البريد لا يعرف العنوان"، "رقصة الموت"، و"مفارقة الوجود"، وهي حركات لا تمثل تقسيما زمنيا أو حبكويا، بل نسيجا تفكيريا، يتكرر ويتداخل ويتشظى.
كل فصل هو نافذة على ذات محطمة، وكل صوت – آزاد، خلود، عدنان، إيزل – هو مرآة مكسورة لا تعيدنا إلى الأحداث، بل إلى استحالة القبض عليها. في هذا المعمار السردي المضطرب عمدا، لا يعاد تشكيل الواقع، بل يحطم في كل مرة يعاد فيها. كل صوت يسترجع مشاهد لم نعد نعرف إن كانت حدثت فعلا أم لا، كل جملة تراوغ القارئ، لا لتضلله، بل لتفضح وهم الحقيقة في الرواية والحياة معا. وهنا تبلغ الرواية قمة ذكائها البنيوي: السرد لا يشف عن شيء، بل يكشف قناع اللغة عن خوائه.