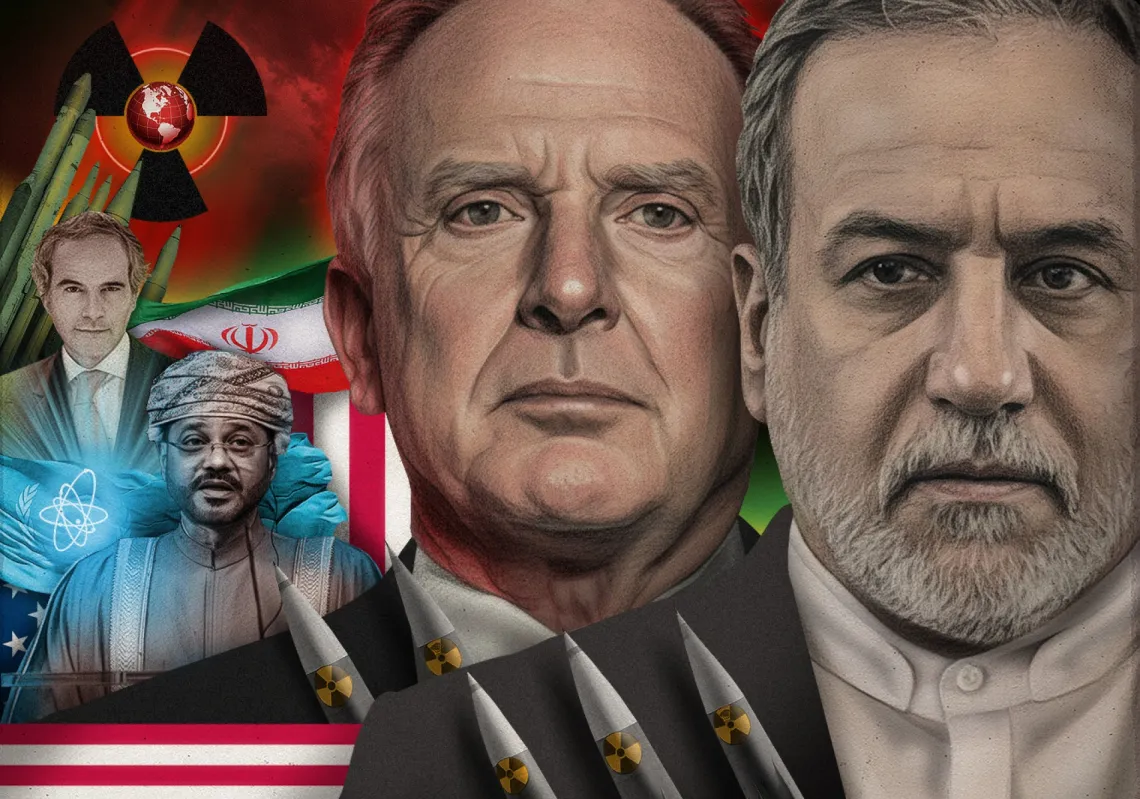عندما خرج جثمان زياد الرحباني من المستشفى، وقف الحاضرون مصفقين، كأنه خروجه الأخير على مسرح كان قد طال ابتعاده عنه. ودّعوه بالورود وبأغنياته هو. هؤلاء ممن تأثروا بشخص زياد الرحباني، كلاما وتصريحات ومسرحا وحلقات إذاعية. ومذهل هو حضور صوته، الأجش العريض المفتر عن نصف ابتسامة دائما، في آذان اللبنانيين وفي حناجرهم.
كانت وفاته مناسبة لاستحضار كثيرين من مجايليه والجيلين الأصغر سنا علاقاتهم الشخصية بانتاجه وكيف تسلل إلى لغتهم وأفكارهم، حتى وإن تخلصوا لاحقا من بعض آثاره فيهم، وكيف رافقهم مراهقين فاشلين في العلاقات العاطفية حتى علمهم، بصوت المرأة، كيف ينعكس فشلهم المتمادي عليها. لكنها كانت أيضا مناسبة لكثيرين لمحاسبته أو للدفاع عنه بأثر رجعي على مواقفه السياسية. على أن نقاش فنان على موقف سياسي، بعد رحيله، هو أمر لا طائل منه، سوى التعصب له وعليه، أو الكراهية ونفي القدرة على فهم ما قدمه من فن، وهو الأساس الذي لولاه لما كان من حاجة للنقاش أصلا. فأيا تكن مصادر الهام الفنان أو مواقفه وتحليلاته السياسية أو عيوبه الشخصية أو رسالته الاجتماعية، فإن كل ذلك لا أهمية له في ذاته. فقد يشاركه آخرون المواقف او العيوب أو الرسائل نفسها ويظل عملهم فنيا بلا أي قيمة، والأمثلة على تفاهة فنانين وأعمال "ذات هدف ورسالة" لا تحصى.