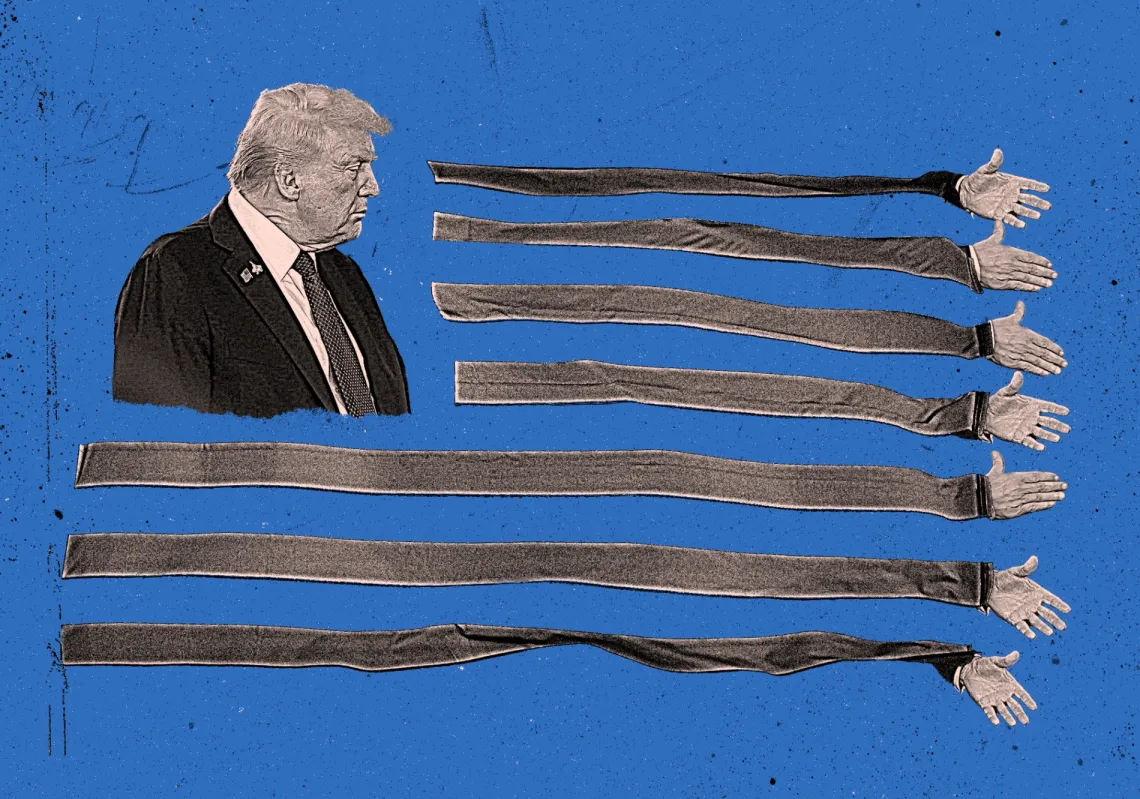تلتقيه رساما غير أن تلتقيه ناقدا. ارتباك الرسام وقلقه لا يذكران بثقة الناقد وقوة حيلته. في الحالين فإن الفنان اللبناني الدمشقي الفرنسي أسعد عرابي (1941-2025) الذي فقدته الحياة الثقافية العربية يوم أمس كان يبدو متوترا ومشدودا ومنضبطا ودقيقا في حركته وهو يرسم، كما في كلماته حين يكتب، وهذا ما تعلمه من الدرس الأكاديمي يوم درس الفلسفة.
بين مدينتين وحضارتين
رسام على قدر كبير من الغنائية الحزينة، وناقد يبحث في الأصول الكلاسيكية عن أسرار الجمال الحي. لغته التعبيرية في الرسم تكشف عن جرأة وحرية استثنائتين في تناول الموضوعات الاجتماعية والسياسية، على الرغم من أنه كان يحن بين حين وآخر إلى التجريد الذي يضفي على نزعته التعبيرية طابعا تأمليا هو أقرب إلى شطحات المتصوفة التي لم تقف بينه وبين الالتفات إلى ما هو عابر ويومي وزائل من وقائع.
لوحاته "مرويات دمشقية" تمزج قوة الصورة بما يرافقها من همس عاشق. هناك بلاد تتشكل على سطوح لوحاته كما في ذاكرته، هي ما تبقى من حياة عاشها على عجل قبل أن ينفتح على العالم بثقافته الشاسعة لينظر من شباك شقته في ديفانس (الضاحية الباريسية) إلى العالم باعتباره مدينة من زجاج.
ما أن يلقي المرء نظرة إلى لوحاته حتى يتأكد أنه ورث من المحترف الفني السوري ما لم يرثه إلا القلة ممن تربوا في أحضان ذلك المحترف: صلابة في البناء التصويري وشاعرية في التعبير الحر.
ما لم يختره أسعد عرابي أن يكون سوريا على الرغم من أصوله اللبنانية. "ما الفرق؟" سيتساءل البعض. الفرق يظهر حين يكون المرء فنانا. أما أن يكون ذلك المرء أسعد عرابي، فإن شبهة التخلي ستلاحقه. فالمحترف الفني اللبناني لا يمت بصلة إلى المحترف السوري. هما محترفان مختلفا المزاج والأفكار والرؤى والأساليب.