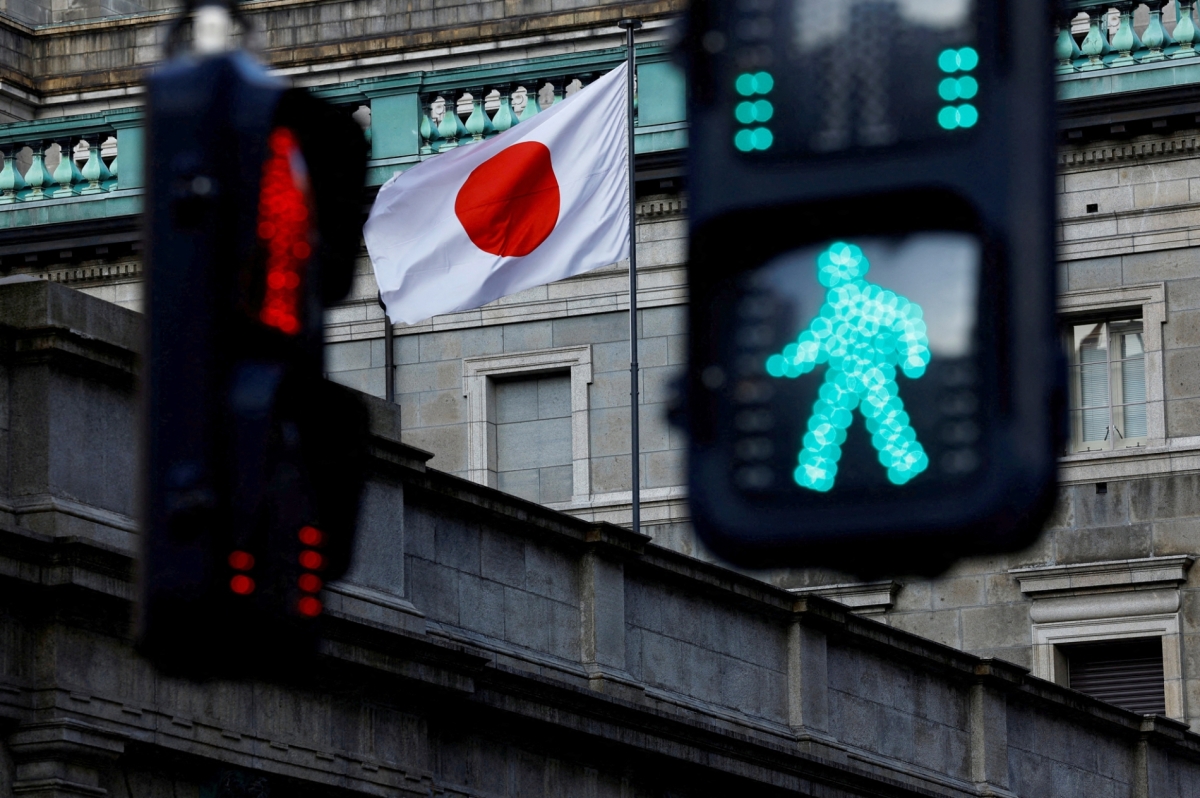نادرا ما سجّل التاريخ الحديث تحولا وطنيا مذهلا وسريعا وشاملا كالذي شهدته اليابان حين انتقلت من أرخبيل إقطاعي إلى قوة صناعية حديثة. قبل نحو مئة وستين عاما، وجدت اليابان نفسها عند مفترق طرق يشبه إلى حدّ بعيد ما تواجهه اليوم كثير من دول الشرق الأوسط، إذ كانت معزولة ومتخلفة تقنيا عن المعايير الغربية، يحكمها نظام إقطاعيّ متصلّب لم يعد قادرا على مجاراة عالم يتبدّل بوتيرة متسارعة. ومع ذلك، استطاعت خلال جيل واحد فقط أن تثور على بنائها السياسي، وتنهض باقتصادها، وتكرّس مكانتها قوة يحسب لها حساب في الساحة الدولية.
لم يكن هذا الإنجاز الاستثنائي وليد صدفة، ولا مجرد حصيلة تقليد أعمى للمؤسسات أو التقنيات الغربية، بل كان ثمرة تفاعل معقد جمع بين التقاليد المحلية، والحماسة الثورية، والقدرة البرغماتية على التكيّف، وربما الأهم من ذلك، تجاوز الأيديولوجيا التي أشعلت شرارة الثورة نفسها. وبالنسبة للعالم العربي، الذي يسعى بعض أبنائه إلى فهم الكيفية التي تمكّن بها مجتمع تقليدي من الإبحار بثقة في مياه التحديث المتقلبة دون أن يفقد صلته بجذوره الثقافية، فإن تجربة اليابان تمثل مصدر إلهام عميق، كما تحمل في طياتها أيضا دروسا تحذيرية تستحق التأمل.
ثمة أوجه تشابه لافتة بين اليابان في القرن التاسع عشر والمجتمعات الشرق أوسطية المعاصرة. فقد واجه الطرفان صداما حادا بين القيم التقليدية ومتطلبات الحداثة، وبين التشبث بالهوية الثقافية المحلية والحاجة المفترضة إلى تبني المؤسسات والتقنيات الأجنبية. كما تعرض كلاهما لضغوط خارجية مارستها قوى كبرى سعت إلى إعادة تشكيل منظومتيهما السياسية والاقتصادية بما يتماشى مع مصالحها. وشهد الجانبان كذلك حركات ثورية استلهمت تصورا مثاليا عن الماضي، ورفعت شعارات الإصلاح والتطهير من خلال العودة إلى المبادئ الأولى التي شكلت جوهر مجتمعاتهم.