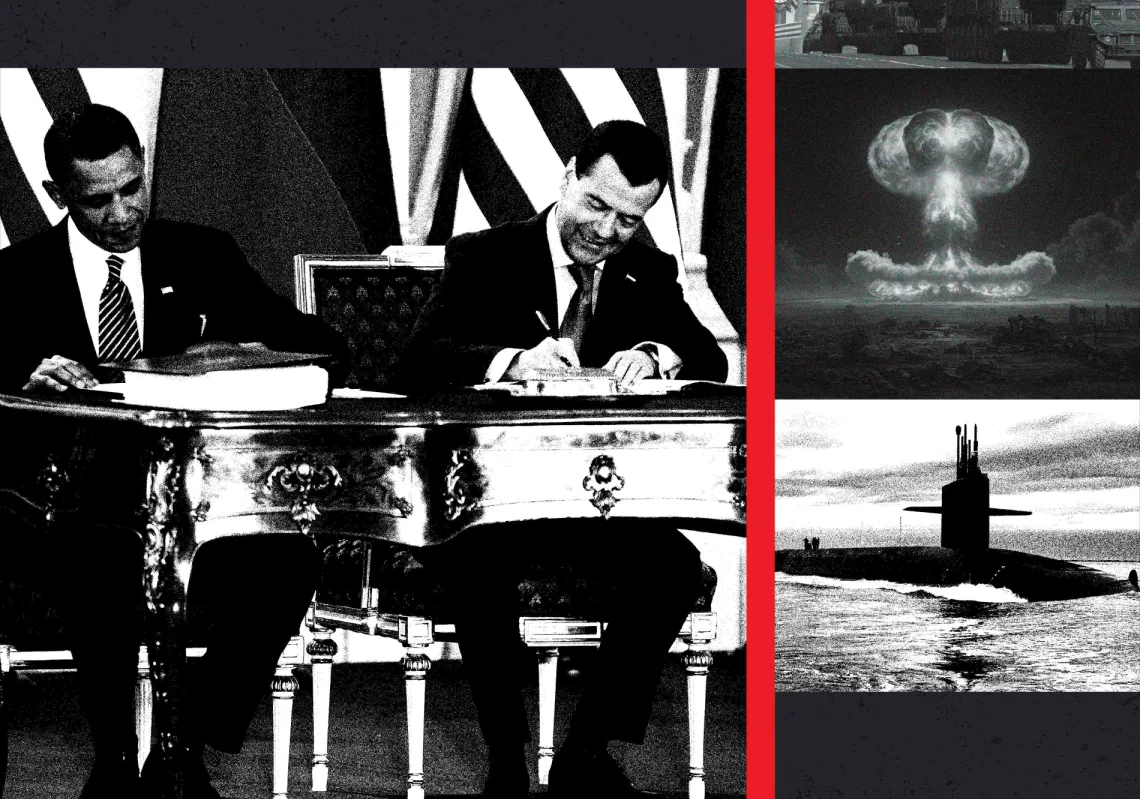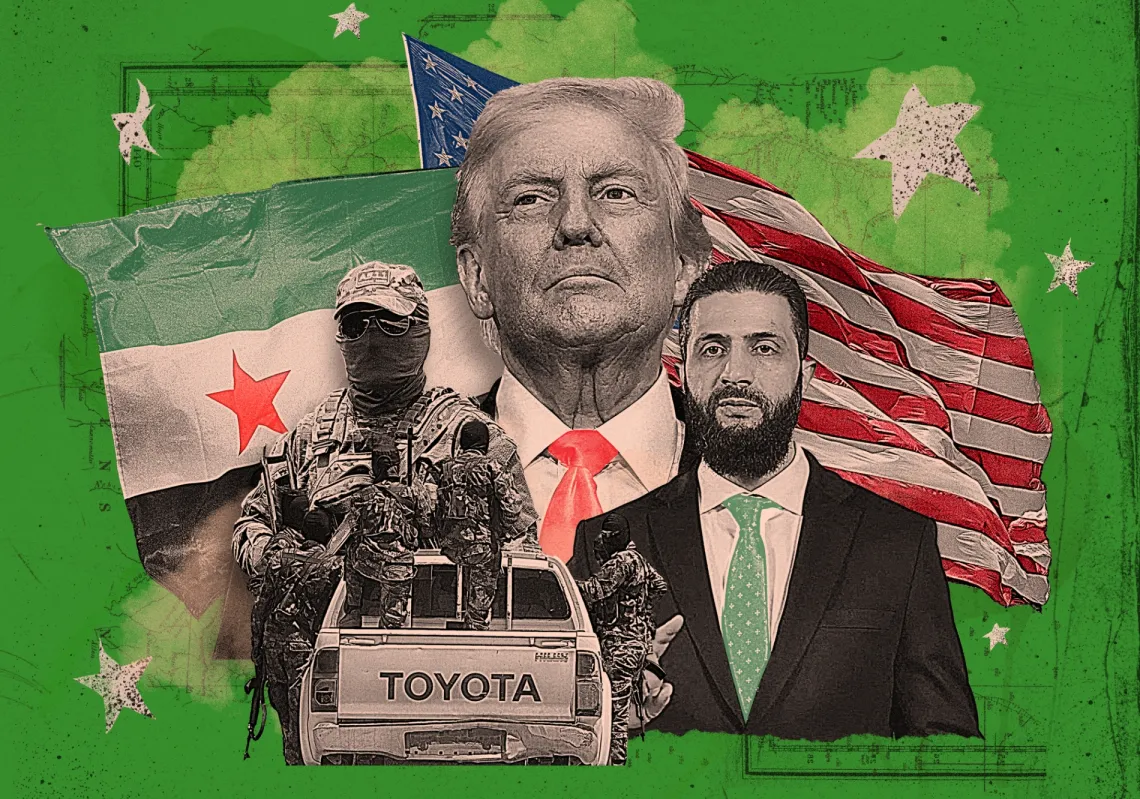لم تكن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة المتحدة في خريف عام 2025 مجرد رحلة ديبلوماسية تقليدية، بل محطة فارقة في مسار العلاقات بين البلدين، نقلت التحالف التاريخي من إطاره العسكري والاستخباراتي إلى آفاق جديدة قوامها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. في تلك الزيارة التي أثارت اهتمام العالم، اصطحب ترمب معه وفدا غير مسبوق من رؤساء كبريات الشركات الأميركية، من "مايكروسوفت" إلى "غوغل" و"إنفيديا" و"أمازون" و"أوراكل"، في مشهد يجسد بوضوح كيف أصبحت شركات التكنولوجيا الكبرى أذرعا استراتيجية للولايات المتحدة، تتحرك بالتوازي مع البيت الأبيض، وتعمل كجزء من قوتها الناعمة والصلبة في آن واحد.
الحدث لم يكن سياسيا فحسب، بل اقتصادي واستراتيجي بامتياز. فقد أعلن الجانبان التزاما استثماريا ضخما تجاوز 42 مليار دولار، ركز معظمه في مجالات البنية التحتية السحابية والحوسبة الفائقة القدرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كانت الرسالة واضحة: التحالف بين واشنطن ولندن يدخل مرحلة جديدة عنوانها "الريادة التكنولوجية"، في زمن تتنافس فيه القوى الكبرى على قيادة الثورة الصناعية الرابعة.
تلك الخطوة جاءت في لحظة دقيقة من التحولات العالمية. فالعالم يعيش سباقا محموما على التفوق في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والتقنيات الدفاعية الذكية. الصين تمد نفوذها الرقمي عبر مشروع "طريق الحرير الرقمي" والاتحاد الأوروبي يسعى إلى استقلالية تكنولوجية تقلل اعتماده على الشركات الأميركية. في هذا السياق، أرادت واشنطن أن تؤكد أن "التحالف الأنغلوساكسوني" لا يزال في قلب المشهد، قادرا على المبادرة وليس مجرد متفرج على تحولات القوى العالمية.
ولم يكن اختيار بريطانيا مصادفة. فمنذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، تسعى لندن إلى ترسيخ موقعها بوصفها شريكا مميزا لواشنطن في مجالات التكنولوجيا والابتكار. الحكومة البريطانية بقيادة كير ستارمر رأت في استثمارات الشركات الأميركية فرصة لتثبيت اقتصاد ما بعد "البريكست"، بينما وجد ترمب فيها ساحة مناسبة لتأكيد رؤيته الاقتصادية القائمة على "الصفقات الكبرى" التي تعزز النفوذ الأميركي في الخارج وتدعم الشركات الوطنية في الداخل.
وقد وصفت الزيارة بأنها الأضخم من حيث حجم الاتفاقات التجارية بين البلدين منذ الحرب العالمية الثانية، إذ تجاوزت قيمة الالتزامات المتبادلة 250 مليار جنيه إسترليني، وفق ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني، منها 42 مليار دولار مخصصة لقطاع التكنولوجيا وحده. وشملت الاتفاقات إقامة مراكز بيانات متقدمة، وتمويل مشاريع بحثية في الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنى التحتية السحابية المخصصة للقطاعين الحكومي والدفاعي.