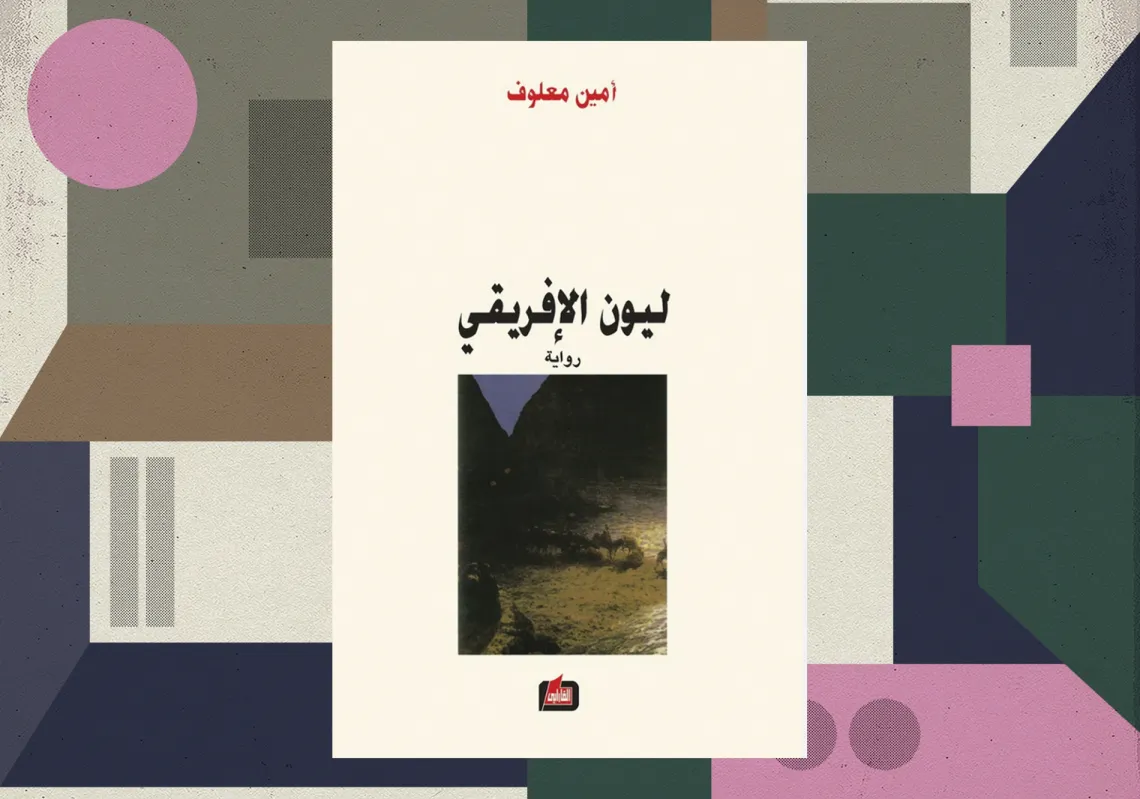بين حقائب الرحيل قسرا ودفاتر العودة خيالا، تشكلت تجربة جيل من المبدعين الذين ولدوا في مصر بين ثلاثينات وخمسينات القرن الماضي. كتاب من أمثال أندريه شديد وروبير سوليه، لم يغادروا وطنهم إلا ليحملوه في ذاكرتهم إلى المهجر ، هربا من عواصف سياسية لم ترحم أحلامهم. وقد رأينا بعضهم يعودون إلى مصر التي سكنتهم صغارا، عبر بوابة السرد الروائي، ليلتقي خيالهم وطنا تبدلت ملامحه الديموغرافية والاجتماعية، ولم يبق لهم سوى أطياف ذكريات يحاولون ترميمها بالكلمات، فشكل هؤلاء الأدباء الذين نضجت أقلامهم في المهجر- ما يمكن تسميته بـ"أدب الحنين".
توثيق وجدان الشرق
يعد جيلبير سينويه أحد الأصوات الروائية التي جسدت مفهوم "الجسر الثقافي" في الأدب الفرنسي المعاصر، إذ استطاع المزج بين دقة المؤرخ وشغف الروائي، ليعيد صوغ الذاكرة الشرقية بلسان غربي. لم تكن كتابات سينويه مجرد سرد للأحداث، بل كانت استقصاء في روح الشرق، ففي ملاحمه الكبرى مثل "ابن سينا أو الطريق إلى أصفهان"، لم يقدم سينويه سيرة ذاتية للشيخ الرئيس فحسب، بل احتفى بعبقرية العقل الشرقي ووهجه الفكري، محولا التاريخ الجاف إلى رحلة إنسانية نابضة بالمعرفة والوجدان.
لكن، وبالرغم من سعة أفقه المشرقي، تظل علاقة سينويه بمصر حالة استثنائية. فهو لا يكتب عن مصر كسائح أو مراقب، بل كابن يبحث عن وطنه المفقود في ثنايا الورق. يبرز هذا التوجه بوضوح في رواياته التي أرخت لـمصر الكوزموبوليتانية، ذلك الفضاء السحري الذي كان يوما بوتقة تنصهر فيها الثقافات واللغات والأديان في انسجام فريد. في أعماله التاريخية المتعددة، نجد سينويه مشغولا باستعادة ملامح القاهرة الملكية والمدن المصرية التي كانت تضج بالحياة والتنوع، مصورا إياها كفردوس ضائع يحاول ترميمه بالكلمات.
طفولة سمير كساب
خلف الاسم الأدبي (جيلبير سينويه)، تكمن قصة طفل قاهري يدعى سمير كساب، ولد في 18 فبراير / شباط 1947 لأبوين من طائفة الروم الكاثوليك (الملكيين). نشأ سمير في مدرسة "العائلة المقدسة" (الجيزويت) العريقة بالقاهرة، حيث تشكلت لغته ووجدانه حتى نال شهادة البكالوريا، لكن ملامح شخصيته الحقيقية لم ترسم فقط في فصول الدراسة، بل في قلب الحياة الأريستقراطية الصاخبة التي كان والده أحد أعمدتها.