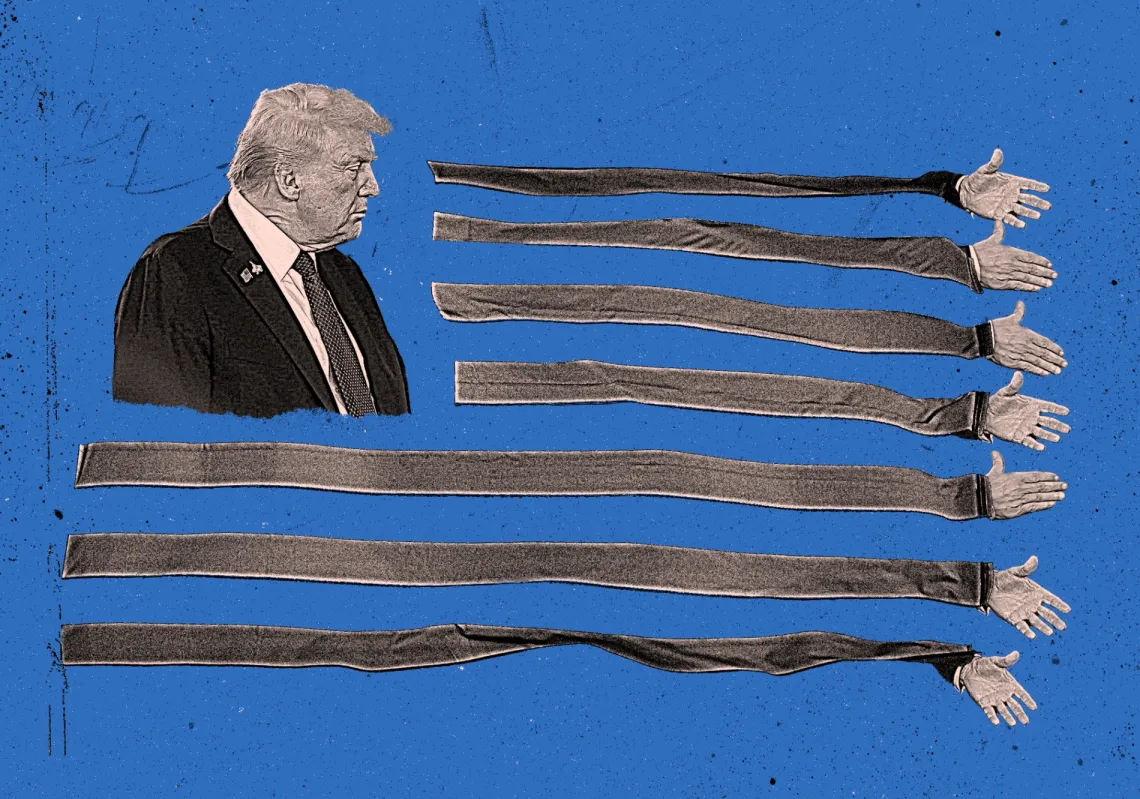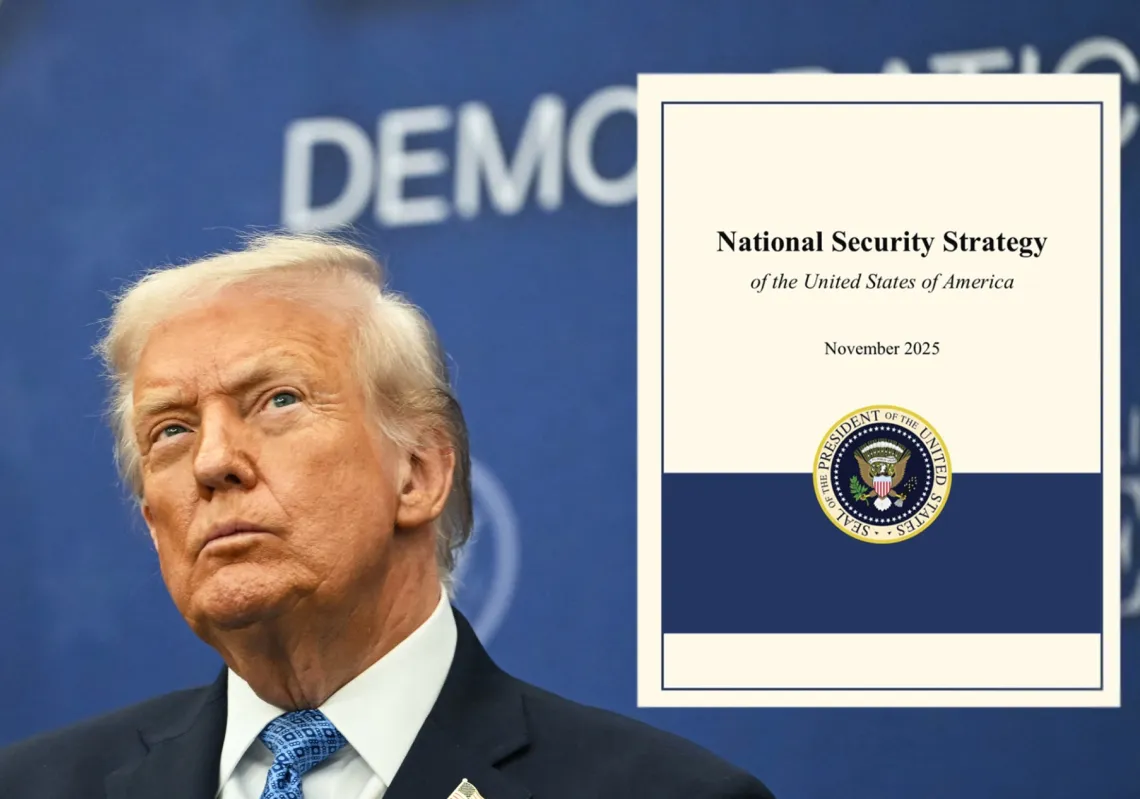بعد أن تطرقنا في الشق الأول من الحوار مع الأستاذ الفخري في "معهد باريس للدراسات السياسية"، برتراند بادي (Bertrand Badie)، إلى الحدث الإيراني المليء بالأسئلة المفتوحة، نتطرق في الشق الثاني من الحوار إلى القضايا الدولية: أميركا دونالد ترمب، ماذا يريد الرئيس الذي يفاجئ العالم ويصدمه بلا توقف وبلا تردد؟
ماذا عن أوروبا القلقة والمترددة والخائفة من أقدم حلفائها وأقواهم؟
هل ما زال في الإمكان الحديث عن عالم غربي؟ أم إن الافتراق نهائي بين ضفتي المتوسط؟ وهل أزمة غرينلاند قاعدة أم استثناء في سجل العلاقة الأطلسية؟
هل ستعدل الصين استراتيجيتها "الناعمة"، فتعلن أنها هي أيضا لا تخشى من استخدام القوة العسكرية؟
وقبل هذه الأسئلة وبعدها، سؤال يتردد بقوة في دوائر القرار السياسي وأروقة الدبلوماسية وغرف العمليات: أي نظام دولي ينتظر العالم؟
هذه الأسئلة وغيرها في الشق الثاني والأخير من الحوار مع برتراند بادي:
* برأيك، هل ما يقوم به الرئيس دونالد ترمب مرتبط به وبطريقة رؤيته للولايات المتحدة والعالم، أم إنه يؤشر إلى تغير راديكالي في الولايات المتحدة على مستوى الدولة العميقة؟ هل هو سلوك مرحلي أم استراتيجية طويلة الأمد؟
- لا توجد عقيدة ترامبّية. عندما انتُخب جورج دبليو بوش، انتُخب على أساس عقيدة المحافظين الجدد، التي كانت خطوطها واضحة جدا، ولا سيما المحور الرئيس فيها والذي كان يتمثل في "تغيير الأنظمة" (REGIME CHANGE).
لا يوجد ما يعادل عقيدة "تغيير الأنظمة" مع ترمب، ولهذا السبب فإن القطيعة عميقة جدا مقارنة بالممارسات السابقة لأسلافه. لا توجد عقيدة، لكن في المقابل هناك ميثاق أبرمه مع ناخبيه وهو: إعادة ترميم القوة الأميركية، ولكن من جهة أخرى، أن لا تكون هذه الاستعادة مكلفة، لا بالمال ولا بالأرواح.
هذا ينطوي على أمرين. أولا، عودة ظهور عقيدة شقّت طريقها تدريجيا وبصمت في الولايات المتحدة، وهي العقيدة "الليبرتارية"، التي كثيرا ما يتم نسيانها. أي إن الولايات المتحدة، حتى الآن، كانت تُحكم بالحلم الرسالي، أي حلم بلد يحرر العالم، ويكاد يبني "مدينة الله" التي كان يضعها "الطهرانيون (جماعة بروتستانتية ظهرت في إنجلترا أواخر القرن 16) القادمون على متن الـ"ماي فلاور" (MAY FLOWER)، و(هي سفينة نقلت المستوطنين الإنكليز إلى أميركا سنة 1620)، في أذهانهم عندما وصلوا إلى الولايات المتحدة.
هذا النموذج انتهى لأنه اعتُبر مكلفا للغاية بالنسبة للأميركيين. وبالتالي كان هناك حلم وسيط، وهو الحلم النيوليبرالي، أي "مدرسة شيكاغو" (تيار اقتصادي نشأ بين الخمسينات والسبعينات في جامعة شيكاغو ويركز على اقتصاد السوق الحر وتقليل تدخل الدولة) ومن أبرز رموزها ميلتون فريدمان، وكل هؤلاء الذين كانوا يعتبرون أن العولمة ستجدد المجتمع الأميركي بشكل طبيعي، وأنها من اختراعه، وأنها ستفيد الجميع.