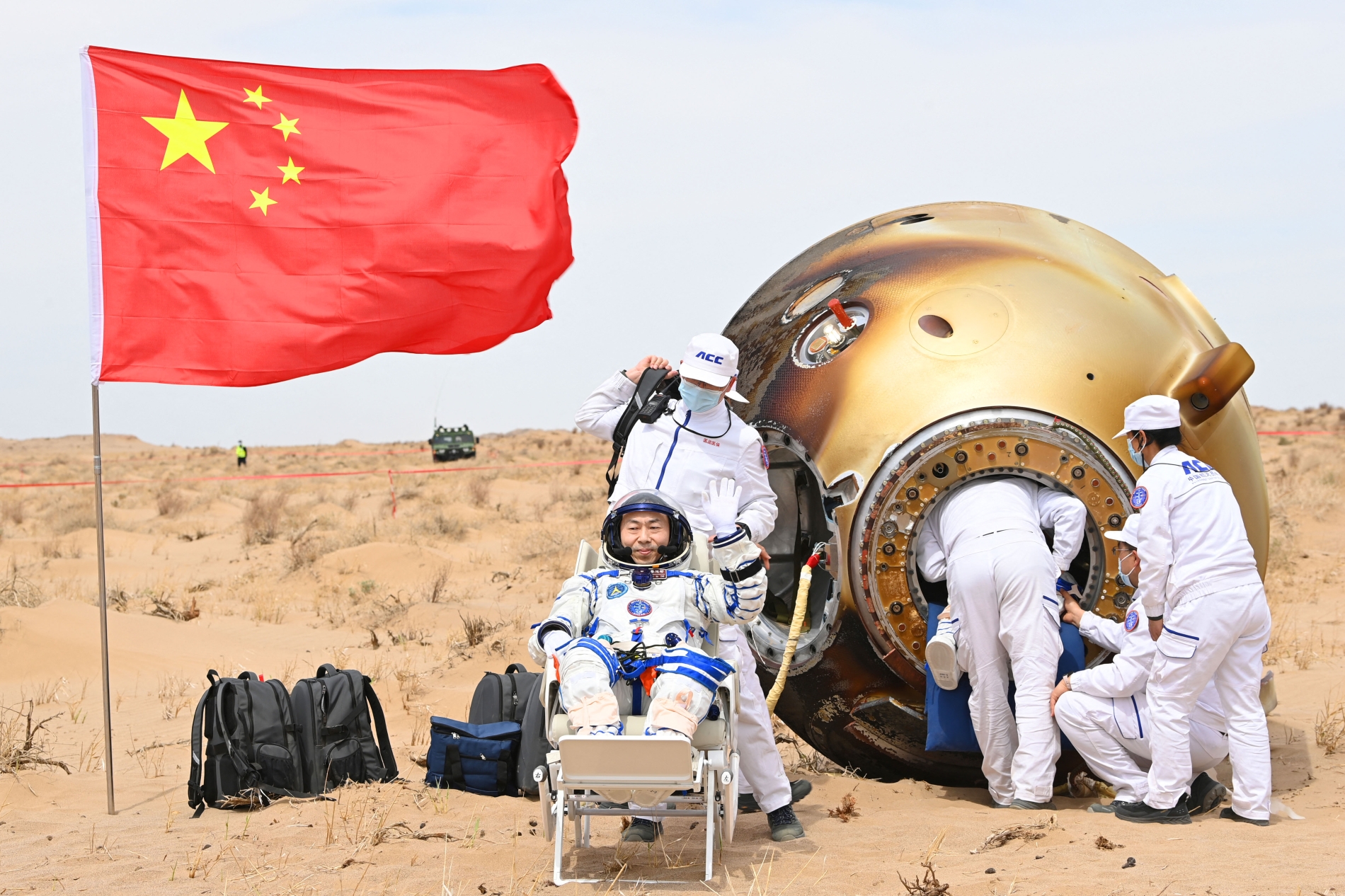تمضي الصين اليوم بوتيرة لافتة في سباق الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، في مسار لا يهدف فقط إلى اللحاق بالركب العالمي، بل إلى إعادة رسم ملامح المشهد الرقمي برمته. ففي الوقت الذي لا يزال فيه الغرب غارقا في نقاشات مطولة حول الذكاء الاصطناعي العام، وحدود الأخطار الوجودية، وأطر الحوكمة والأخلاقيات، اختارت بكين نهجا مختلفا وأكثر براغماتية، هو تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة عملية تخدم الاقتصاد والمجتمع هنا والآن، وفي أوسع نطاق ممكن.
هذا التوجه الصيني يقوم على تحقيق اختراقات فورية قابلة للتوسع السريع، بدل انتظار قفزات نظرية بعيدة المدى. فبدل التركيز على نماذج فائقة التعقيد أو رهانات مستقبلية غير مضمونة، تعمل الصين على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مباشرة في تطبيقات منخفضة التكلفة، وقابلة للنشر على نطاق واسع. والنتيجة هي انتشار متسارع لهذه التقنيات في قطاعات متعددة، من الروبوتات الصناعية والخدمية، إلى الحوسبة السحابية، مرورا بالمركبات الذاتية القيادة، وأنظمة المراقبة الذكية، وصولا إلى تحسين كفاءة المصانع وسلاسل الإمداد والطاقة.
ويمتاز هذا النموذج بالسرعة والحجم في آن واحد، إذ لا تكتفي الشركات الصينية بتجربة الحلول في نطاقات ضيقة، بل تدفع بها إلى الأسواق بسرعة قياسية، مستفيدة من سوق محلية ضخمة تسمح بالاختبار والتعديل والتوسع في وقت قصير. ومع مرور الوقت، تتضح ملامح استراتيجيا أعمق: فالصين لا تسعى فقط إلى قيادة الابتكار التقني، بل إلى ترسيخ منصاتها وبناها التحتية الرقمية في قلب الاقتصادات العالمية، بحيث تصبح هذه التقنيات جزءا لا يتجزأ من أنظمة النقل، والخدمات، والصناعة، والإدارة العامة في دول عديدة.
لذا، يكتسب النموذج الصيني أهمية خاصة بالنسبة إلى دول الخليج. فالسعودية والإمارات وقطر تخوض جميعها سباقا متسارعا نحو بناء مدن ذكية، وتطوير اقتصادات رقمية متقدمة، وصوغ استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، في إطار سعيها لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط. وتحتاج هذه الدول إلى حلول تقنية لا تكون متقدمة فحسب، بل سريعة التطبيق، وقابلة للتوسع، وذات تكلفة يمكن التحكم بها.

وهنا تبرز الجاذبية الصينية بوضوح. فالقدرة على توفير حلول ذكاء اصطناعي جاهزة للتنفيذ – سواء في شكل سيارات أجرة ذاتية القيادة تجوب الشوارع، أو منصات سحابية لإدارة الخدمات الحكومية، أو أنظمة ذكية لرفع كفاءة الطاقة والمياه – تمنح قادة الخليج مسارا أقصر نحو التحول الرقمي. والأهم من ذلك أن الشركات الصينية غالبا ما تعرض شراكات أكثر مرونة، لا تقتصر على بيع التكنولوجيا، بل تشمل التمويل، وبناء البنية التحتية، ونقل الخبرة التقنية، في حزمة متكاملة تتماشى مع طموحات المنطقة في تحقيق تحديث رقمي سريع وملموس.
وبينما يستمر الجدل العالمي حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وحدوده، تمضي الصين في تكريس واقع جديد قوامه الانتشار الواسع والتطبيق العملي. وهو واقع تجد فيه دول الخليج فرصة استراتيجية لتسريع انتقالها إلى اقتصاد ما بعد النفط، مستفيدة من نموذج صيني يقدم التكنولوجيا لا بوصفها وعدا بعيدا، بل كأداة جاهزة لإعادة تشكيل الحاضر وصناعة المستقبل القريب.
أخطار استراتيجية
غير أن هذه الجاذبية المتزايدة للتكنولوجيا الصينية لا تأتي بلا أثمان أو أخطار استراتيجية عميقة. فالانجذاب إلى حلول سريعة ومنخفضة التكلفة قد يقود، مع مرور الوقت، إلى اعتماد مفرط على مزود خارجي واحد، وهو اعتماد لا يقتصر على الجانب التقني فحسب، بل يمتد ليشمل البيانات والبنى التحتية الرقمية والقدرة على اتخاذ القرار السيادي. وفي عالم تعد فيه البيانات موردا استراتيجيا لا يقل أهمية عن النفط والغاز، يثير هذا الاعتماد أسئلة حساسة تتعلق بسيادة البيانات، والأمن السيبراني، ومن يملك حق الوصول إلى الأنظمة الحيوية والتحكم بها في أوقات الأزمات.
وتزداد هذه المخاوف تعقيدا عندما يتعلق الأمر بالشركات الصينية تحديدا. فعلى خلاف العديد من الشركات الغربية التي تعمل – نظريا على الأقل – ضمن أطر قانونية تفصل بين الدولة والقطاع الخاص، تتحرك شركات التكنولوجيا الصينية داخل منظومة تتداخل فيها سياسات الدولة مع استراتيجيات الشركات بشكل وثيق. هذا التداخل يعني أن انتشار المنصات الرقمية الصينية خارج حدود الصين، لا يمكن فصله عن الأجندة الجيوسياسية الأوسع لبكين، سواء تعلق الأمر بتوسيع النفوذ، أو بتشكيل معايير تقنية عالمية، أو بتأمين موطئ قدم طويل الأمد في البنى التحتية الرقمية للدول الأخرى.