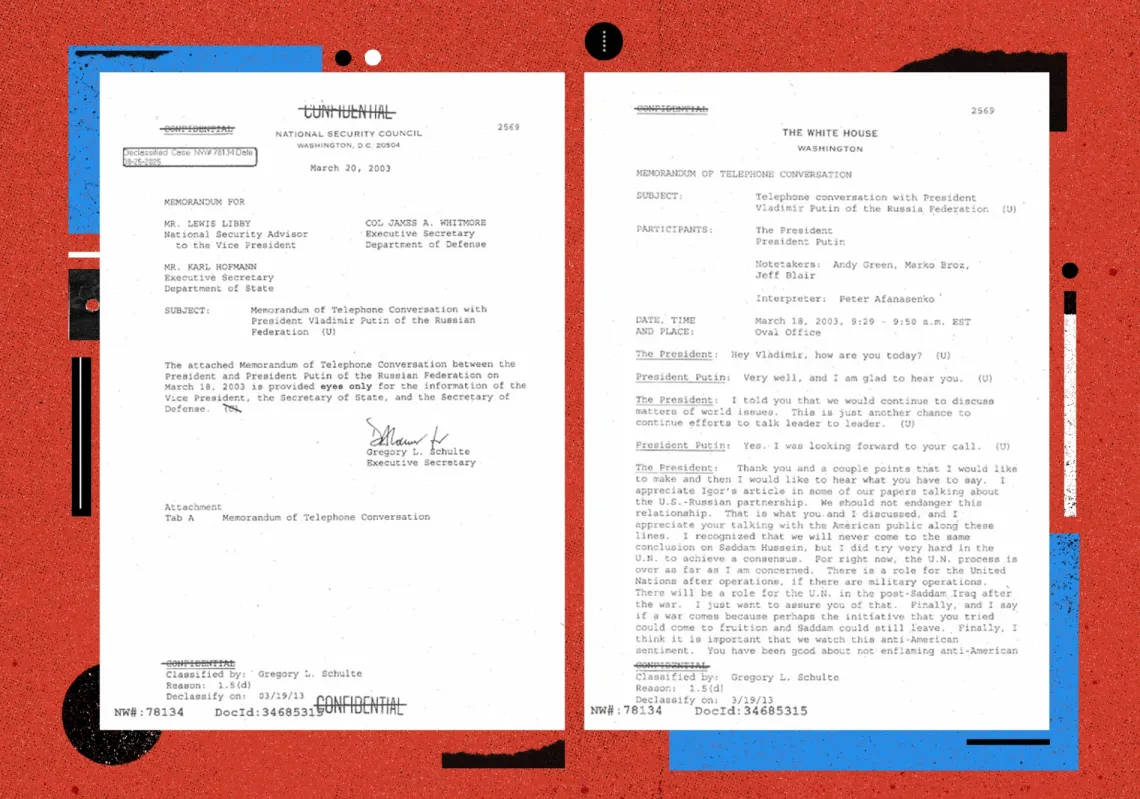طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب عرضا للوساطة في النزاع الطويل حول تقاسم مياه النيل بين مصر وإثيوبيا، في خطوة قد تبدو لأول وهلة بادرة إيجابية نحو القاهرة. فمصر حافظت لعقود على سلامها مع إسرائيل، وصانت قناة السويس الحيوية، وظلت شريكا رئيسا لواشنطن في مجالات الأمن والاستخبارات والتعاون العسكري، ولعبت دورا محوريا في التوصل إلى هدنة غزة الهشة لكنها مستمرة.
كما أن قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة ترمب للانضمام إلى مجلس السلام حديث التأسيس– رغم الجدل المحيط به– أكسب هذا الكيان قدرا من الشرعية الدولية التي كان بأمسّ الحاجة إليها، في وقت يعرب فيه قادة العالم عن مخاوفهم من اتساع صلاحيات المجلس وغموض آليات اتخاذ القرار داخله.
ومع ذلك، يأتي عرض الوساطة الأميركي في لحظة تتسارع فيها التحولات الجيوسياسية في الإقليم، وعلى سواحل البحر الأحمر وفي القرن الأفريقي، مع تغيّر التحالفات وإعادة تشكيل موازين القوى. وهو توقيت يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت المبادرة تهدف فعلا إلى حل نزاع مضى عليه أكثر من عقد، أم إنها تخدم مصالح استراتيجية أخرى.
في قلب الخلاف المصري-الإثيوبي يقف سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق، الرافد الأساسي الذي يغذي نهر النيل، مصدر المياه العذبة لمصر. ومنذ انطلاق أعمال بنائه قبل أكثر من عقد، تحوّل هذا المشروع الكهرومائي، الذي تقدر كلفته بمليارات الدولارات، من مبادرة إقليمية للبنية التحتية إلى مصدر دائم لقلق صانعي القرار في القاهرة، وإلى تهديد يلوح في الأفق لـ110 ملايين مصري يواجهون أصلا أزمة مائية خانقة.
السد، الذي دخل مرحلة التشغيل الكامل في أغسطس/آب 2025، يشكل خطرا مباشرا على أمن مصر المائي في المدى البعيد. فمصر تعتمد بشكل شبه كامل على النيل لتأمين احتياجاتها من المياه العذبة، وتحصل بموجب الاتفاقات الدولية القائمة على حصة سنوية معترف بها تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.
لكن الخزان الضخم للسد أثبت قدرته على إحداث اضطراب واسع في تدفق المياه. وخلال سنوات الملء المتتالية، احتجزت إثيوبيا كميات هائلة من المياه كانت ستتجه إلى مصر. وحتى بعد بدء توليد الكهرباء، ما زال السد يحجب أو يتحكم في كميات كبيرة من الحصة المصرية السنوية.