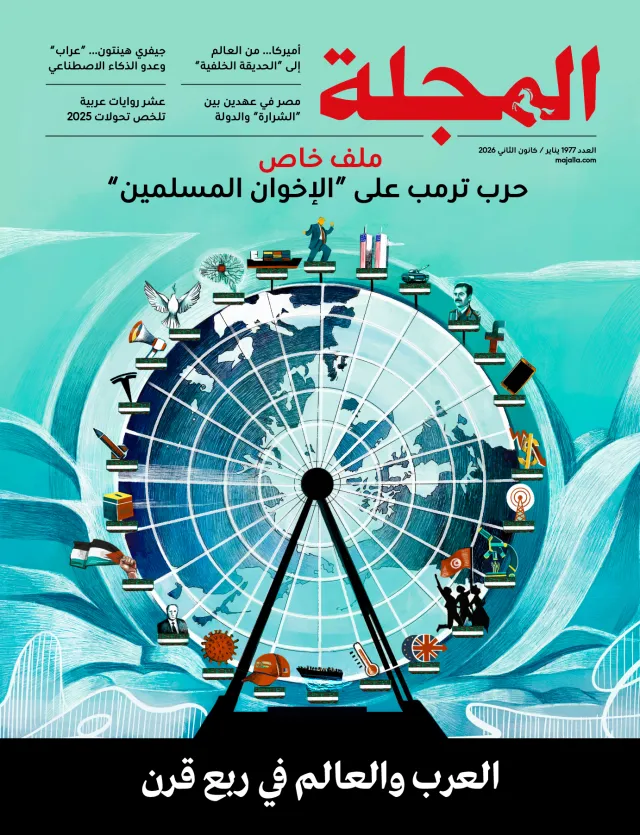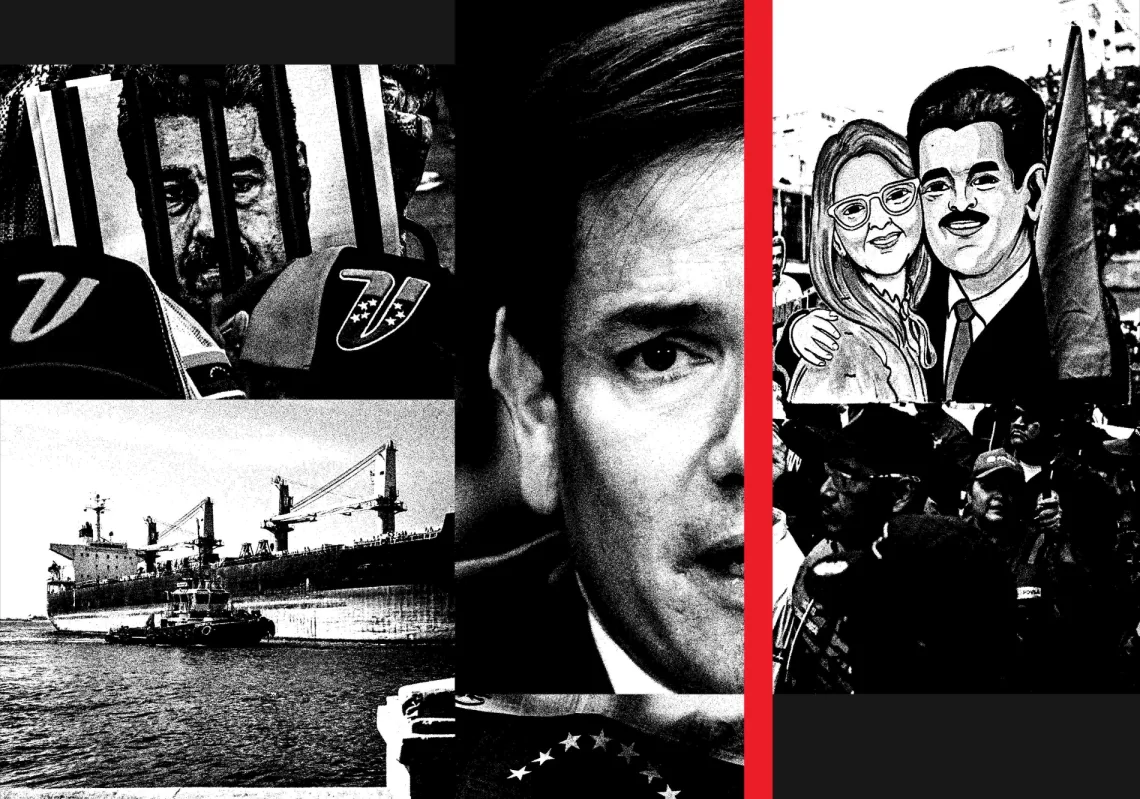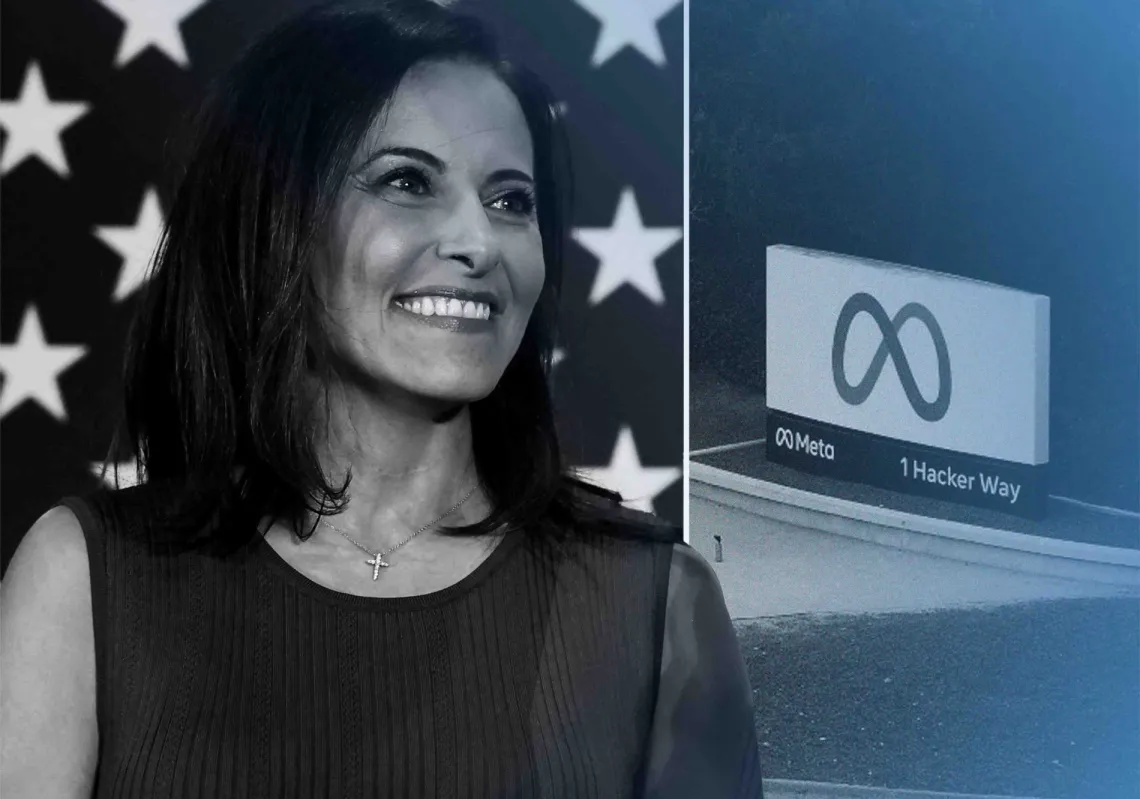كتب إيمي سيزير في النص التكريمي الذي نُشر بعد وفاة فرانز فانون (1961) معتبرا أن الكتاب الأساس عن الاستعمار وعواقبه الإنسانية وآثار العنصرية، هو كتاب فانون "بشرة سوداء، أقنعة بيضاء". "أما بالنسبة إلى التحرر من الاستعمار، وجوانبه وإشكالاته، فالكتاب الأساس، بالنسبة إلى سيزير هو أيضا كتاب فانون: "معذبو الأرض". فهل تنحصر قيمة فرانز فانون في الفترة الاستعمارية وما أعقبها مباشرة، أم لا يزال ممكنا اعتماده لتحليل علاقتنا بالغرب؟
كتب فانون في "بشرة سوداء، أقنعة بيضاء": "إذا نازعني الأبيض في إنسانيتي، فسأثبت له أنني لست الزنجي الساذج الذي يتخيله دائما، وذلك بأن أفرض على حياته ثقل وجودي كإنسان. أكتشف نفسي يوما ما في هذا العالم، وأعترف لنفسي بحق واحد فقط: حق مطالبة الآخر بسلوك إنساني. وأنا علي واجب واحد: ألا أنكر حريتي من خلال خياراتي... لا يجب أن تكرس حياتي لجرد قيم الزنوج، لا يوجد عالَمٌ أبيض، كما لا توجد أخلاق بيضاء، ولا حتى ذكاء أبيض، هناك فقط، على جانبي هذا العالم، بشرٌ يبحثون عن ذواتهم".
الغرب الأدهى
يظهر أن هذه العبارات جميعها لا تزال تنبض حياة، وأنها تصف واقع الحال، وأن ما كتبه فانون يتجاوز الفترة الاستعمارية، وأنه تحليل لعلاقة الغرب المعاصر بالآخر، سواء أكان هذا الآخر هو الشعوب التي عرفت الاستعمار، أو كان يتمثل في المهاجرين اليوم. إلا أن هناك من يرون أنه لا يكفينا لتحليل العولمة وحروب الهويات وأوضاع المهاجرين، وما يمزق العالم المعاصر، لا يكفينا أن نطبق ما كنا نقوله عن الغرب مستعمِرا، وأن الغرب ربما صار أكثر "دهاء"، حتى إن اتخذ دهاؤه صورة أكثر نعومة، هذا إن لم نقل إنه أصبح يتنكر حتى لمبادئه، ويفقد صوابه.