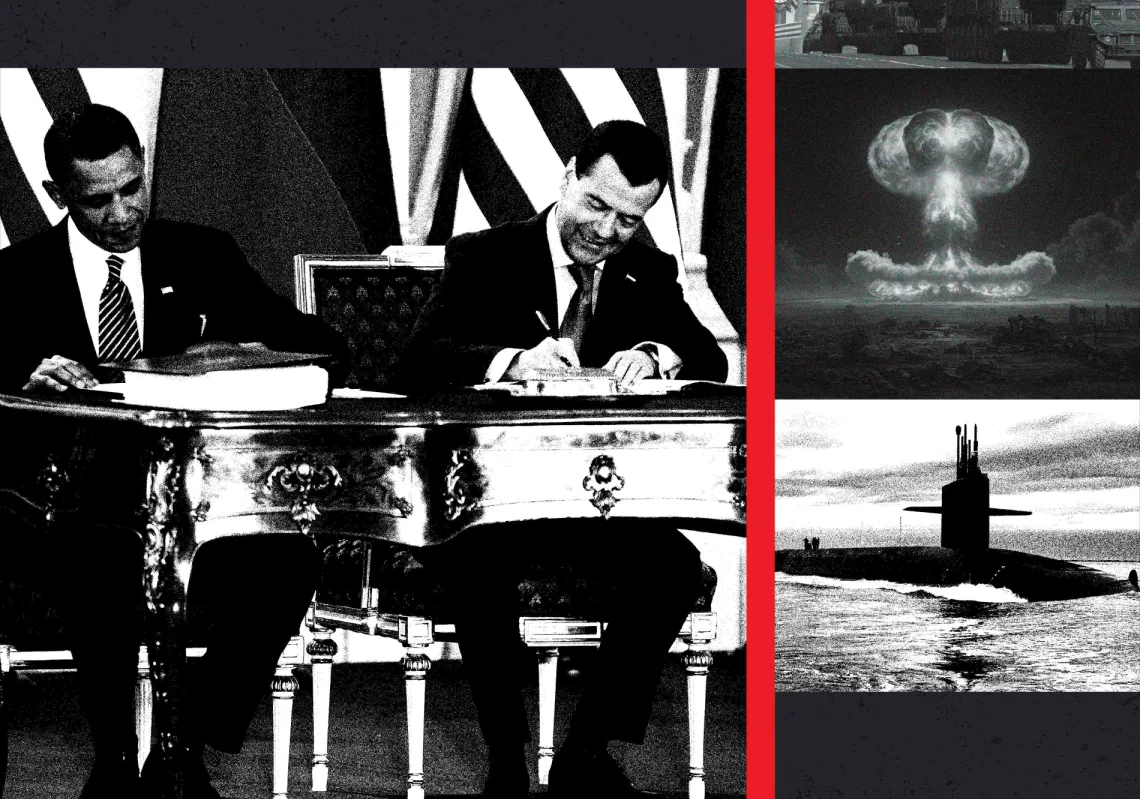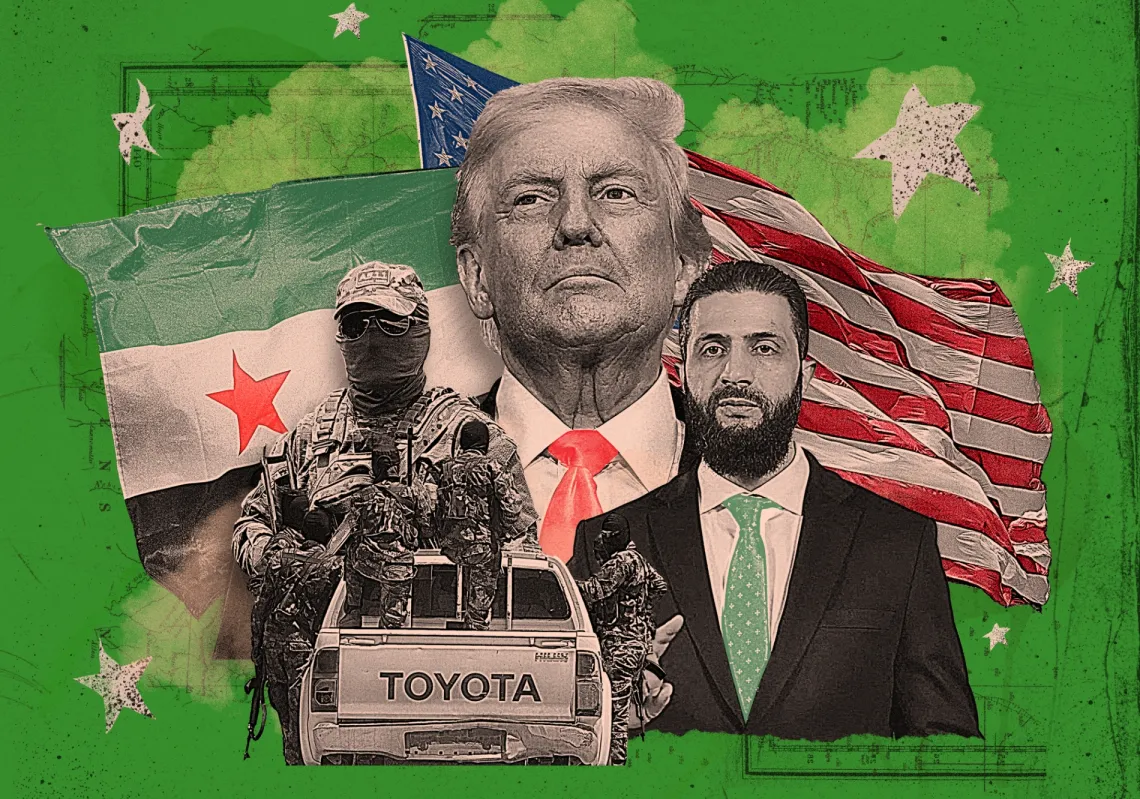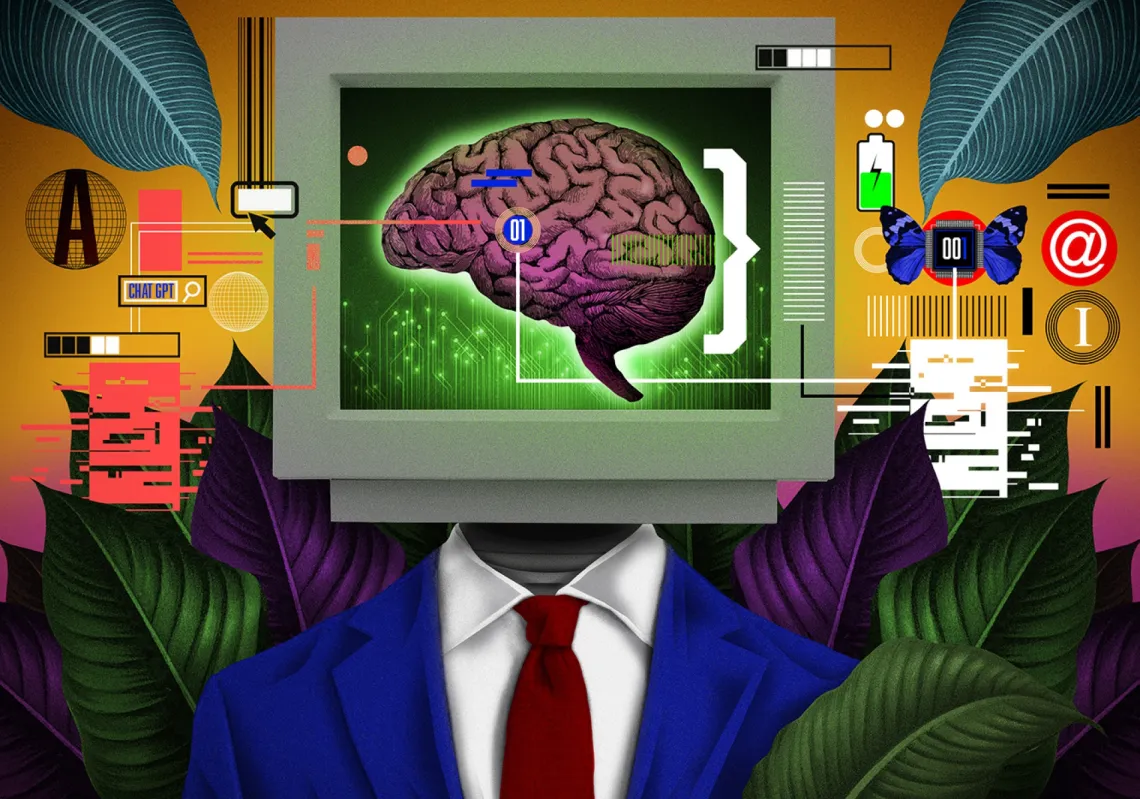قال الشاعر الفلسطيني يوسف القدرة إن الموت أصبح مناخا سائدا في غزة، وإن هناك دائما ما لا تصل إليه الكاميرات، وما لا يمكن ترجمته إلى صورة أو بث مباشر. وأضاف القدرة، الذي عاش أكثر من سنة ونصف السنة تحت نيران القصف، أن غزة لا تخرج من أهلها.
في هذا الحوار، تحدث يوسف القدرة الذي وصل قبل أسبوع إلى مرسيليا، جنوب فرنسا، الى "المجلة"، عن أيام وليالي الخوف التي عاشها، وكيف كان يواجه الموت بالكتابة، حيث كل جملة قد تكون الأخيرة. مضيفا أنه كان يكتب على الهاتف "دون شحن كاف، ودون ضوء سوى ما يصدر من الشاشة"، وأنه كان يكتب على ورق مقوى أحيانا، بعد أن يتحسس العتمة أو يتتبع صوت الطائرات. هنا نص الحوار.
خرجت من غزة. هل يمكن القول إنك نجوت؟ لقد عشت أكثر من سنة ونصف السنة تحت القصف، من بيت إلى خيمة، ومن خيمة إلى أخرى. كيف نفهم خروجك هذا في الوقت الذي نسمع فيه دعوات التهجير للغزيين؟
النجاة كلمة ثقيلة، تقال بسهولة، لكنها لا تعاش بسهولة. لم أنج، إنما انتزعت. كأن أحدهم قلعني من تربة صدري، ورماني في هواء لا أعرفه. ما حدث لم يكن خروجا، كان انفصالا مؤلما عن المدينة التي أحببتها حد التهلكة. كل خيمة تركتها خلفي كانت خيمة داخلي، وكل بيت تهدم على مرأى عيني، كان يشيد طبقة جديدة من الحنين فوق قلبي.
خروجي لم يكن نقيضا للثبات، إنه جزء من مقاومة صامتة. حين تصبح المدينة مسرحا دائما للقصف، لا يعود الرحيل خيانة، ولكن بحثا عن صوت منها يدوي باسمها.