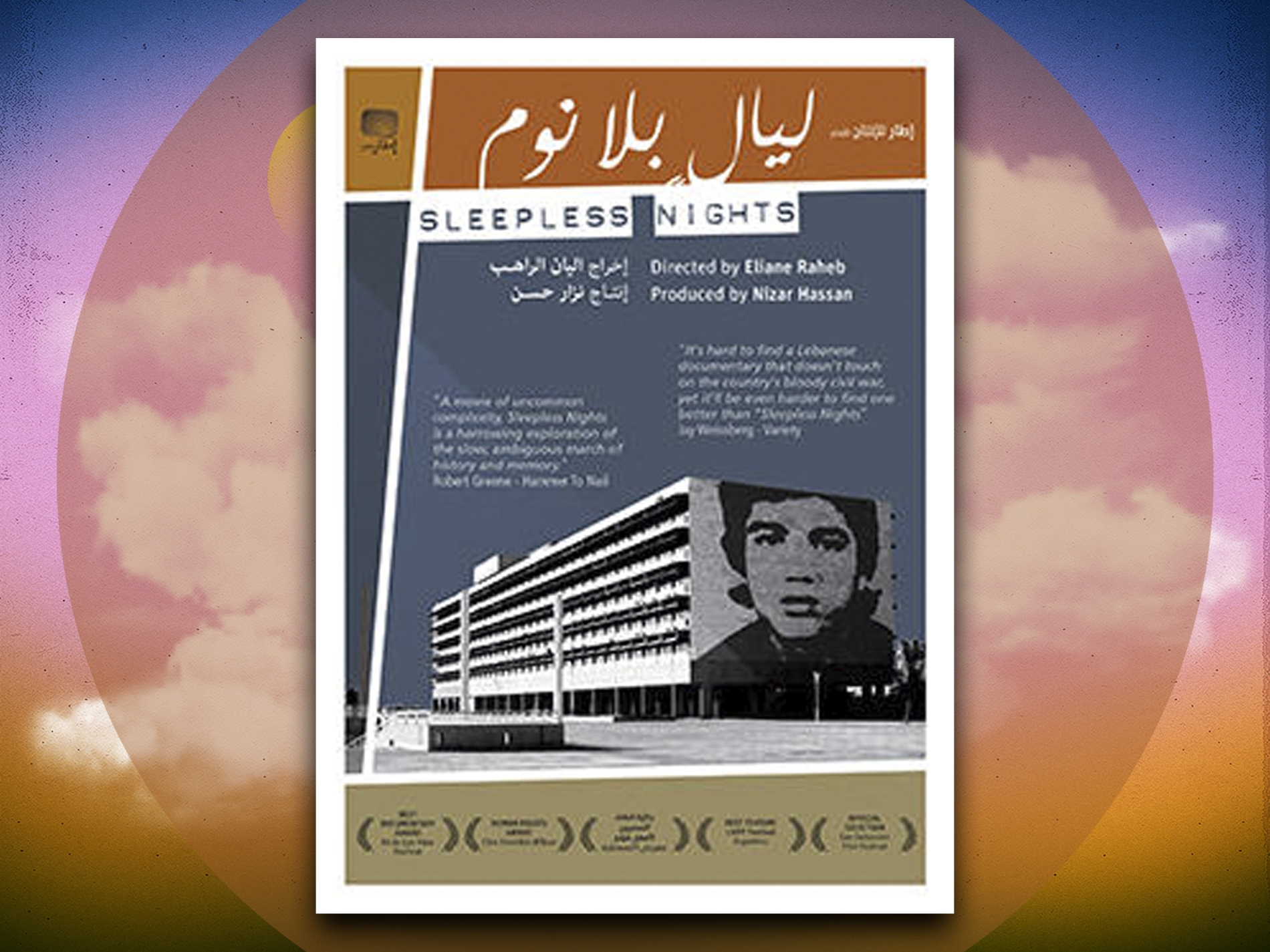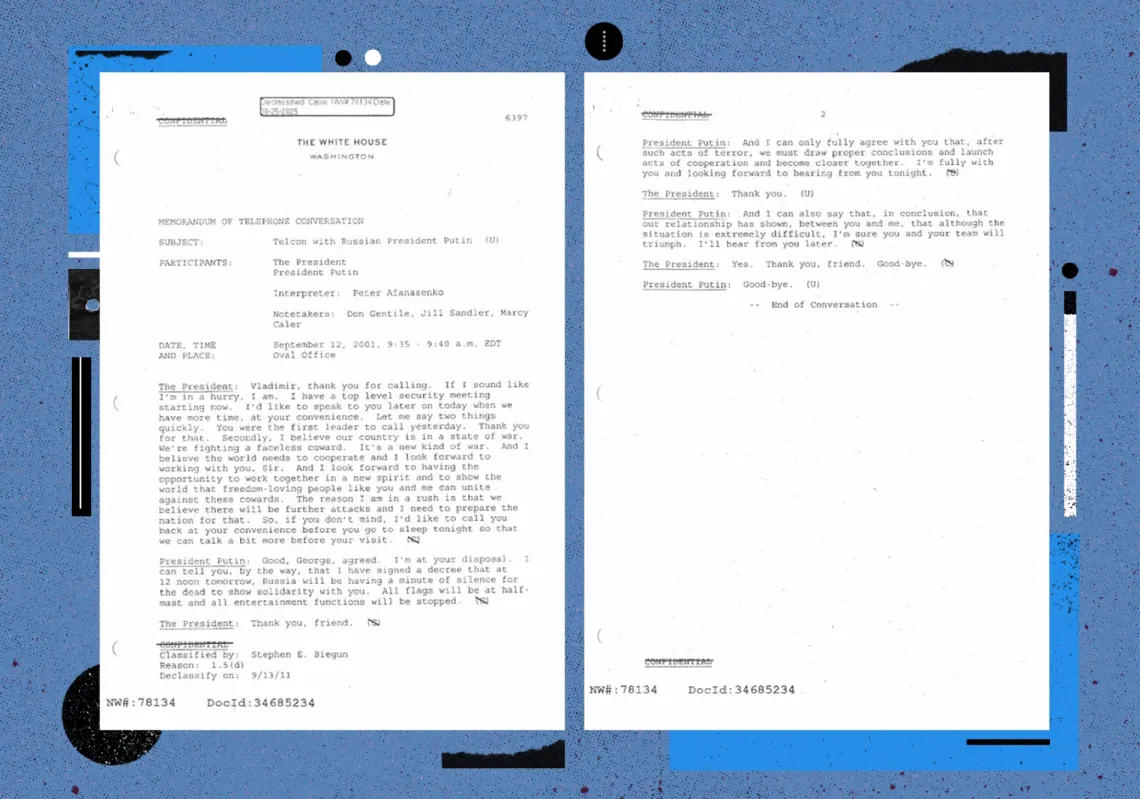لا يصل عدد الأفلام التي قدمتها السينما اللبنانية على امتداد نصف قرن، وتتعرض بشكل مباشر لقضية مفقودات ومفقودي الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، إلى العدد الكامل لأصابع اليدين.
في المقابل، فإن خيمة انتظار طويل، يتكسر فيها حزن متجمد ببطء كما في الأقاصي الأكثر برودة للنفس البشرية، نصبتها أمهات ملتاعات وسط حديقة في قلب بيروت، حملت اسم الشاعر والفيلسوف الذي دافع عن المحبة جبران خليل جبران، صدرت، على مدى سنين طوال، دفقا هائلا من أقسى صور الألم التي تخلفها الحروب الكارثية: قتل الأمهات ببطء عبر حجب معلومات تفيدهن لمعرفة مصير أبنائهن وبناتهن وأقاربهن من المغيبين قسرا، ومحاصرتهن من قبل السلطات (وهي ذاتها للمفارقة التي كانت ضالعة في عمليات القتل والتهجير والخطف طوال الحرب) بالإهمال والتضييق والوصم، تارة، أو تارة أخرى، بهندسة لجان وسياقات وأطر متابعة هشة واستعراضية ومفرغة، تفتقر إلى آليات تنفيذية ونيا تجدية، ليس هدفها إلا المماطلة أو الرهان على "ملل" الأمهات واستسلامهن.
ولكن كيف تضمر أرحام الذاكرة في طور التلاشي، طالما أجراس أجنتها تدوي كصرخات هائمة تنتظر الخلاص؟
سيطر هذا السؤال المترنح بين ضفاف الذاكرة والكرامة والمصالحة من جهة، وبين ضرورة المضي قدما، بحمل الإنكار وأسى تشرذم الهوية الذاتية والجماعية وخطيئة النسيان وبدعة "عفا الله عما مضى"، من جهة أخرى، على عقول مخرجين ومخرجات من أمثال بهيج حجيج وجوانا حاجي توما وخليل جريج وإليان الراهب وداليا خميسي ولينا أبيض، كما على عقول ممثلين من أمثال جوليا قصار وحسان مراد وآخرين، ممن خصصوا حيزا من أعمارهم وطاقاتهم الإبداعية، في السينما الروائية والوثائقية، على امتداد أكثر من ثلاثة عقود، لنقل مأساة 17000 مفقودة ومفقود، على أيدي ميليشيات مسيحية يمينية وأخرى فلسطينية و"وطنية"، وجهات سورية أسدية، وإسرائيلية، إلى صالات السينما والمعارض الفنية.
استلهم هؤلاء، والذين تحدثت إليهم "المجلة" لمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، شجاعة البوح والتحدي والمواجهة من نضالات أمهات أسسن، في خضم الحرب، إطارا تشاركيا للتحذير من استمرار سياسة الخطف والمطالبة باستعادة المفقودين، ثم بعد ذلك قمن بنصب مظلة، لتصبح بمرور الوقت "خيمة جبران"، مرآة لضمير الوطن المريض حد الاختفاء.
طحين أحمر
في 24 سبتمبر/ أيلول 1982، اقتحم مسلحون منزل عدنان حلواني وزوجته وداد، واقتاداه إلى المجهول. لكن وداد حلواني، التي نادت على زوجها الشاب كثيرا آنذاك، عبر موجات الإذاعات المتشظية في بحر القنابل والرصاص، قررت أن تغادر لحظة الشلل، الذي تخلفه المفاجأة الفاجعة، إلى لحظة الفعل. كانت موقنة، بحدس المرأة الأم، أن رجلها، الوديع الذي "كان نشاطه الأساسي تأمين الطحين للأفران وفتح أبواب الثانوية لتعليم الطلاب، لمنع استغلالهم في الحرب"، وإن لم يعد، إلا أن الطبيعة هيأتها لدور أكبر يتجاوز الاهتمام بحكايتها الشخصية إلى المساهمة بنقل مأساة آلاف الأمهات غيرها. أسست في العام ذاته "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان" التي كان لها الدور الرئيس في الضغط لإقرار قانون (2018) ثم هيئة رسمية (2020). وهذه الأخيرة "لم تعط أدنى مقومات الفعل التي نص عليها القانون"، بحسب حلواني، التي شعبت قوة القضية وزخمتها بتأسيس أطر حقوقية أخرى من بينها: الشبكة الدولية للضحايا والناجين من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، الجمعية اللبنانية لمراقبة ديمقراطية الانتخابات، الفيديرالية الأورومتوسطية لعائلات المفقودين والمخفيين قسريا، والشبكة الدولية لعائلات المفقودين. لم توفر حلواني وسيلة من أجل مواجهة ذلك الصمت المتعمد الجاثم كصخرة على صدور الأمهات، فاستحقت لقب "النملة التي حفرت في الصخر لعقود"، كما يشير عمل مسرحي حديث عرض أخيرا في بيروت مستوحى من سيرتها النضالية.