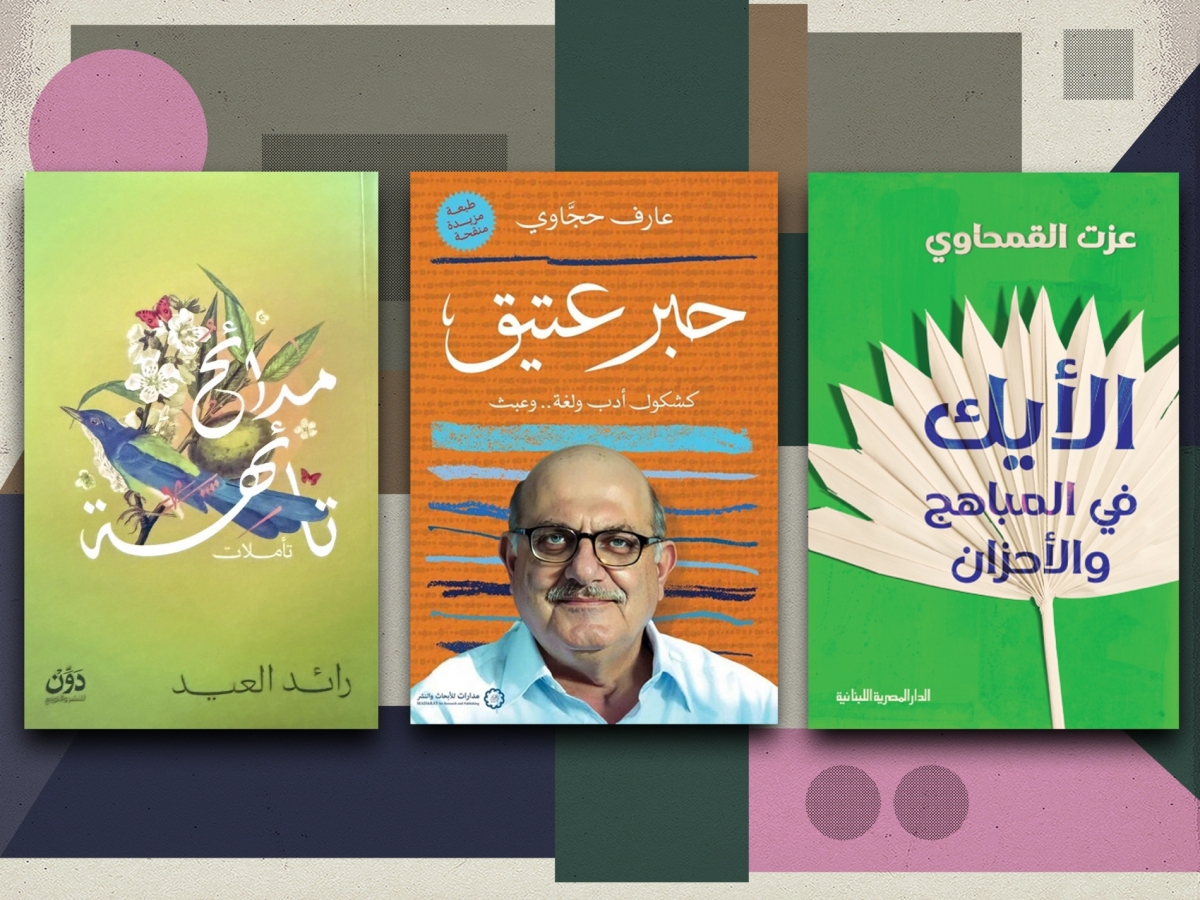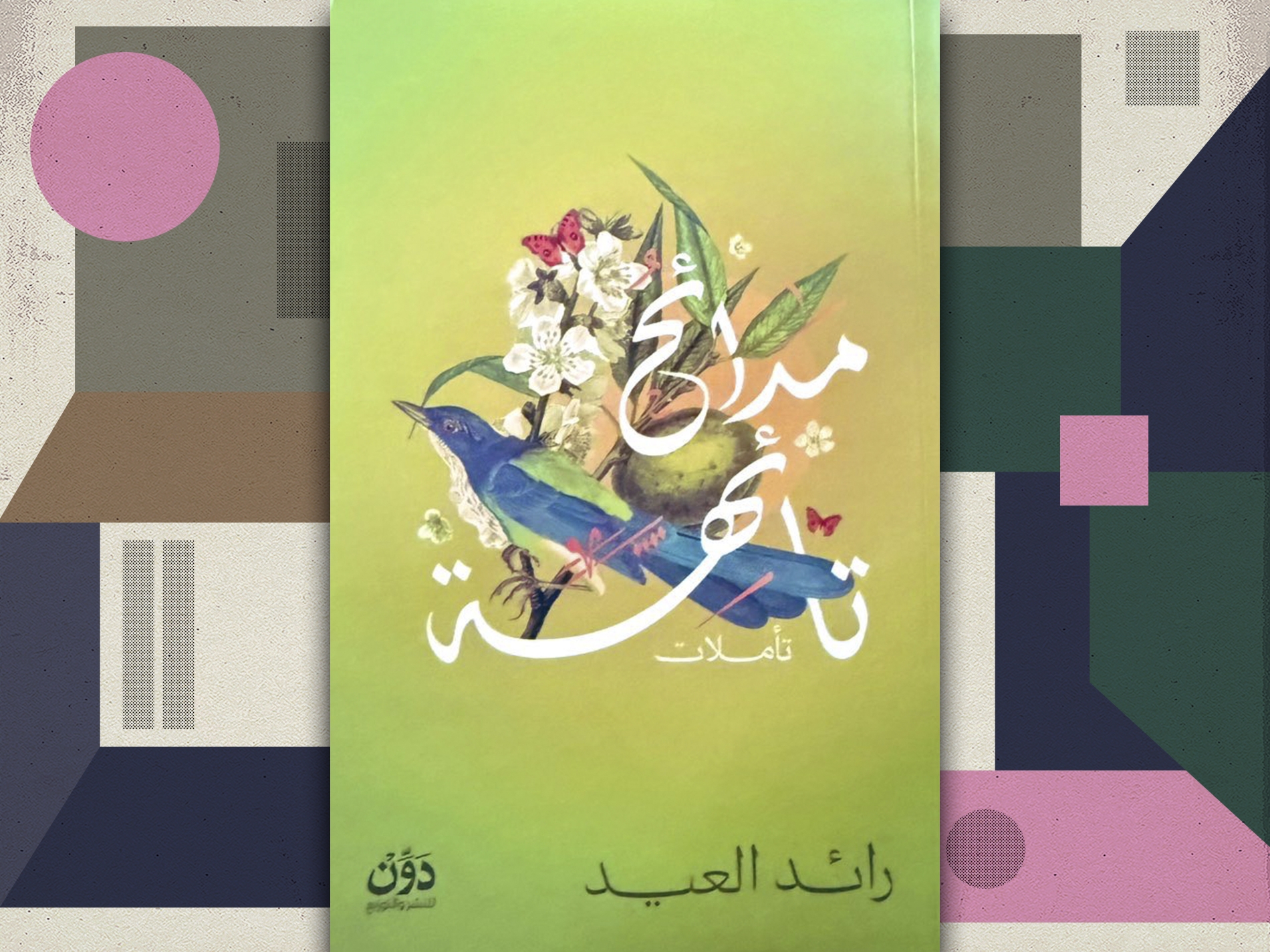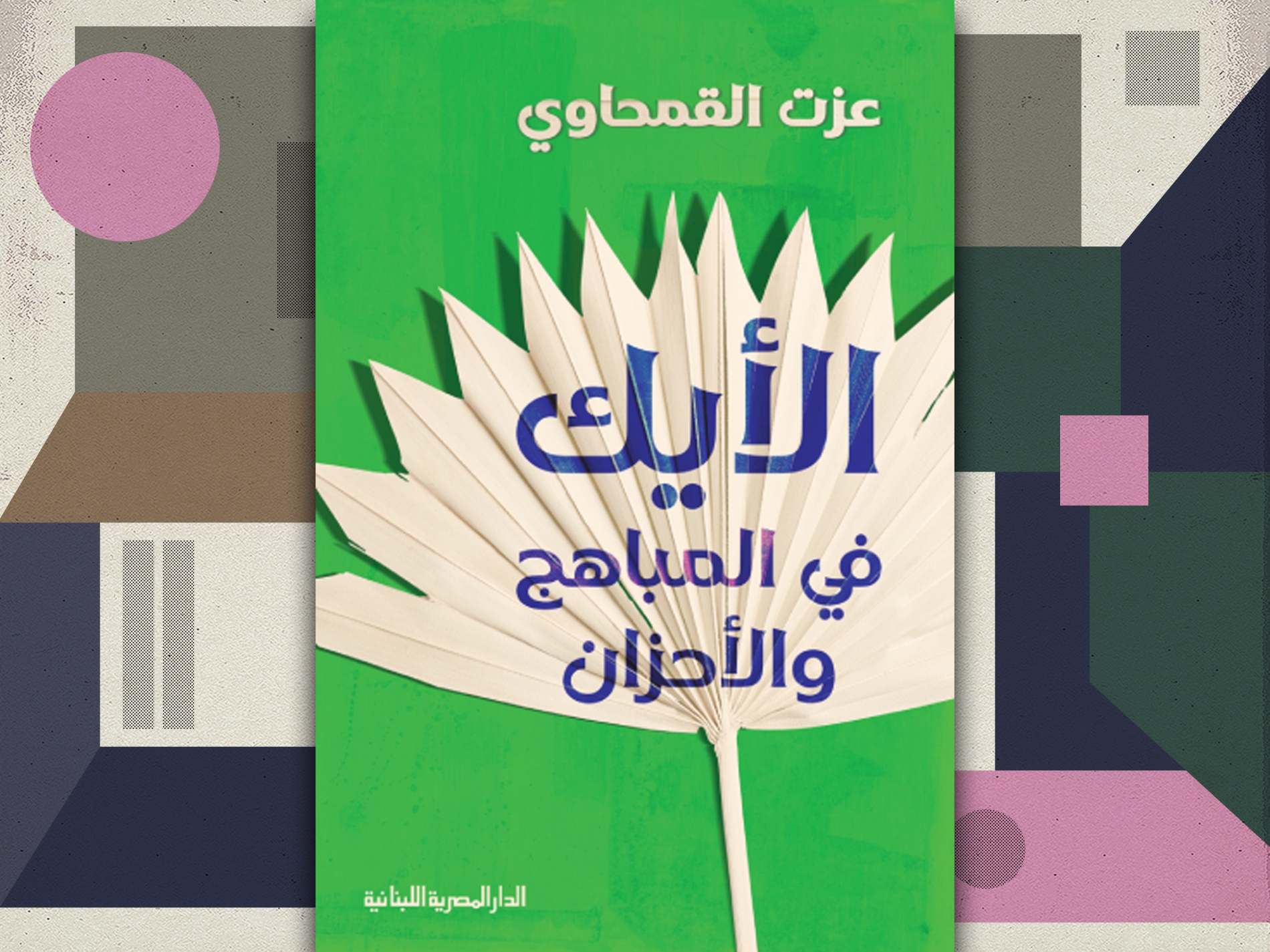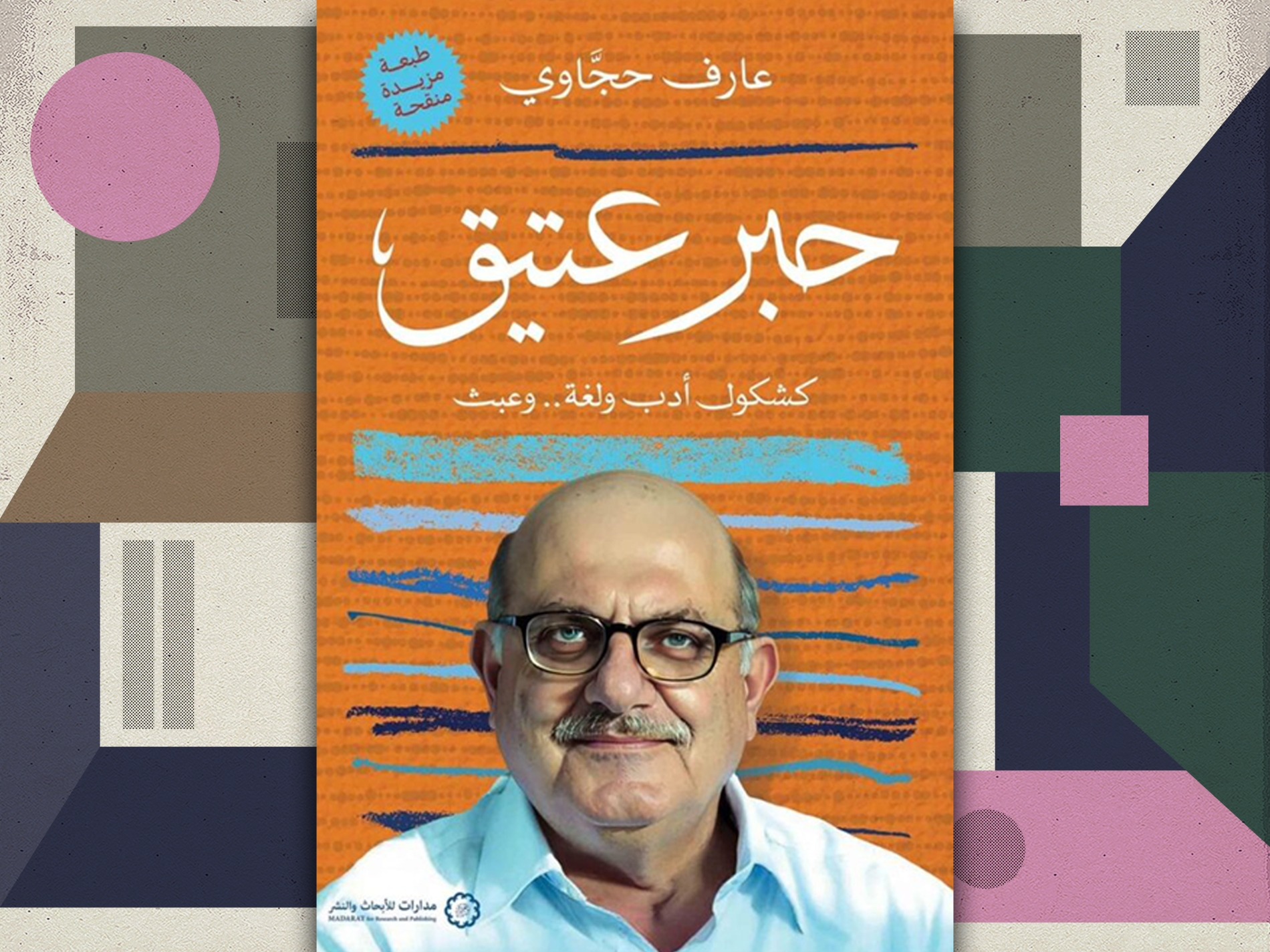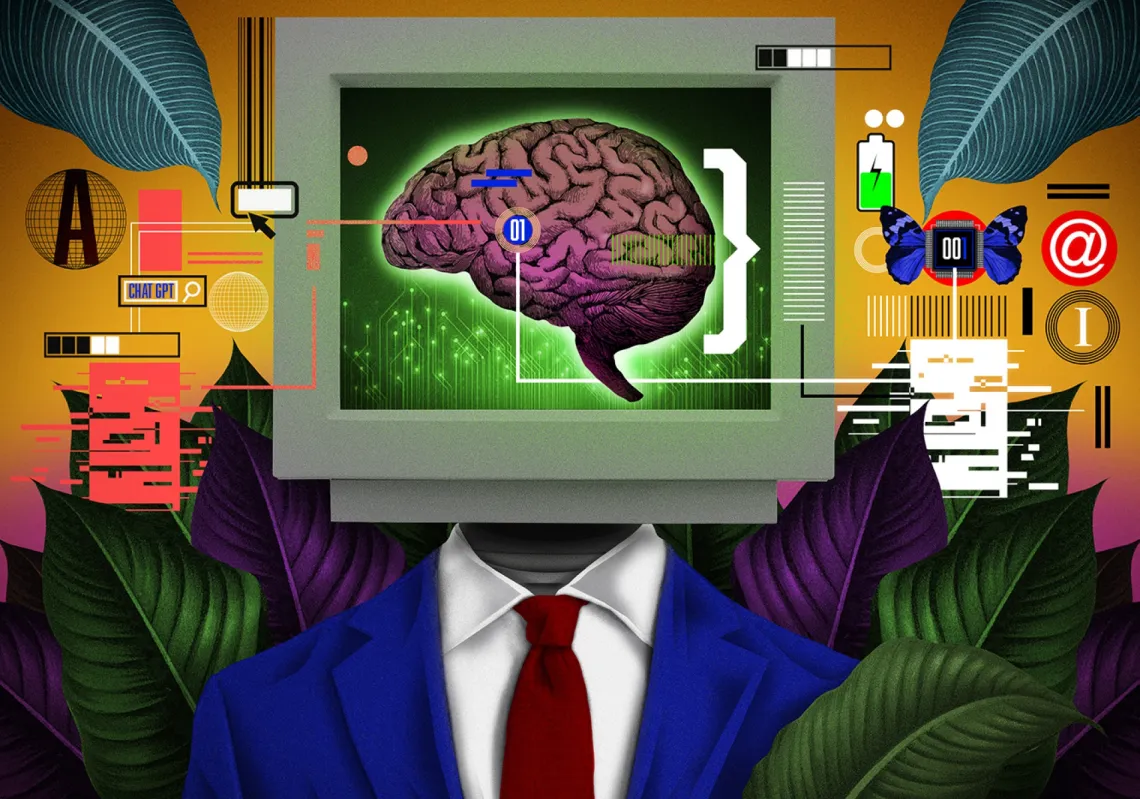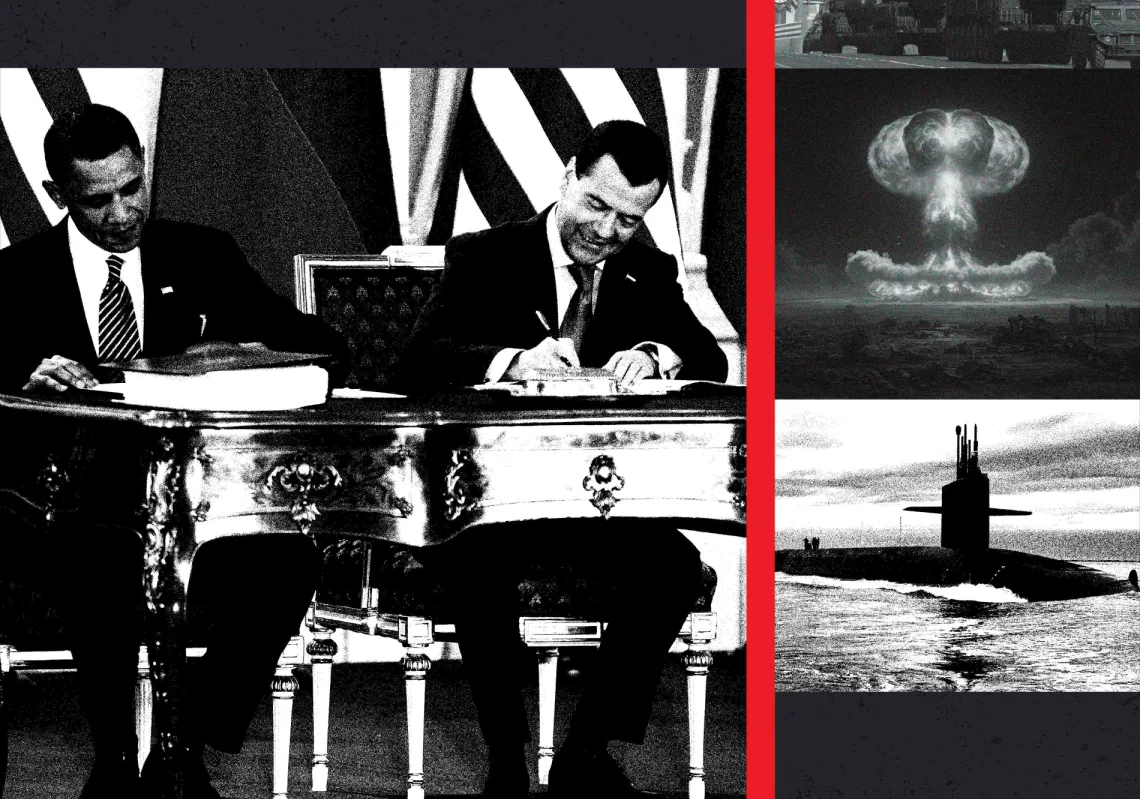كيف يقرأ الكاتب العالم ويتعامل معه؟ لعل هذا هو السؤال الذي يتبادر الى القراء حينما يطالعون عددا من الكتب يظهر فيها ولع مختلف واهتمام خاص بتأمل العالم والتوقف عند تفاصيله التي ربما تمر علينا بشكل عابر.
بين هذه الأعمال، ثلاثة إصدارات يختلف أصحابها في بيئاتهم وثقافتهم، وربما مرجعياتهم الفكرية ومنطلقات الكتابة عند كل منهم، ولكن تجمع بينهم سمة التأمل والتفكر، والسباحة بين المعاني والأفكار بطريقة جذابة وذكية، تأسر القراء وتجذب انتباههم إلى هذا النوع من الكتابة الذي يندر وجوده في العربية، لا سيما بين كتاب لهم باع طويل في الكتابة الأدبية.
الملاحظ بين هذه الكتب الثلاثة، على اختلافها، أنها تجتمع تقريبا على البدء باللغة والاهتمام بها، بل وتأمل معاني المفردات، فاللغة ومعانيها موضوع أساس عند عارف حجاوي في كتابه "حبر عتيق"، والدوران حول المعاني واختيار ألفاظ ذات معان مجازية دالة، وسيلة عزت القمحاوي في كتابه "الأيك في المباهج والأحزان"، حيث يبدو الاهتمام بالبناء اللغوي والتراثي واضحا في عنوانه، وحتى عند رائد العيد في "مدائح تائهة" يبدو التركيز في الفصول والعناوين على المعاني اللغوية التي تحضر لدى القارئ بمجرد سماع الكلمة، بدءا بالمديح والبدايات مرورا بالحديث عن "اللامكان" و"اللعب"، وصولا إلى الـنظر من الأعلى والهوامش.
في مقدمة كتابه "الأيك في المباهج والأحزان"، يشير القمحاوي بوضوح إلى رغبته في الكتابة خارج أطر الفنون الأدبية التقليدية من قصة ورواية، فيقول: "لم أكن مدفوعا سوى برغبة غامضة في رصف الكلمات التي من شأنها أن تجلب لي المتعة، ولنفسها عطف القارئ وهذا أقل ما تستطيعه اللغة، وقد كان القليل منها في بعض لفائف البردي يرافق الميت من أسلافي إلى قبره، فيضمن له الحياة وعطف الآلهة".
"مدائح تائهة" لرائد العيد
رغم أنه يبدأ بالمديح، إلا أنه ينطلق منه إلى تأملات مختلفة تماما شديدة الثراء والجاذبية، يرى الكاتب السعودي رائد العيد في كتابه "مدائح تائهة" (صادر اخيرا عن دار دون) أن المديح ابن التأمل والتأمل، نبش في عمق لا يرى، وعلى هذا الأساس يبدأ كتابه وتأملاته، فيشير إلى أن المدح سمة الإنسان التي لا يشاركه فيها غيره، والحاجة إلى المديح والإعجاب حاجة بشرية بذلا واستقبالا بغير غرور ولا اعتلاء. ثم ينتقل من المعاني اللغوية للمدح إلى الحالة المعروفة اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي بالإعجاب و"اللايك" وكيف أصبحت مؤثرة على الناس إلى الدرجة التي يعرف بها بعضهم وفقا لعدد المتابعين أو المعجبين بهم، وهو في ذلك كله يرصد تلك الحالة ويبين أثرها ويقف أمامها للرصد والتحليل بشكل واقعي.