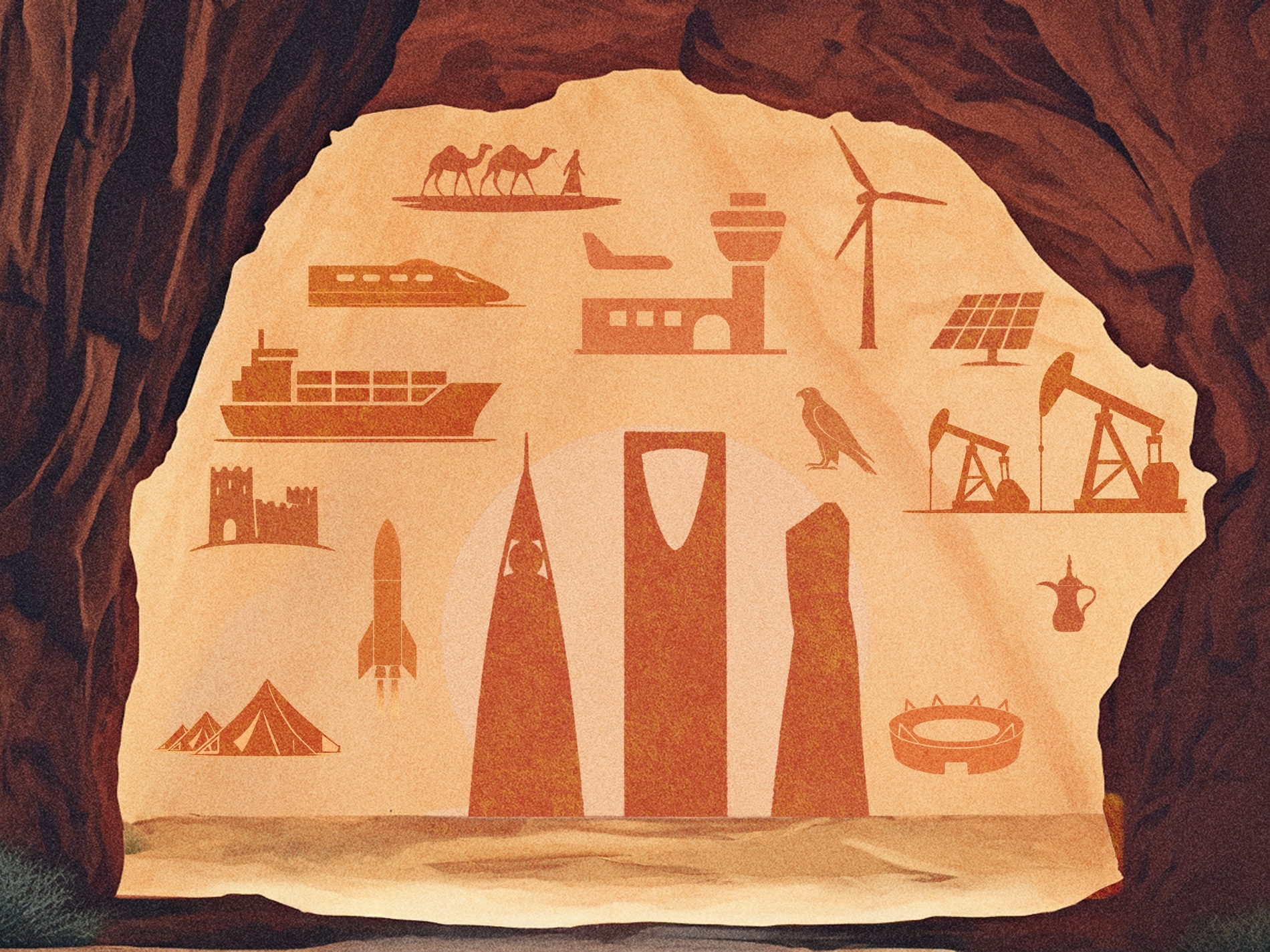يشيع بين بعض الكتاب والخصوم أن الدولة السعودية في مرحلتها الأولى لم تكن سوى ثورة على الدولة العثمانية، وأنها منذ لحظة ولادتها حملت مشروع تمرد على الخلافة القائمة في إسطنبول. هذه الصورة، وإن راقت للبعض في سياق الخصومة السياسية والفكرية، فإنها بعيدة عن الحقيقة التاريخية إذا وضعناها في سياقها الواقعي في مطلع القرن الثامن عشر. فالجزيرة العربية في تلك الحقبة لم تكن ساحة يهيمن عليها النفوذ العثماني المباشر، بل فضاء واسعا يعيش في فراغ سياسي مستحكم. لم يكن للعثمانيين وجود فعلي في قلب نجد: لا وال يعين فيها، ولا جيش يرابط في مدنها وقراها، ولا جهاز إداري يسيطر على شؤون أهلها. اقتصرت سيطرتهم على الأطراف، فالحجاز خضع لنفوذهم عبر شريف مكة، والأحساء ارتبطت بولاة البصرة، واليمن عرف بولاة متذبذبي النفوذ، بينما العراق كان بيد ولاة بغداد. أما الداخل النجدي فظل متروكا لأهله، تتقاسمه زعامات محلية وأمراء صغار يتداولون السلطة كلما تبدلت موازين القوة.
وقائع موضوعية
كان هذا الواقع يعني أن كل بلدة أو قرية تحولت إلى ما يشبه الإمارة الصغيرة المستقلة، يحكمها شيخ أو أمير، وتتحدد قوتها بمقدار ما تمتلك من رجال وسلاح وما تعقده من تحالفات قبلية. لكن هذه التحالفات كانت هشة، لا تعمر طويلا، فما يجمع الناس اليوم قد يفرقهم غدا، وما تعقده المجالس قد ينقضه السيف. لذلك عاش المجتمع النجدي في حال دائم من التشرذم والاضطراب. ولم يكن هذا التشرذم مجرد مسألة سياسية عليا، بل انعكس على تفاصيل حياة الناس اليومية. فالأمن كان شبه مفقود، والقوافل التجارية لا تأمن الطريق، والغزوات القبلية تهدد المزارع في حقله، والبدوي في باديته، بل حتى سكان المدن أنفسهم لم يسلموا من الاضطرابات. لم يعرف الناس الاطمئنان الكامل في أي مكان، إذ ظل خطر الغزو أو النزاع قائما في كل لحظة. وهكذا أصبح الأمن رأس المال الأول في عيون الأهالي، والمطلب الذي يبحثون عنه قبل أي شيء آخر.