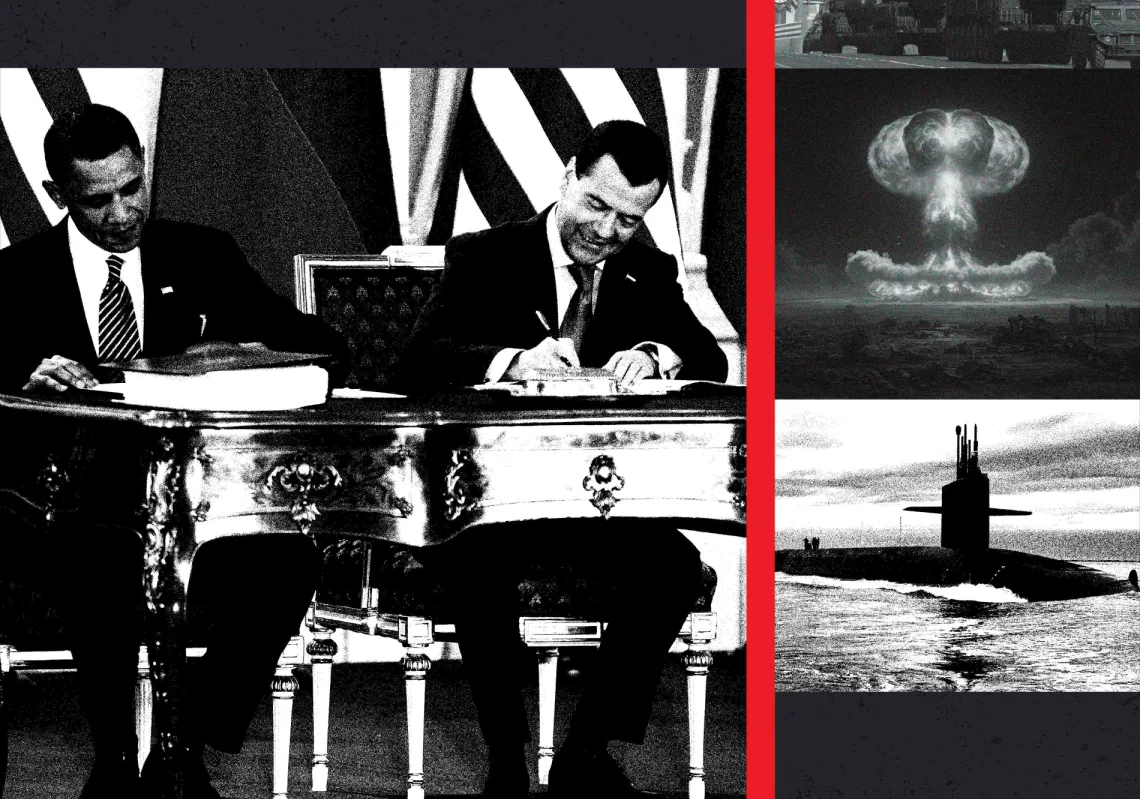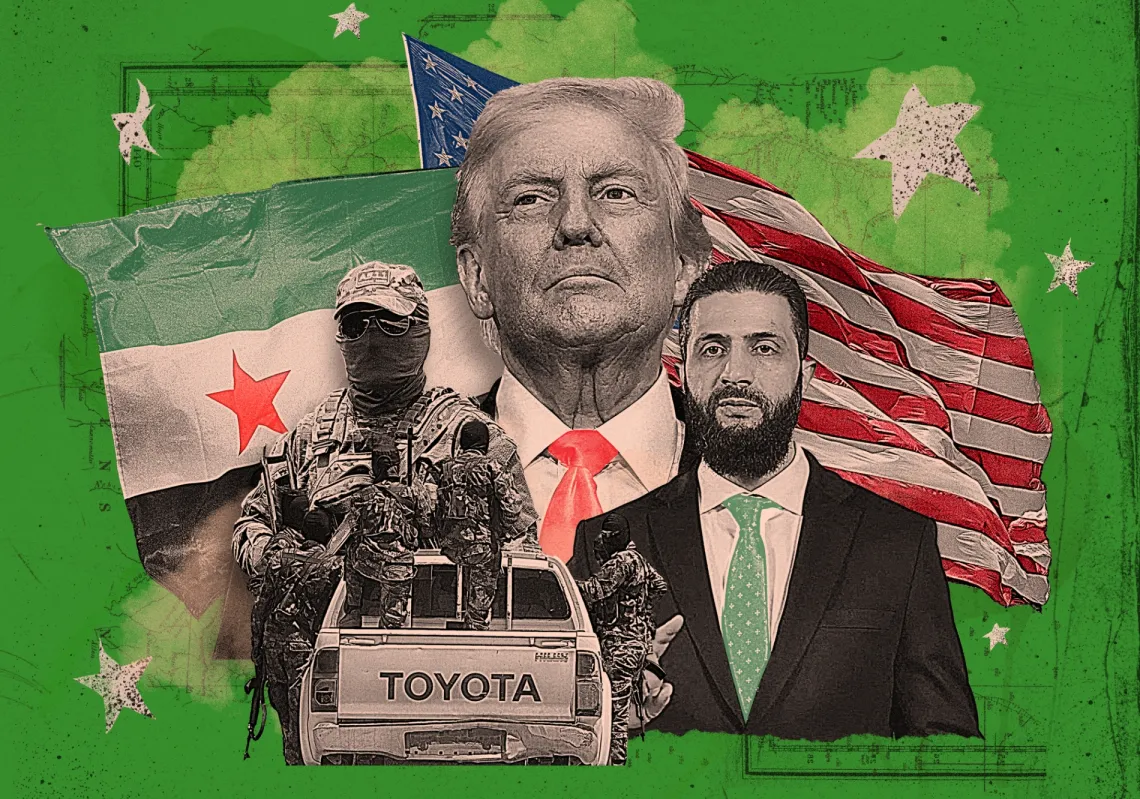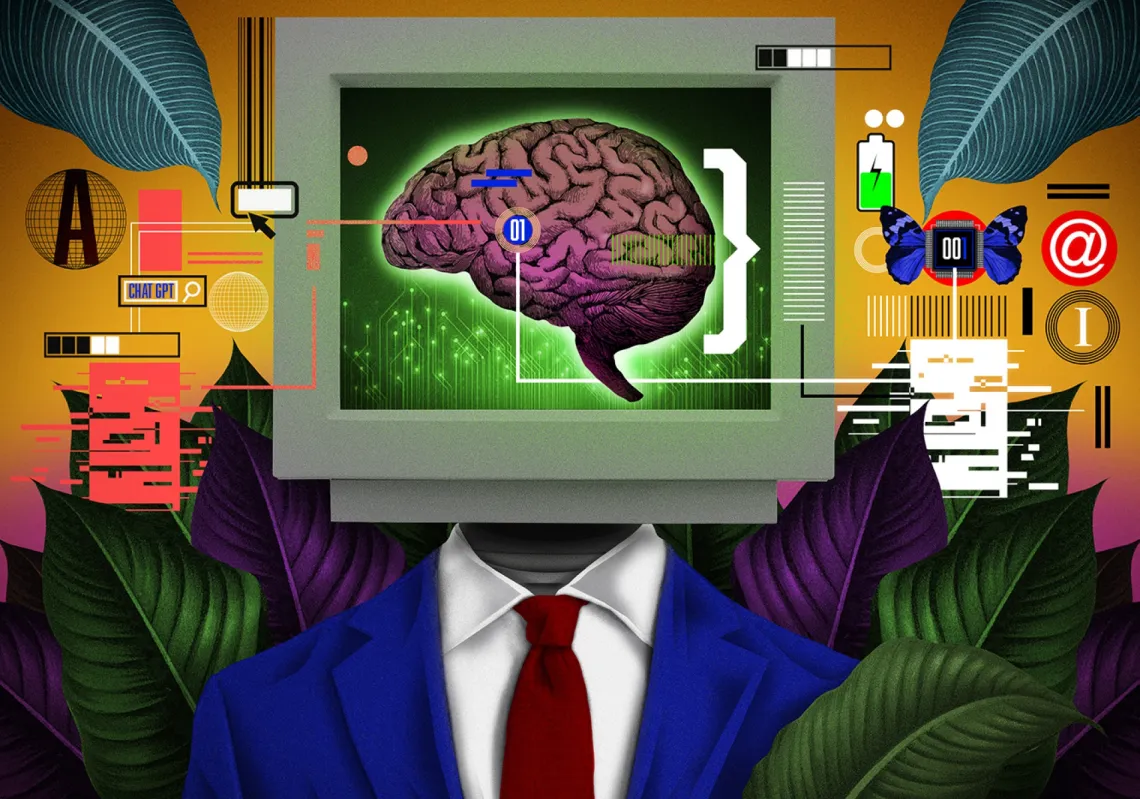ما الذي يحدث في علاقة الذكور بالتعليم في تونس؟ لقد صار عددهم يمثل أقلية صغرى بين المتعلمين. فالإناث في هذا البلد يمثلن اليوم 70% من مجموع متخرجي التعليم العالي، و62% من مجموع حائزي شهادة الدكتوراه، أعلى الشهادات الجامعية.
وفي الوقت نفسه، أصبحت تونس تحتل المرتبة الأولى عالميا على مستوى نسبة الطالبات في المجالات العلمية (علوم، تكنولوجيا، هندسة، رياضيات)، فقد وصلت هذه النسبة إلى 49.45%، أي أنها قاربت التناصف بين الذكور والإناث، وبصفة عامة تمثل الإناث الغالبية بين الطلاب، حيث يوجد تقريبا طالبتان لكل طالب مسجل بالجامعات التونسية.
لكن المسألة لا تتعلق بالتعليم العالي فحسب، فأرقام امتحان البكالوريا (الثانوية العامة) منحازة أيضا إلى الإناث. في الدورة الأخيرة (2025) توزعت نتائج الناجحين بين 63% من الإناث و37% من الذكور، وإن كان تفوق الإناث ترسخ منذ زمن طويل، إلا أن الفارق بين الجنسين يتعمق تدريجيا بمرور السنين، فكانت نسب النجاح بين سنتي 2008 و2010، 61% تقريبا لصالح الإناث و39% لفائدة الذكور، وظلت كذلك حتى سنة 2022، لكن الدورة الأخيرة سجلت اتساع الهوة بفارق نقطتين.
الأسباب الاجتماعية للتفاوت التعليمي
من بين أسباب هذا التفاوت الإيجابي لصالح الاناث، يذكر المستشار العام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، والمدير السابق للتوجيه الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السيد منصف الخميري لـ"المجلة"، تشتت التركيز لدى فئة الذكور نتيجة توفر مساحات كبرى من اللهو وتمضية الوقت في انشغالات موازية خاصة في ظل الانفجار الرقمي الحديث، وكذلك تعدد مسالك الجنوح، والانخراط في مسالك مغرية لكنها محفوفة بخطر الدفع نحو التسرب المبكر. يحصل ذلك، حسب قوله، مقابل تركيز أكبر لدى الفتيات اللواتي وعين بأن لا خلاص لهن في مجتمع ذكوري غير منصف في غالب الأحيان، إلا عبر التحصيل الدراسي والجامعي وكسب استقلالية مادية تقيهن شبح الإخضاع الأسري تحت ضغط التبعية الاقتصادية.