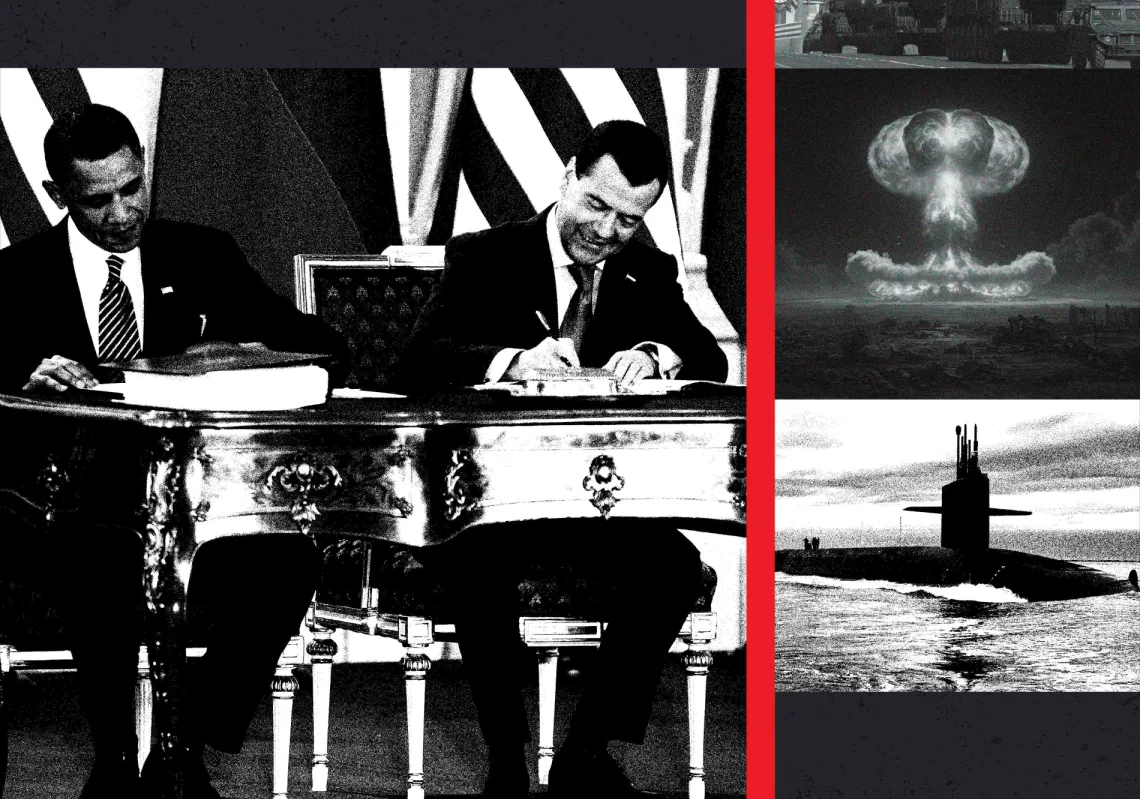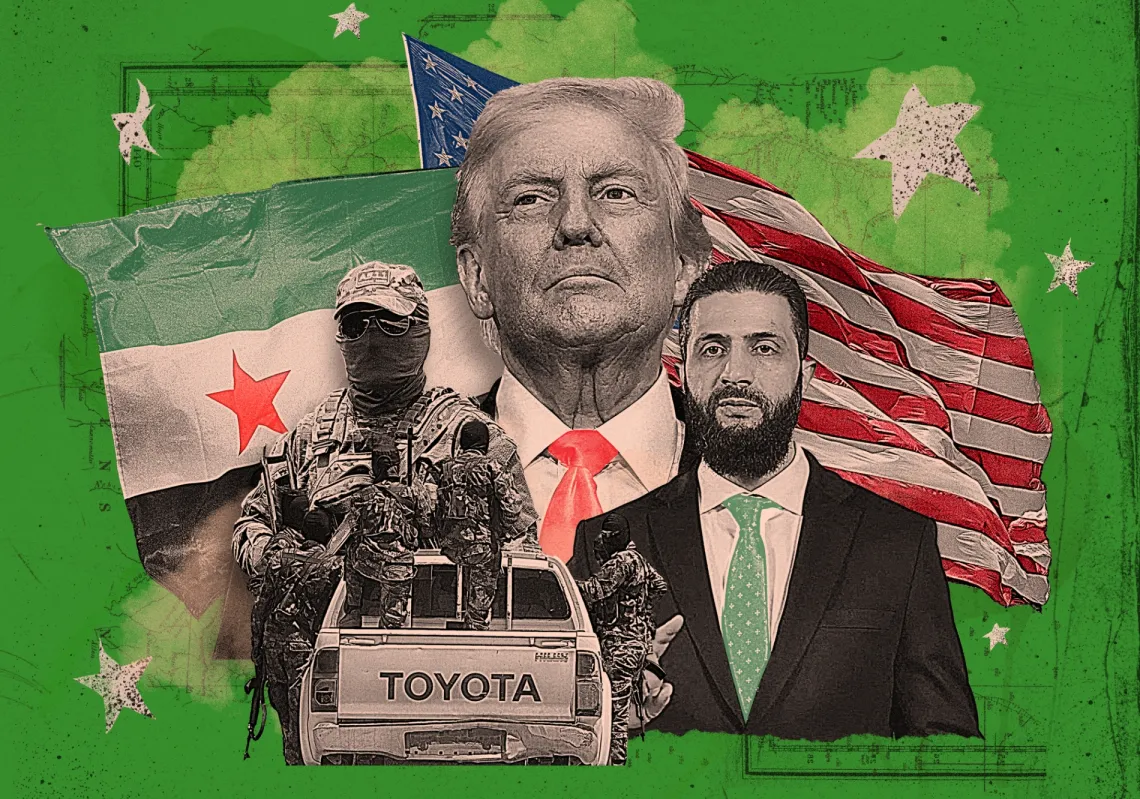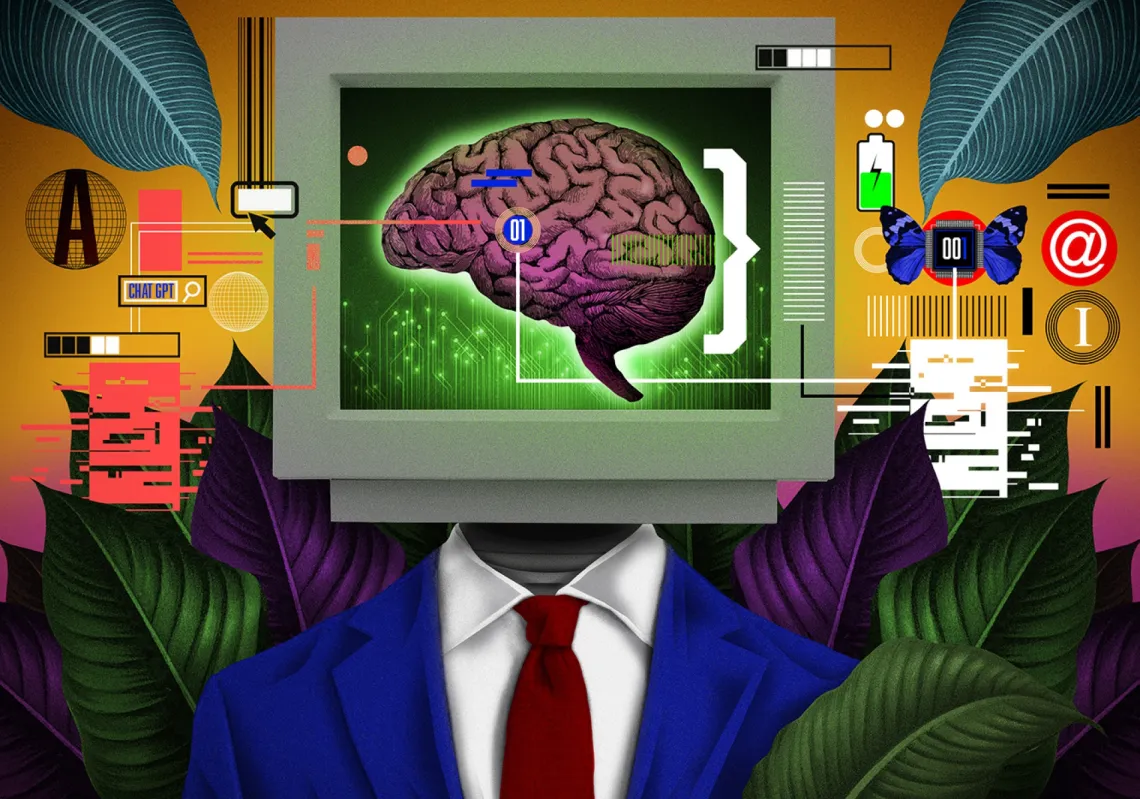في مثل هذا الوقت من عام 1948، وتحديدا في الثامن والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول، كانت فلسطين على أعتاب نفق طويل من الانقسام والشتات، حين اجتاحت قوات الاحتلال بيتا صغيرا في ترشيحا، المدينة التي ارتبط اسمها بفاجعة لا تنسى، بطلتها فاطمة الهواري (1930–2012). شابة في مقتبل العمر تستعد لزفافها، قبل أن تدهمها غارة جوية انتقامية محملة بالدمار، تبدد أحلامها في الهواء، وتفقدها عريسها وذويها، تاركة لها شللا ظل يلازمها بقية حياتها.
بعد نحو نصف قرن، عاد الطيار الذي قاد تلك الطائرة، مصطحبا كاميرات "سي إن إن"، ليعترف بجريمته ويقدم اعتذارا علنيا، لتتجسد أمام الشاشات والتاريخ مواجهة استثنائية بين الجلاد وضحيته.
انطلاقا من هذه الواقعة المأسوية، يغزل المسرحي الأردني الفلسطيني غنام غنام فصلا جديدا في سرديته الفلسطينية، مستعيدا الحدث لا باعتباره يخص امرأة بعينها أو مكانا محددا، بل كظل لوطن يحاول لملمة ذاته، كأنه إيزيس الفرعونية. هذا البعد الرمزي يتقاطع بقوة مع الممارسات الإسرائيلية الراهنة، ليترجمها في عرضه المسرحي "فاطمة الهواري.. لا تصالح"، الذي قدم أخيرا في القاهرة ضمن فعاليات "مهرجان إيزيس لمسرح المرأة"، بعد أن شهد عرضه الأول في "مهرجان الرحالة للفضاءات المغايرة" بالأردن، أغسطس/آب الماضي. يذكر أن العمل تطوعي بالكامل، من بطولة أماني بلعج (تونس)، وأحمد العمري (الأردن)، مع موسيقى ماهر الحلو وإضاءة ماهر الجريا.
يمتد العرض نحو ساعة، وتمتزج فيه السيرة الفردية مع سيرة أوسع تشمل الوطن والذاكرة الجمعية، ليصبح المسرح مرآة للغائبين، أولئك الذين يظهرون بالكلمة أو من خلال جسد يروي ما تعجز عنه الحكايات، ثم يرحلون تاركين طيفا لا يمحى. ليست "فاطمة الهواري" مجرد قصة عن الفقد، بل شهادة على عناد البقاء، السمة الغالبة على القضية الفلسطينية عموما، وعلى إيمان ثابت بأن الفن قادر على ترميم ما تهدم. إنها أيضا تجربة مخرج يواصل الكتابة من حافة المعاناة، مؤمنا بأن المسرح يستطيع أن يعيد الى الإنسان صوته، حتى لو كان هذا الصوت هو آخر ما يمكن سماعه، وسط صمت العالم.
لا تصالح
ينطلق غنام وفريقه من تقليد قديم كان الحكاؤون يحرصون عليه، إذ يبدأون بالترحيب بالجمهور قبل الدخول في الحكاية. لكن ما إن يبدأ هذا التمهيد الودود حتى ينزلق بسلاسة إلى صلب العرض، فيتداخل الترحيب مع الأداء، ويشتبك الممثلون في جدل طريف حول الاسم: أهي "لعبة فرجوية مسرحية"، كما تقول أماني بلعج، أم "لعبة مسرحية فرجوية" كما يؤكد أحمد العمري؟ هنا يتدخل غنام ليكسر الحائط الرابع، ويخاطب أسماء بعينها من المتفرجين من نقاد ومسرحيين لمشاركتهم الرأي في أزمة المصطلح، الأزمة التي تعاني منها غالبية المصطلحات، لذلك يحسم الجدل بين الطرفين مطمئنا إياهم: لعبة مسرحية فحسب. فالمهم هنا ليس الاسم أو التصنيف، بل البطولة الكبرى للحكاية نفسها. رغم بساطة تفصيلة كتلك، إلا أنها تحوي سخرية مبطنة من بعض الفرق الفلسطينية التي انشغلت بالتفرعات الشكلية على حساب جوهر القضية.