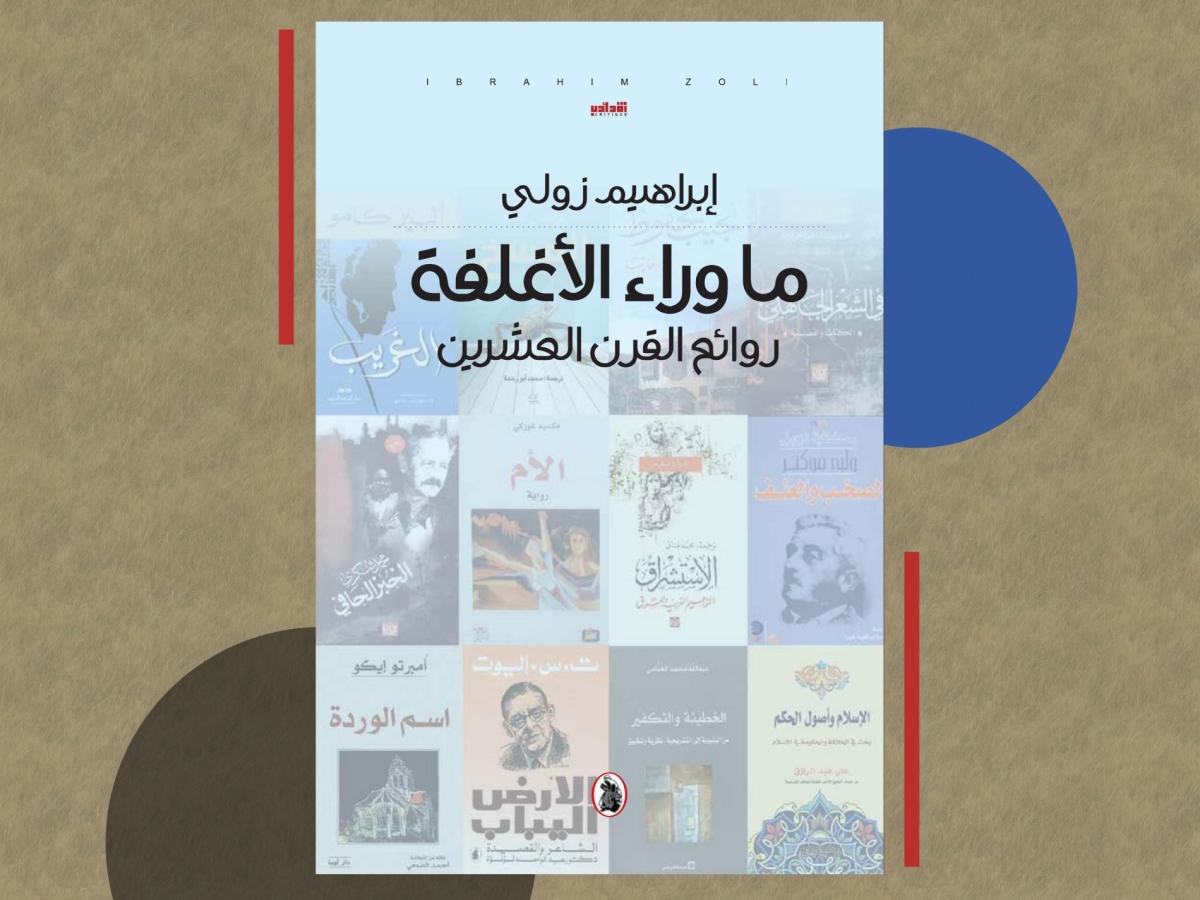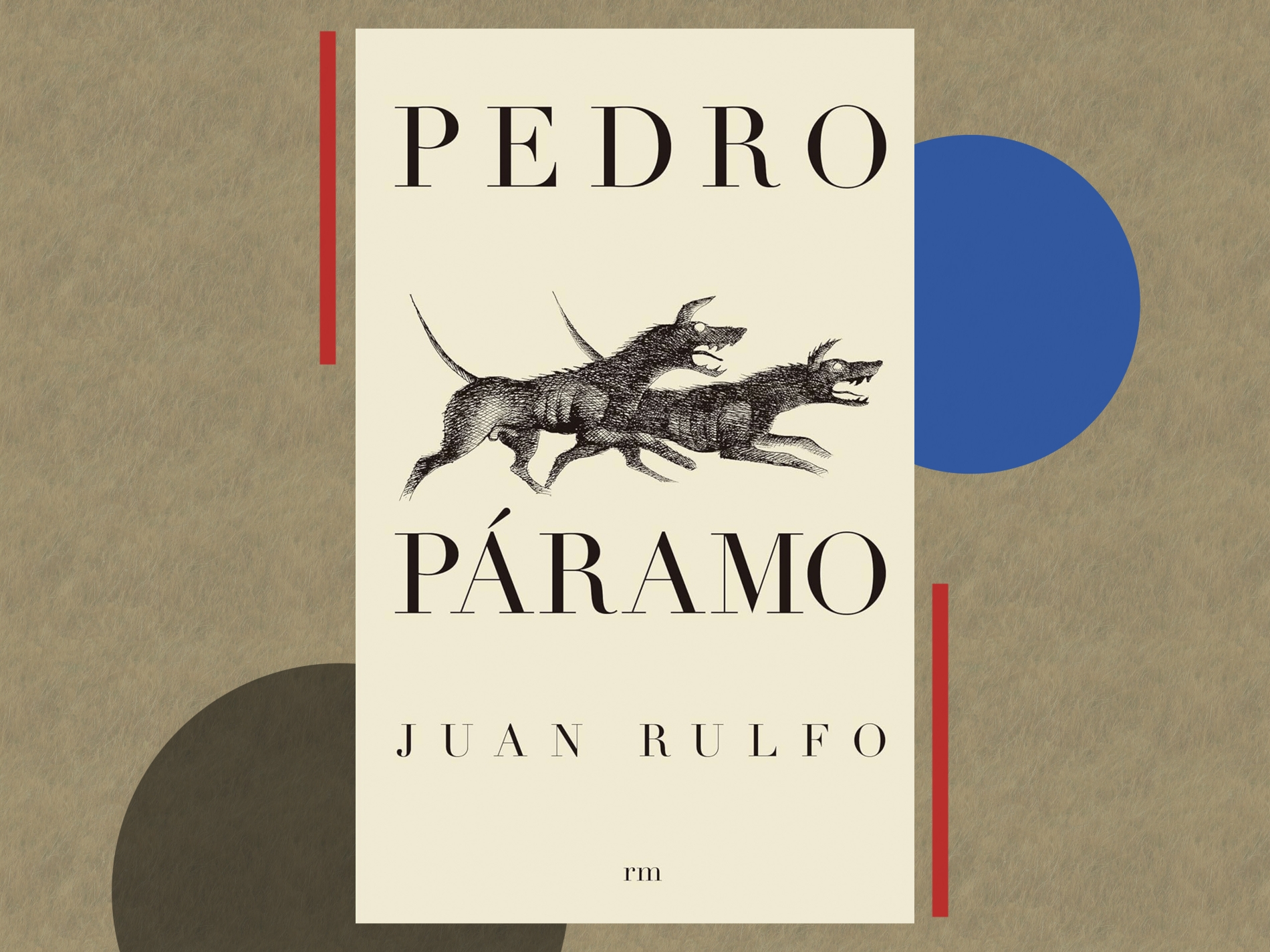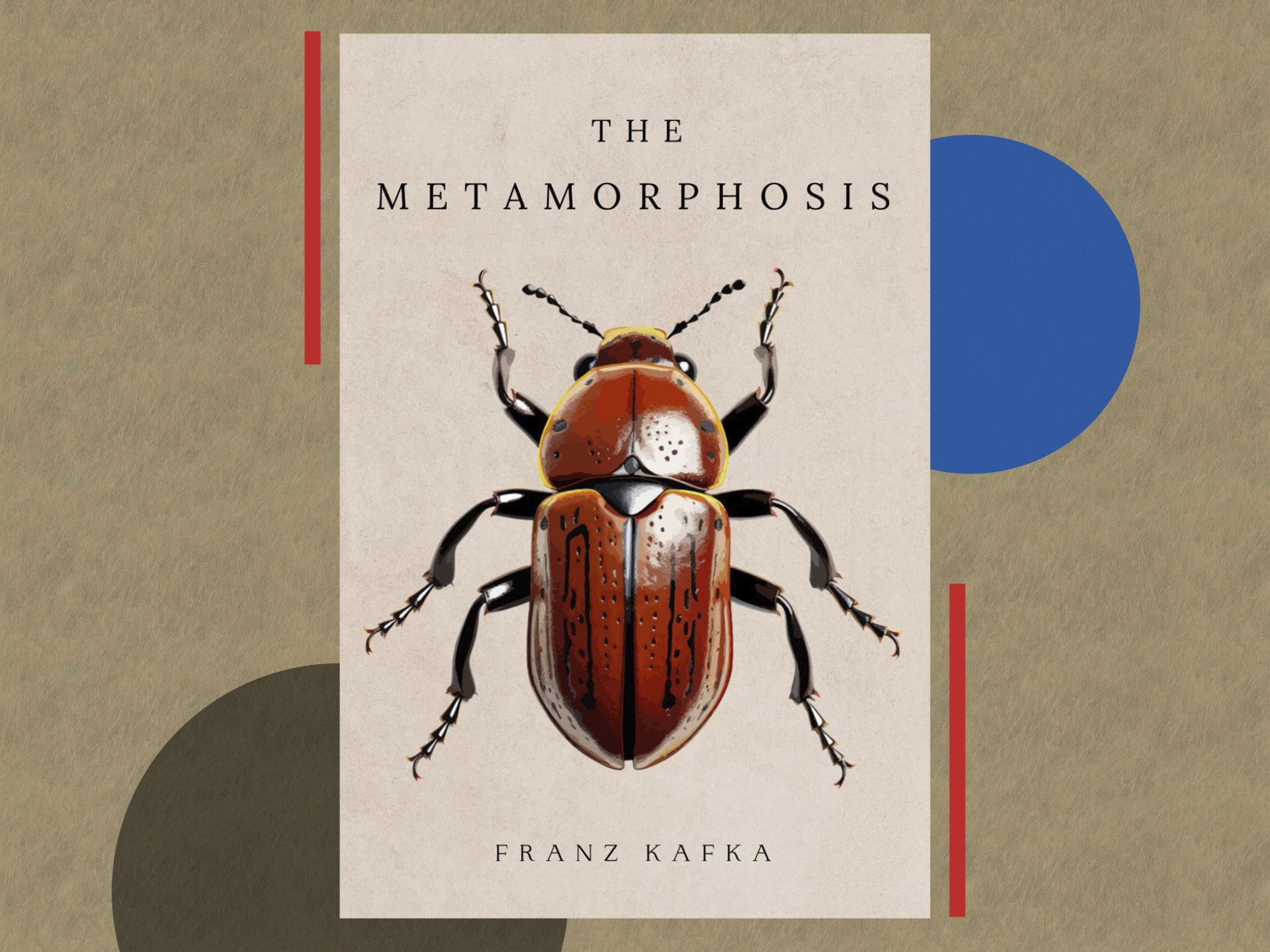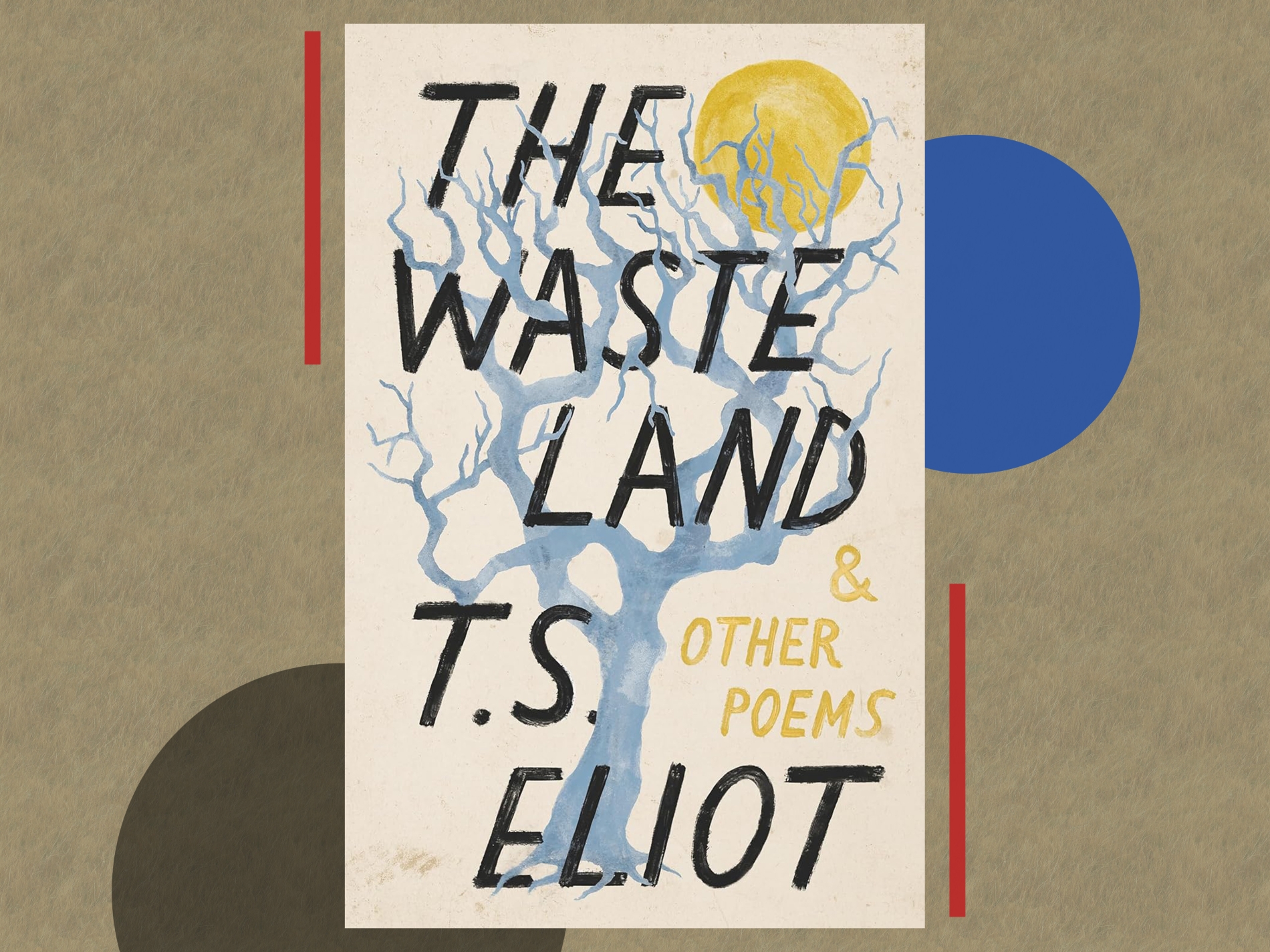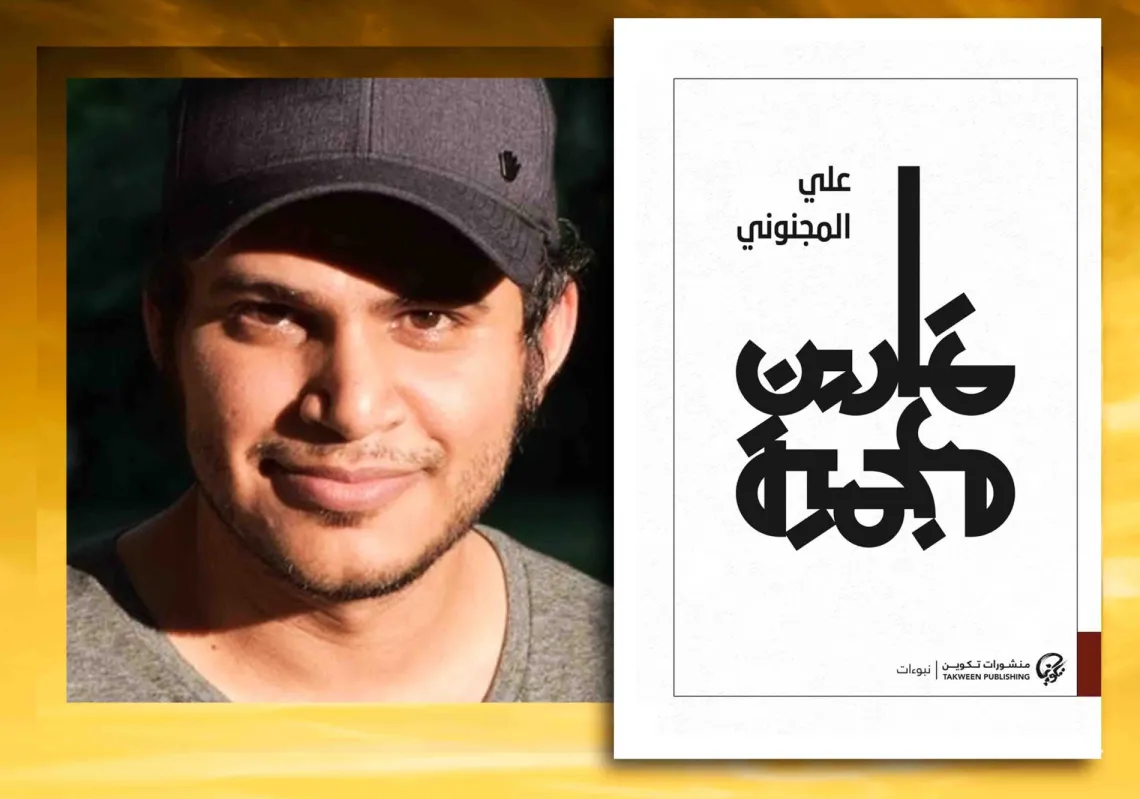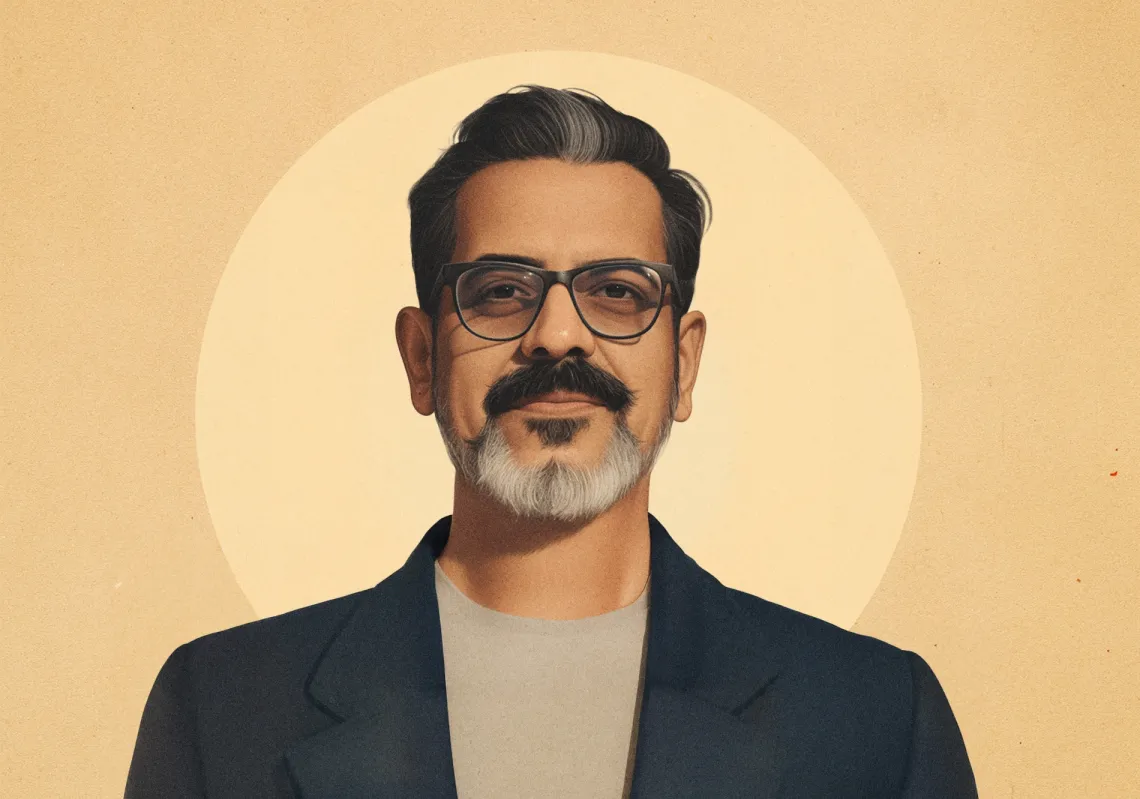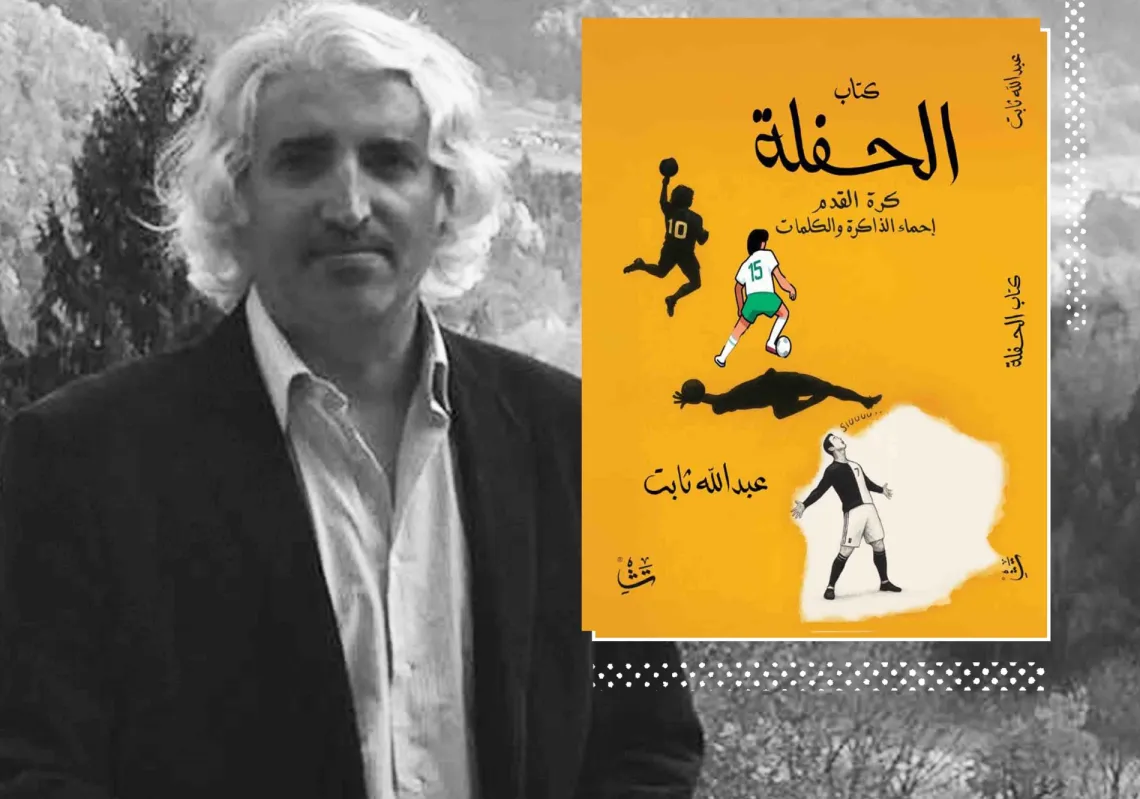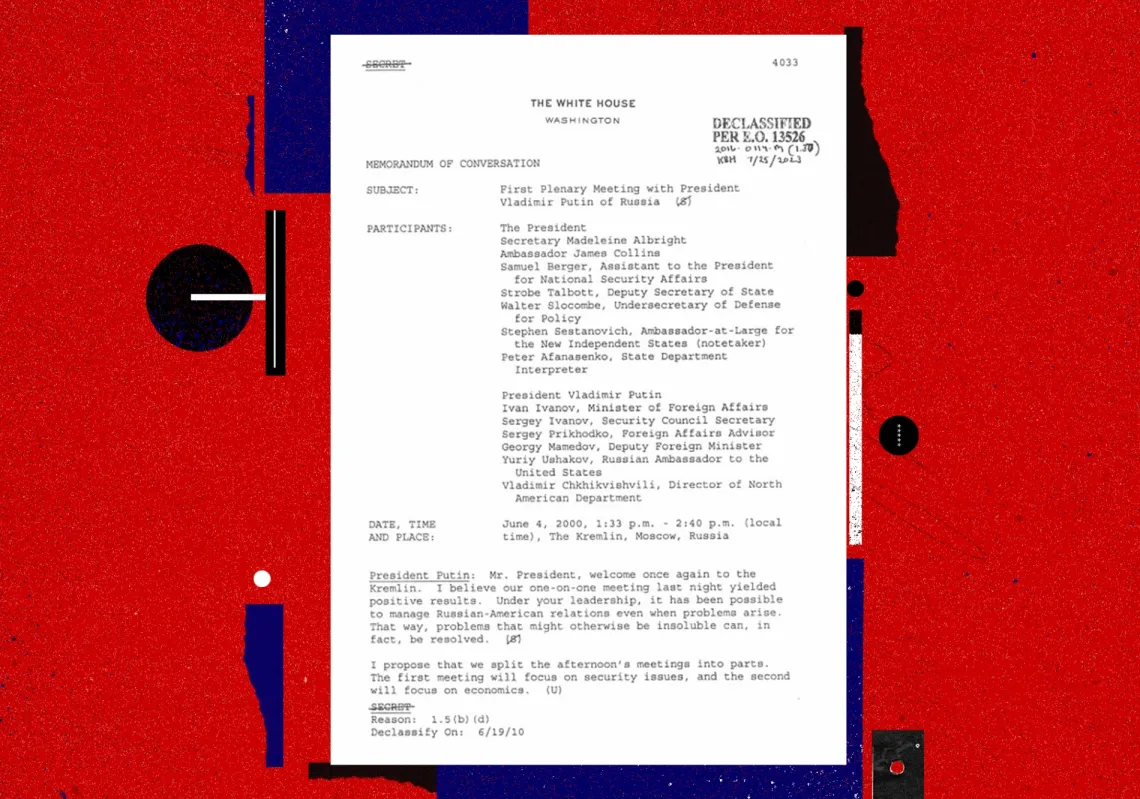يقدم الشاعر والكاتب السعودي إبراهيم زولي في كتابه الجديد "ما وراء الأغلفة: روائع القرن العشرين"، الصادر عن "المؤسسة العربية للدراسات والنشر" في بيروت (2025)، قراءات نقدية ذات طابع خاص في رؤيتها وبنائها، تنبع من إيمان عميق بأن الأدب يشكل التاريخ في أكثر صوره حيوية وتأملا، وأنه الذاكرة التي تكتب تحولات الإنسان والكون معا.
يصف زولي القرن العشرين بأنه مختبر للأفكار، زمن تفككت فيه الأيديولوجيات الكبرى وانهارت الإمبراطوريات، وخرج الإنسان من أطره القديمة إلى فضاء جديد تتقاطع فيه الفلسفة بالشعر، والنقد بالسياسة، والفرد بالجماعة. تلك الرؤية تمنح الكتاب بعدا تأويليا يتجاوز القراءة التقريرية إلى تحليل يرى في النصوص الكبرى تجسيدا لمأزق الإنسان الحديث، وسعيا لفهم ذاته في مواجهة التحول المتسارع للعالم.
يتعامل المؤلف مع "الأعمال المختارة" بوصفها كائنات فكرية تنبعث منها أنوار متبادلة، تتجاور داخل فضاء واحد تتقاطع فيه الأزمنة والتجارب. من "زينب" لمحمد حسين هيكل إلى "الأم" لمكسيم غوركي، ومن "زوربا" لنيكوس كازانتزاكيس إلى "بدرو بارامو" لخوان رولفو، ومن "عوليس" لجيمس جويس إلى "محبوبة" لتوني موريسون، تمتد القراءة كرحلة متواصلة داخل الوعي الإنساني. تلك النصوص، كما يسميها المؤلف، تشكل جغرافيا روحية للقرن العشرين، تجمع بين الفكر والخيال، وتعيد رسم خرائط الروح عبر تعدد الأصوات والرؤى.
من الغلاف إلى ما وراءه
يحمل عنوان الكتاب بعدا جماليا يتجاوز سطح العبارة نحو أفق رمزي أوسع، فـ"ما وراء الأغلفة" يشير إلى نزعة الكاتب في العبور من الملموس إلى الخفي، ومن المظهر إلى الجوهر الذي يختبئ داخل النصوص. ففي مقدمة الكتاب يصف زولي الغلاف بأنه السطح الذي يخفي ما يراد السكوت عنه، ومن هذا التوصيف تبدأ رحلته النقدية التي تماثل فعل التنقيب، إذ يتجه نحو الأعماق باحثا عن النبض الأول الذي منح العمل الأدبي طاقته الحية واستمراره في الذاكرة.
في قراءته لرواية "زوربا"، يرى زولي أن كازانتزاكيس كتب عن الروح في ذروة اشتعالها، وهي تخوض صراعا بين التمرد والانتماء، بين الرقص والانطفاء. فزوربا يرقص كي ينجو من فلسفة الخراب، ويخلص الجسد من ثقل الفكرة. هذا التصور الذي يجمع بين التجربة الإنسانية والفلسفية يمنح الكتاب حسا شاعريا يتداخل فيه النقد بالتأمل.