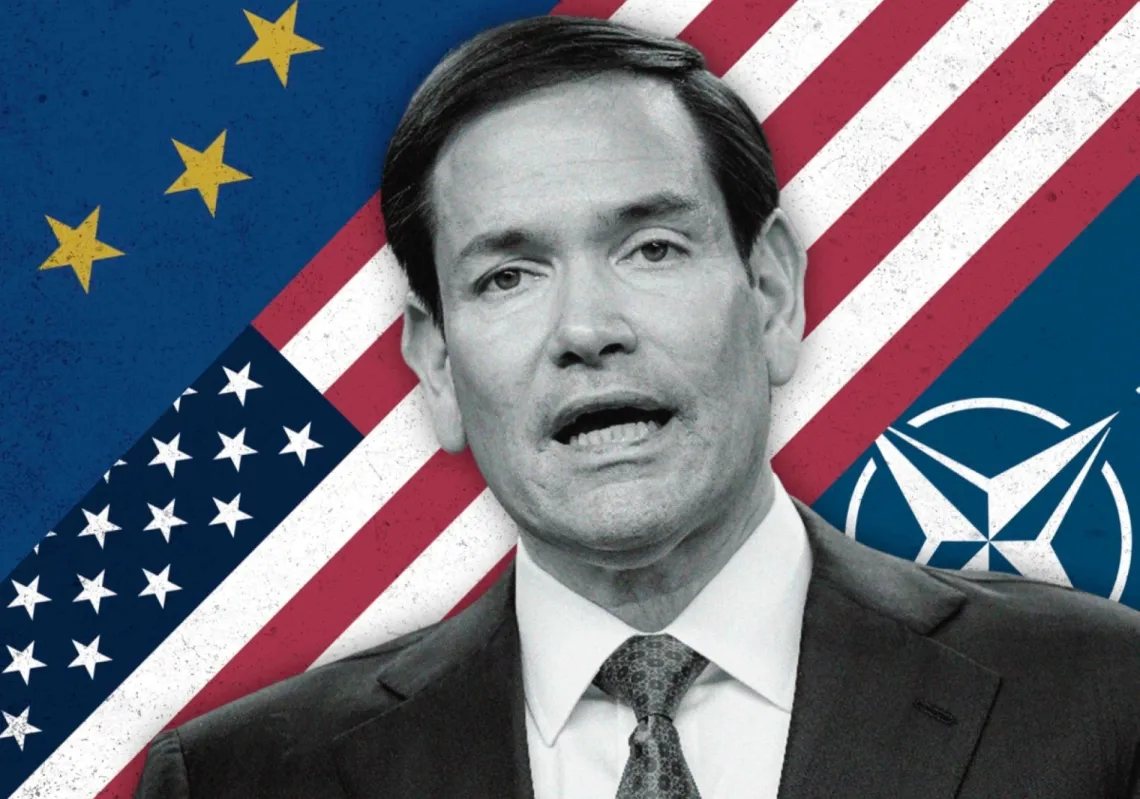مضى على انطلاقة الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة ستة عقود تقريبا، ومع ذلك فإن الطبقة السياسية التي تولت قيادة هذه الحركة وهندستها وتحكمت في مساراتها وخياراتها، ما زالت ذاتها تقريبا، بأشخاصها وأفكارها وطرق عملها، رغم كل التحولات والتنقلات التي شهدتها قضية فلسطين وحركتها الوطنية في صعودها وهبوطها، في وحدتها وتفككها، في قوتها وضعفها.
وإذا كان متوسط أعمار الأفراد المكونين لتلك الطبقة في الثلاثينات، في حينه (أواسط الستينات)، فهذا يعني أننا اليوم إزاء قيادات باتت في أواخر الثمانينات، ما يشير إلى شيخوخة الحركة الوطنية الفلسطينية، من جهتين، باستبعادها عدة أجيال من الفلسطينيين، وافتقادها القدرة على تجديد شبابها وحيويتها، وأيضا، من حقيقة أن تلك الحركة باتت متقادمة ومستهلكة، بكياناتها، ونمط علاقاتها، وخطاباتها، وأشكال عملها. طبعا، لتلك الطبقة القيادية القديمة ما لها وما عليها، فقد تحملت مسؤولية استنهاض الفلسطينيين بعد النكبة، وبناء كينونتهم السياسية، وبلورة هويتهم الوطنية الجمعية، لكنها أيضا مسؤولة، بالقدر ذاته، عن تعثر حركتهم الوطنية، وترهل أحوالها، وأفول مكانتها.
الحديث يدور هنا عن حركة وطنية غنية بخبراتها الكفاحية، ويعرف شعبها أنه يضم نسبة عالية من المتعلمين والأكاديميين والناشطين السياسيين، وهي حركة دفع شعبها أثمانا باهظة، في معاناته وتضحياته، إلا أن ذلك كله لم ينعكس في طبيعة بنائها لمؤسساتها وإطاراتها وعلاقاتها الداخلية، ولا في نمط إدارتها لمواردها، أو في طريقة صراعها مع عدوها، فهذه الحركة تأسست على القيادة الفردية، وعانت من الافتقاد لمراكز صنع القرارات وصوغ الخيارات الاستراتيجية، بحكم تغيب القيادة الجماعية والهيئات التشريعية ومراكز الدراسات.
وتعاني الكيانات السياسية، أي المنظمة والسلطة والفصائل والمنظمات الشعبية، من مشكلات التآكل والتقادم والأفول، يفاقم منها انحسار شعبيتها، وتصدع مكانتها التمثيلية، في الداخل والخارج، بحكم تراجع دورها في الصراع ضد إسرائيل، وعدم استطاعتها تحقيق إنجازات سياسية جديدة توازي التضحيات المبذولة، بعد التحول من حركة تحرر وطني إلى سلطة، تحت الاحتلال، ومع ضياع الإجماعات الوطنية نتيجة للخلافات السياسية، وغياب العلاقات الديمقراطية في مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية ونظامها السياسي.
تهميش منظمة التحرير الفلسطينية
وفيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية، فقد همشت القيادة الفلسطينية، أو هشمت، منظمة التحرير، أكثر من أي طرف آخر، وذلك في تركيزها على السلطة، وإدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة (1967)، التي لم تصبح دولة، بعد توقيعها اتفاق أوسلو (1993)، وهذا يشمل خطاباتها وأشكال عملها وأولوياتها السياسية، التي باتت تتركز على اعتراف إسرائيل بـ»استقلال الدولة الفلسطينية»، بحسب التعبيرات الرسمية التي اعتادت القيادة الفلسطينية تضمينها في خطاباتها، بعد أن اعترفت هي بإسرائيل، مما يعني بداهة استبعاد الفلسطينيين اللاجئين من المعادلات السياسية الفلسطينية، وحصر تمثيل القيادة الفلسطينية بفلسطينيي الضفة والقطاع، من الناحية العملية. وباختصار، فإن منظمة التحرير اليوم باتت بمثابة هيكل لا يتم تشغيله، أو استخدامه، إلا في المناسبات، أو لأغراض تغطية الفراغ السياسي أو لتعزيز الشرعية، رغم وجود لجنة تنفيذية، ومجلس مركزي، ومديري دوائر، ومديري مكاتب، وموازنات، ورواتب.

الاستعصاء في كيان السلطة
أما كيان السلطة (وهو بمرتبة حكم ذاتي- أقل من الدولة)، فهو يعاني من استعصاء ناجم عن عدم قدرة الفلسطينيين على تحويله إلى دولة مستقلة ومترابطة وذات سيادة، بسبب ممانعة إسرائيل وتكريسها واقع الاحتلال والاستيطان، وبحكم غياب الضغط الخارجي (الدولي والعربي) عليها. لكن هذا الاستعصاء ناجم، أيضا، عن ضعف البني الوطنية الفلسطينية، والخلافات السائدة، سيما مع انقسام كيان السلطة إلى كيانين، متنافسين، ومتصارعين، واحد بقيادة حركة “فتح” في الضفة، والثاني بقيادة حركة “حماس” في غزة، يضاف إلى ذلك افتقاد السلطة لآليات الانتقال الديمقراطي، وضمن ذلك طريقة الرئيس الفلسطيني المزاجية والفردية في العمل، إذ قام بحل المجلس التشريعي المنتخب (أواخر 2018)، ثم حل مجلس القضاء الأعلى (صيف 2019)، وبعدها ألغى عملية الانتخابات الرئاسية والتشريعية (في أبريل/نيسان 2021) التي كانت مقررة بعد شهر (مايو/أيار 2021)، والتي كانت موضع آمال كثر لتجاوز مشكلتي الانقسام وفقدان الشرعية والفراغ القيادي.
هكذا عرف الفلسطينيون حوالي 18 تشكيلة حكومية (منذ إنشاء السلطة في 1994)، بواقع حكومة كل عام ونصف العام، ما يفيد بأنه بات للفلسطينيين، في تلك الفترة القصيرة، أكبر عدد من الوزراء بالقياس لأي دولة أخرى في العالم، مع 23 وزيرا على الأقل في كل حكومة. ولا يقتصر الأمر على ذلك، فثمة أيضا جيش من وكلاء وزراء ومديري عمــوم للوزارات وقـــادة أجهزة أمنية وسفراء ومستشارين، وكل ذلك يتطلب بداهة موازنات ورواتب باهظة ومصاريف مهمات تشكل عبئا ضاغطا على كاهل الفلسطينيين، الذين يعانون أصلا قلة الموارد الذاتية، ويرتهنون في مداخيلهم إلى المساعدات الخارجية.