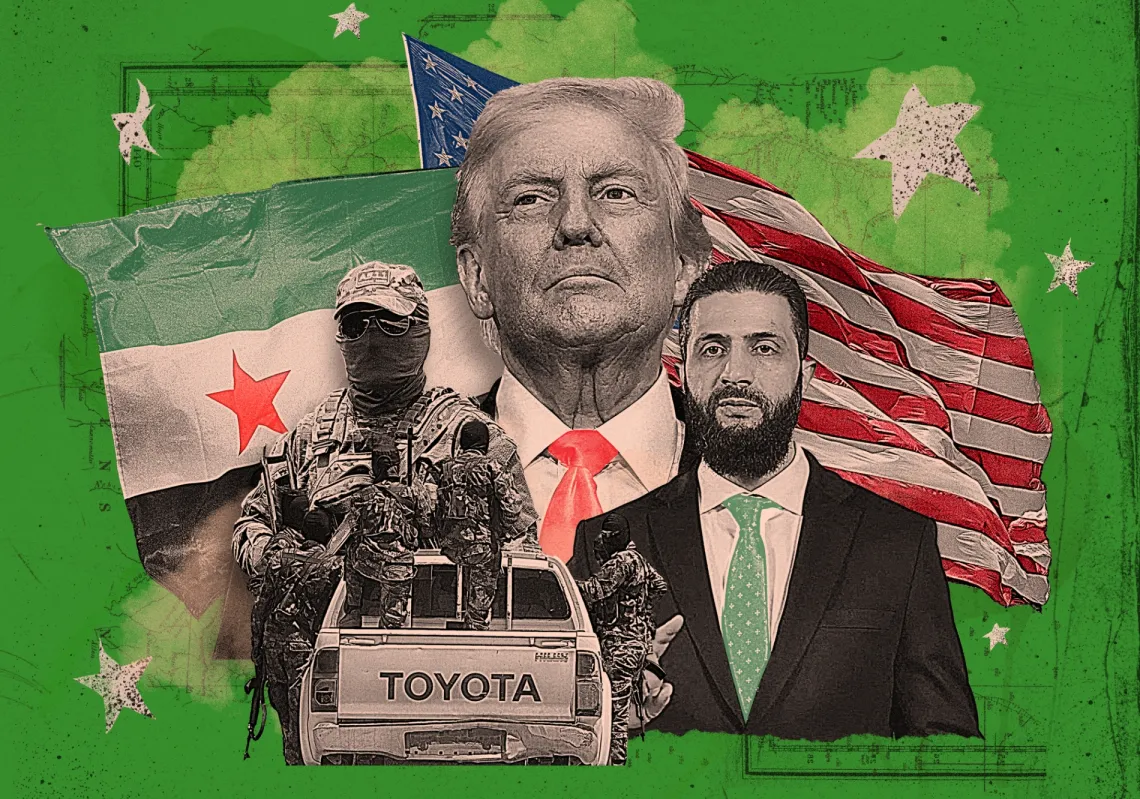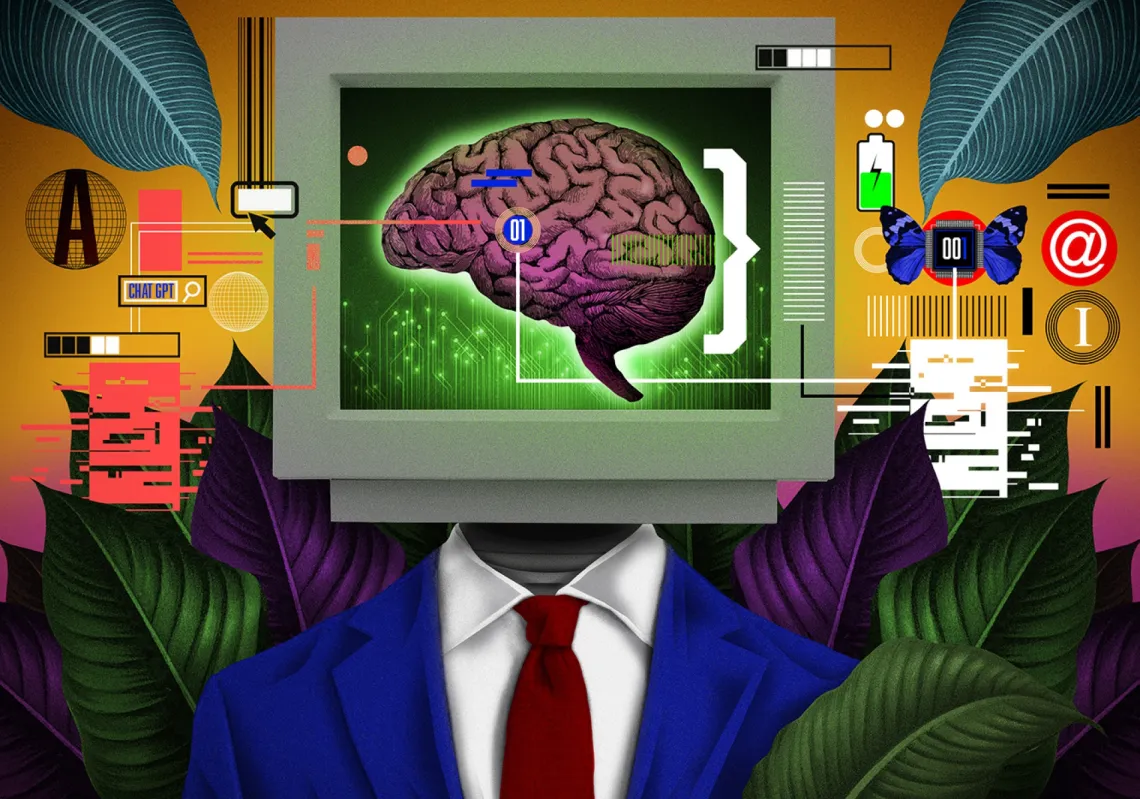"التسامح نقيض الضيافة: فعندما أكون "متسامحا"، أقيد استقبالي للآخر، أحتفظ بالسلطة وأسيطر على مساحتي الخاصة" - جاك دريدا
"لنستعد رمز الباب: لكي تكون هناك ضيافة، لا بد من وجود باب. لكن إذا وجد باب، فلا ضيافة بعد ذلك، ولا وجود لبيت ضيافة بحق. لا يوجد بيت بلا باب أو نافذة، لكن بمجرد وجود باب ونوافذ، فهذا يعني أن أحدا ما يملك المفتاح، وبالتالي عليه أن يتحكم في شروط الضيافة. لا بد من وجود عتبة، لكن إذا وجدت عتبة، فلا ضيافة بعد ذلك. هذا هو الفرق، هذه هي الفجوة بين ضيافة الدعوة وضيافة الزيارة. في الزيارة، لا يوجد باب. أي كان، يمكن أن يأتي في أي لحظة ويمر دون حاجة إلى مفتاح الباب. لا مراقبة جمارك في الزيارة، أما في الدعوة، فهناك جمارك، كما أن هناك شرطة رقابة"- جاك دريدا
تولد مفهوم التسامح خلال حركة الإصلاح الديني الأوروبية، ليعبر عن تغير في الذهنية نتج من علاقة الاعتراف المتبادل بين القوى التي استمرت تتصارع طوال القرن السادس عشر داخل الدين الواحد. وقد انتقل إلى الفكر العربي المعاصر فحاول دعاة الإصلاح أن يوظفوه. بعضهم ذهب إلى الإشادة به واعتباره مفتاح التحديث الفكري والسياسي (فرح أنطون)، وبعضهم الآخر ذهب إلى القيام ضده واعتباره مدعاة إلى زرع الشتات و"النيل من وحدة الأمة" (جمال الدين الأفغاني).
رواسب
ظل هذا المفهوم حاملا رواسب الإشكالية الدينية التي نشأ في حضنها، والتي جعلت منه، قبل كل شيء، نداء "للمحبة والرحمة والإحسان للناس بعامة". فرغم التوسع الذي عرفته دلالاته، ورغم محاولات سعيه كي يرتقي إلى مستوى المفهوم الفلسفي، إلا أنه ظل متسما بهذا الطابع الديني، مرتبطا بمفاهيم المحبة والإحسان، الأمر الذي حال دون فعاليته حتى عند من يعتبرون أنفسهم ناحتيه ومولديه. ويكفي، دليلا على ذلك، أن ننتبه إلى ما يعرفه الغرب المعاصر، سواء في علاقته بمستعمراته السابقة، أو بالأقليات المتعايشة معه من مظاهر اللاتسامح، كي لا نقول التعصب والعنصرية، حيث يشكل عدم الاعتراف بالآخر، وبالخصوصيات الثقافية صفات ملازمة لكثير من المواقف، حتى تلك التي تدعي اليسارية.