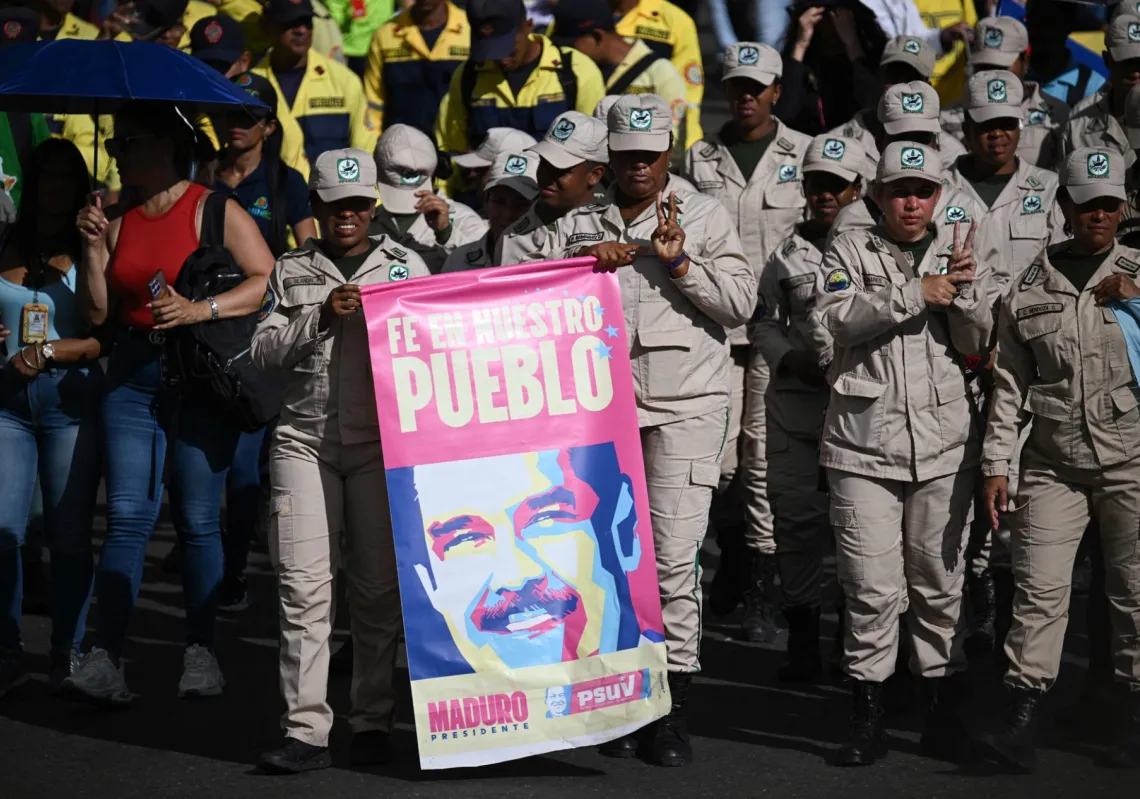عندما يدور الحديث حول الإسلام الحركي المعاصر، فإن التركيز يتمحور غالبا حول جماعة "الإخوان المسلمين" التي شكّلت نقطة التحول في تحويل الدين إلى حركة أيديولوجية شملت التحول من التعايش السلمي إلى المواجهة، خصوصا في المرحلة التي عُرِفَتْ بـ"الصحوة" بداية ثمانينات القرن الميلادي العشرين والتي نادت بـ"إسلامية الحكم".
ينبغي التوضيح هنا أن المشكلة لا تكمن في صراع بين العلمانية والإسلاميين كمبدأ. فالنهج العلماني في إدارة الدولة، وإتاحة هامش للتعددية الحزبية، وتداول السلطة التنفيذية عبر التنافس الانتخابي بين الكتل والأحزاب والجماعات السياسية المرخصة كان قد بدأ في مصر منذ العهد الملكي، تحديدا منذ عام 1922، العام الذي شهد الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة. واستمر العمل بهذا الدستور حتى ألغاه الملك فؤاد عام 1930 واستبدل به دستور 1930 الذي عملت به مصر مدة خمسة أعوام، لكن الضغوطات الشعبية المتزايدة أجبرت الملك فؤاد على وقف العمل بدستور 1930، وإعادة اعتماد دستور 1923 الذي استمر العمل به حتى عام 1953. ولكن الوضع قد تبدّل مع مجيء الجمهوريات ذات الطابع العسكري الثوري من جهة، وتبني جماعة "الإخوان المسلمين" لمبدأ الحاكمية نهجا لإدارة الدولة من جهة أخرى، ممّا أزّم العلاقة بين الدولة والجماعة.
نقف في السطور التالية على الجذور التاريخية لهذه العلاقة، خصوصا التحولات السياسية في ظل الأنظمة الجمهورية العربية العلمانية التي تعتبر مبدأ "الحاكمية"، مبدأ رجعيا يتناقض مع جوهر الفكر التقدمي الذي ادعت تلك الأنظمة تبنيه. وعليه فقد حاربت تلك الأنظمة الجمهورية العربية العلمانية منظمات وشبكات وتيارات وأحزاب الإسلام الحركي، وعملت على تحجيم دور الدين في الحياة العامة، وحصره في المساجد، واتخاذ الدين الإسلامي مصدرا لسنِّ واشتراع قوانين الأحوال الشخصية وليس لرسم سياسات الدولة.