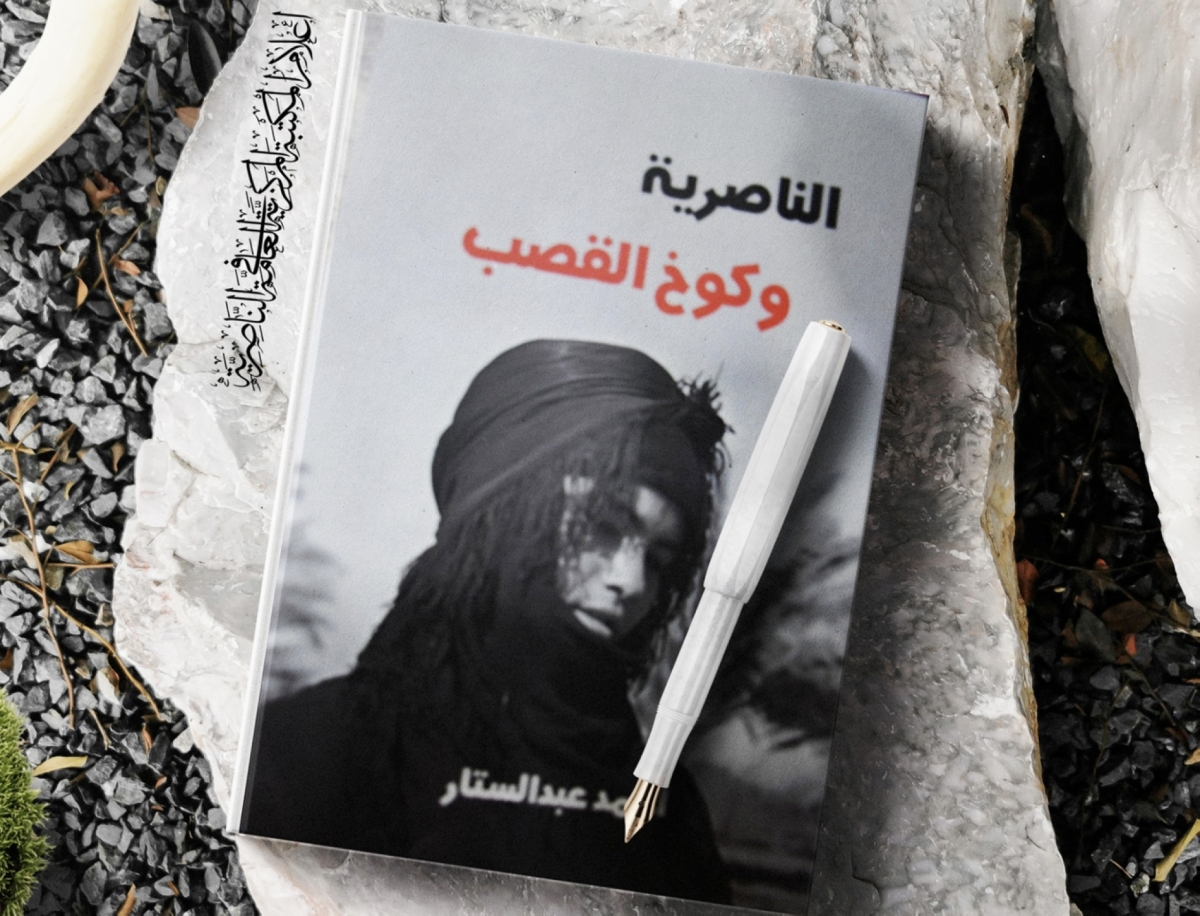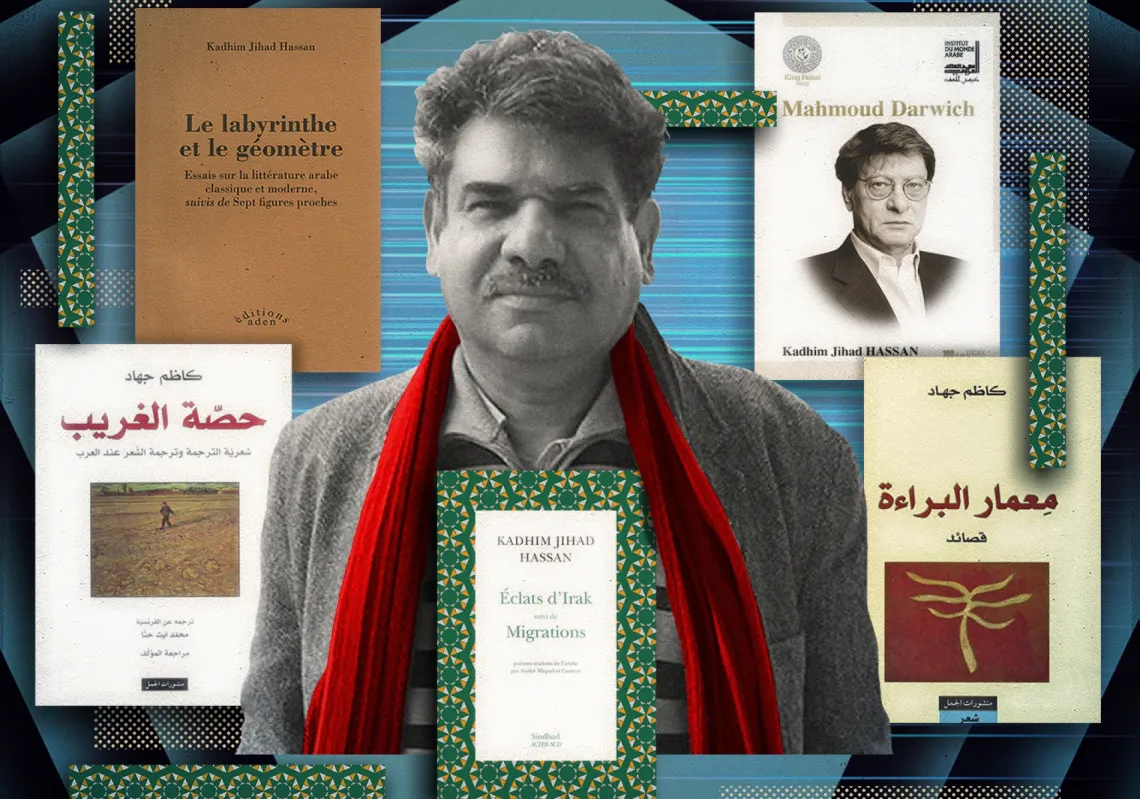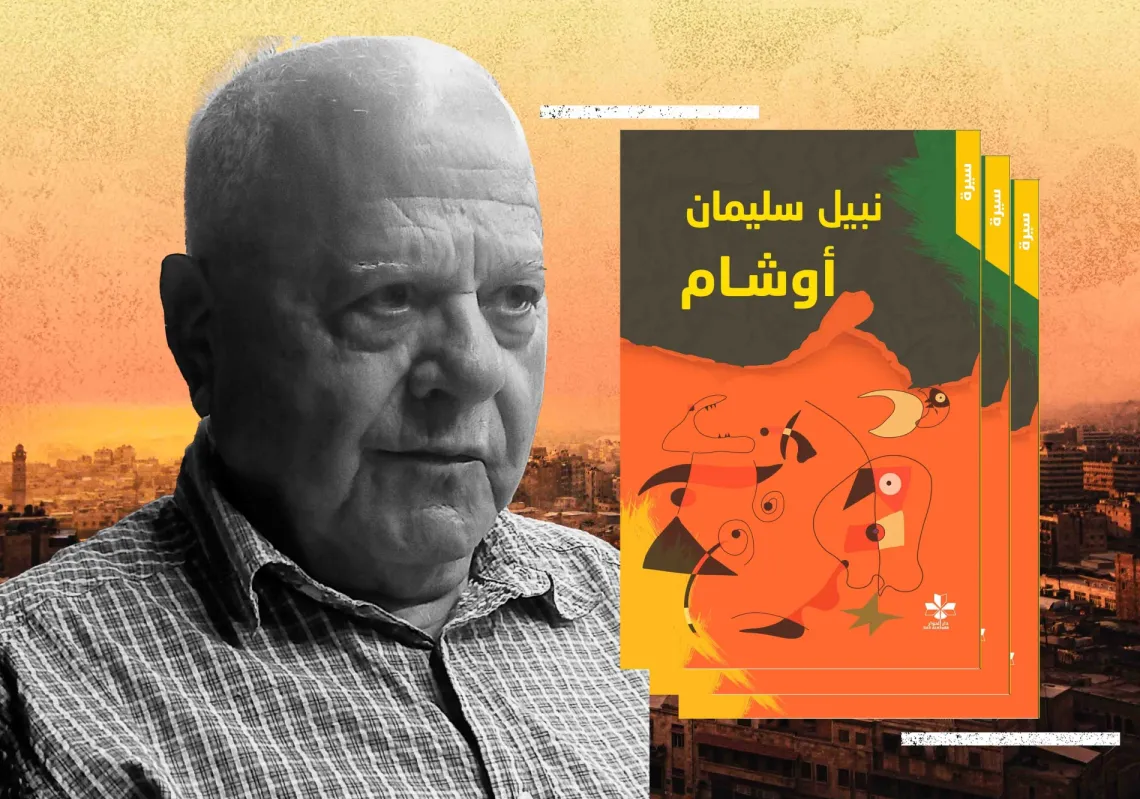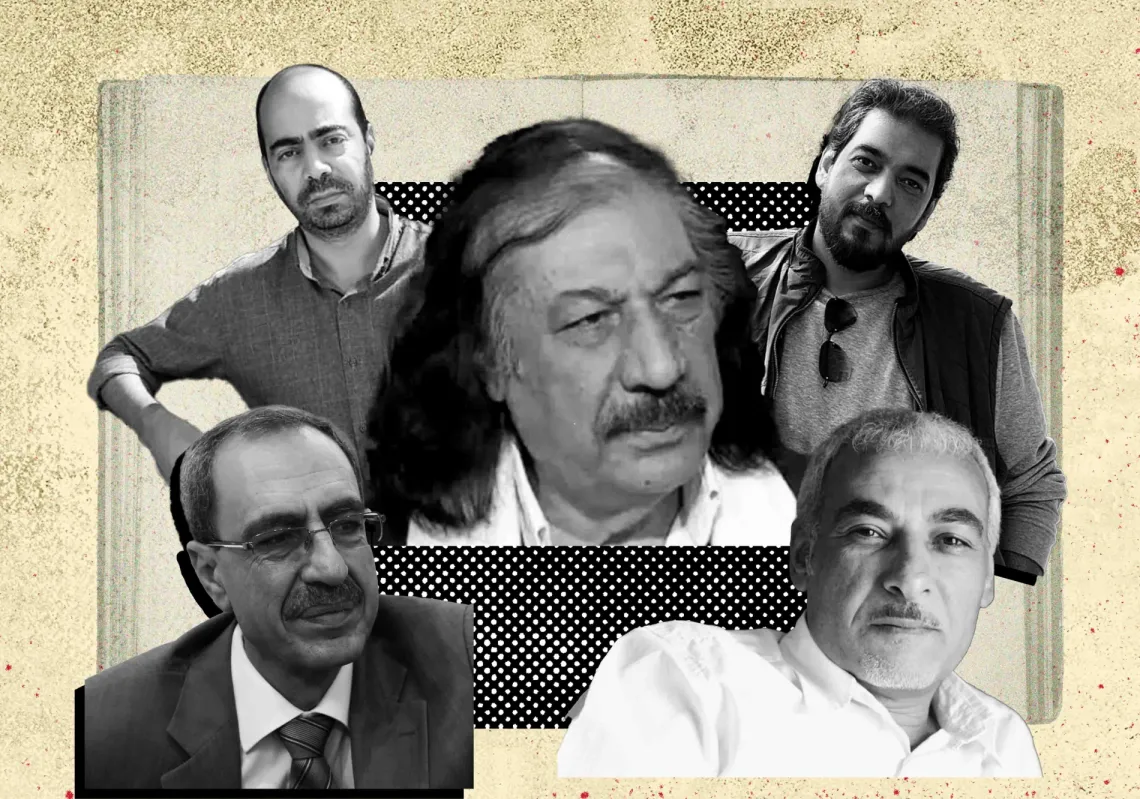ليس من السهل أن تكتب عن جرح لم يلتئم، لأنك ستكتشف عند كل محاولة أن السكين لا يزال مغروسا في اللحم. أحمد عبد الستار، في كتابه "الناصرية وكوخ القصب" الصادر عن دار "المسار" 2025، يفتح هذا الجرح: العلاقة المعقدة، بل المتوترة، بين أبناء المدينة وأبناء الريف – دون تأنق لغوي أو حياد أكاديمي. منذ البداية، يعلن انحيازه للسؤال، لا للإجابة، ويبدأ بطفولته: كان شاهدا على نظرات الاحتقار، على الكلمات الثقيلة التي يرمي بها "المتمدنون" أبناء الريف، حتى إنه – كما يعترف – تبنى تلك النظرة فترة من حياته، قبل أن تتفكك أمام مشاهدات أوسع وأكثر تعقيدا.
لا يسعى الباحث إلى الدفاع عن أحد ضد أحد، بل يفكك النماذج الجاهزة. يرى أن التباين بين الريف والمدينة ليس في الأخلاق، بل في شكل الحياة. أبناء الريف لا يحملون عيبا خلقيا أو خلقيا، بل يأتون من منظومة اجتماعية مختلفة، أقل تعقيدا، وأكثر التصاقا بالأرض. الفارق بين الاثنين لا يستدعي الإدانة، بل الفهم. الريفي لا يفسد المدينة، هو فقط لا يتقن لغتها، بينما تتعالى المدينة عليه بدلا من أن تنصت لصوته.
تحول العلاقة بين الشيخ والفلاح
يبدأ المؤلف في تشريح بنية مدينة الناصرية، لا بوصفها كيانا عمرانيا، بل صيرورة اجتماعية. كيف ولدت؟ من أين أتت علاقاتها الطبقية؟ من هم ملاك الأرض الأوائل؟ وكيف تبدل الشيوخ من رموز حماية إلى أدوات استغلال؟ في سرده هذا، لا ينحاز إلى الحنين، بل إلى ما يسميه "المنهج المادي التاريخي"، الذي يربط شكل العلاقات الاجتماعية بالبنية الاقتصادية، وليس بالشعارات.
التحول الحاسم في سرديته، يظهر بعد قرار الدولة العثمانية تمليك الأراضي لشيوخ العشائر، مما أفضى إلى تحول العلاقة بين الشيخ والفلاح إلى علاقة مالك ومستأجر، متخمة بالضرائب والاستغلال والمهانة. من هنا تبدأ الهجرة، كقدر أكثر مما كخيار. الريفي الذي ينزل المدينة، لا يفعل ذلك حبا بها، إنما هربا من عسف الريف، لكنه يصطدم هناك بنظام لا يعترف بجراحه. هذا السياق يقودنا إلى لحظة العزلة الكبرى: الفلاح في المدينة، وحيد، يطارد خبزا لا يعرف كيف يصنعه، وتطوقه نظرات لا تعرف كيف تسامح. الجريمة إذن – كما يقول المؤلف – ليست في الفلاح بل في النظام الذي دفعه إلى الهجرة، ثم عامله كدخيل.