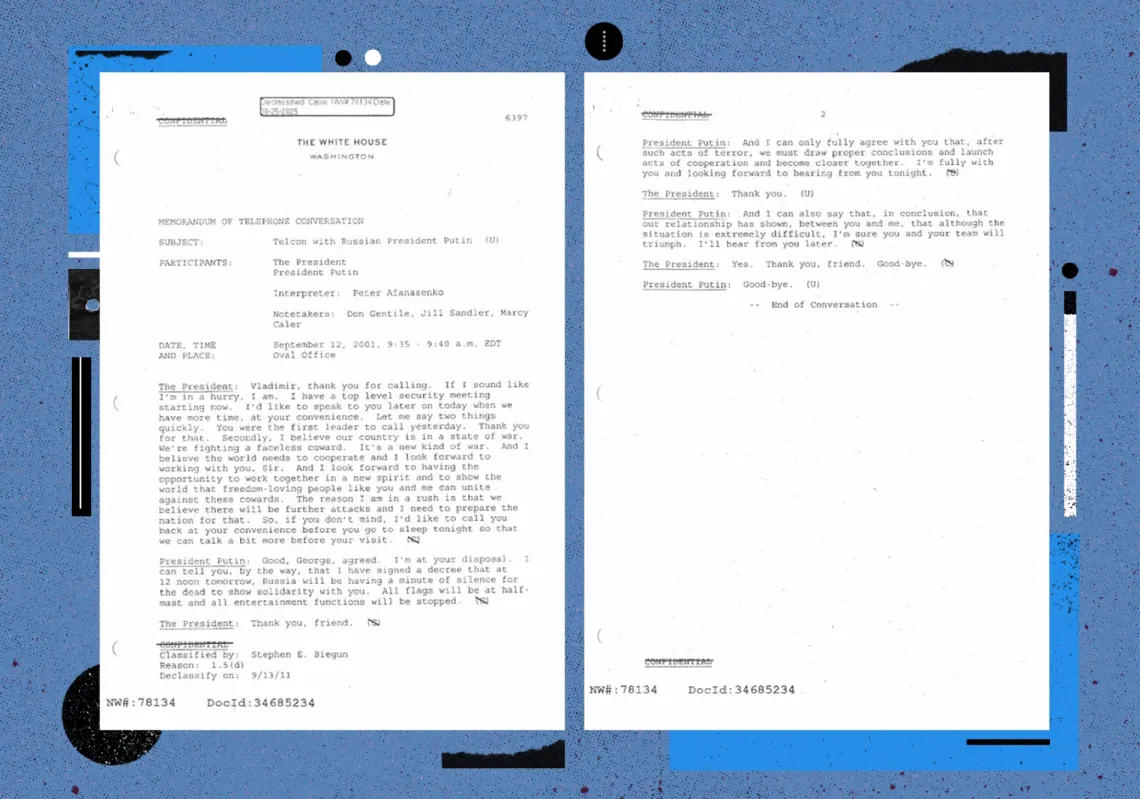في قلب غابة فالورسين عند سفوح مون بلان وجبال الألب في فرنسا، انعقد حدث غير مسبوق: عرضت أعمال فنانين فلسطينيين من قطاع غزة، لكن من دون حضور أصحابها. حمل المعرض عنوان "الطبيعة كملجأ"، وكان جزءا من "بينالي غزة"، وهو حدث فني جماعي دولي ينطلق من قلب الإبادة، يواصل الفنانون الفلسطينيون من خلاله ممارساتهم تحت القصف ليجعلوا من الفن وثيقة حياة ومقاومة، وصوتا يتجاوز حدود المعارض التقليدية ليحمل رسائل إنسانية عاجلة إلى العالم.
المعرض هو مشروع تنظيمي مركز في محيط طبيعي قائم على الغابة، وموزع ضمن عدد من نقاط الرصد المختلفة داخل المشهد الطبيعي المفتوح. يستحضر وبقوة أصوات ستة فنانين فلسطينيين نازحين من غزة وغائبين جسديا. تترجم مساهماتهم إلى أعمال مكانية مركبة أو محفورة في المشهد الطبيعي. وهو لا يمثل عودة رومانسية إلى الطبيعة، بل تعبيرا عن الصمود في ظل انهيار جميع البنى التحتية. حيث تصبح الطبيعة أرشيفا وشاهدا.
لحظة كاشفة
في هذا المشروع الفني القائم على الغابة، أصبحت فالورسين موقعا يجسد مأساة غزة المستمرة، فيتأمل كيف دفع فلسطينيو غزة، المستهدفون بالموت والمهددون بالمجاعة والمهجرون من أرضهم، والمنفيون عن أدواتهم، إلى علاقة حميمة جذرية لا إرادية مع الطبيعة، ليس كبادرة رومانسية، بل كنوع من البقاء. يقوم هذا العمل الفني على فكرة العودة إلى الطبيعة، يعاد من خلاله إحياء المعرفة التي اضطر سكان غزة إلى استعادتها في مواجهة الإبادة الجماعية: كيف يحرقون أغصان الأشجار كوقود، وينظفون حوائجهم بالرمل، ويستخدمون مياه البحر للغسل، ويستبدلون الآلات الصامتة بأيديهم العارية. في ظل انهيار البنية التحتية، أصبحت الطبيعة الملاذ الأخير والغابة الشاهد على هذه الحقيقة.
يجمع هذا المشروع أعمال ستة فنانين من غزة، معظمهم لا يزالون تحت الحصار ولا يستطيعون الانوجاد فعليا. وهنا في هذا السياق، يمكن القول إن الغياب ليس مخفيا، بل مدرج، مسمى ومكرم. إذ تصل مساهماتهم كتعليمات، وتسجيلات، ورسومات تخطيطية، وصور، وملاحظات صوتية، أي رسائل عابرة للحدود، يعيد القيّم الفني تجميعها وتمثيلها وعرضها.