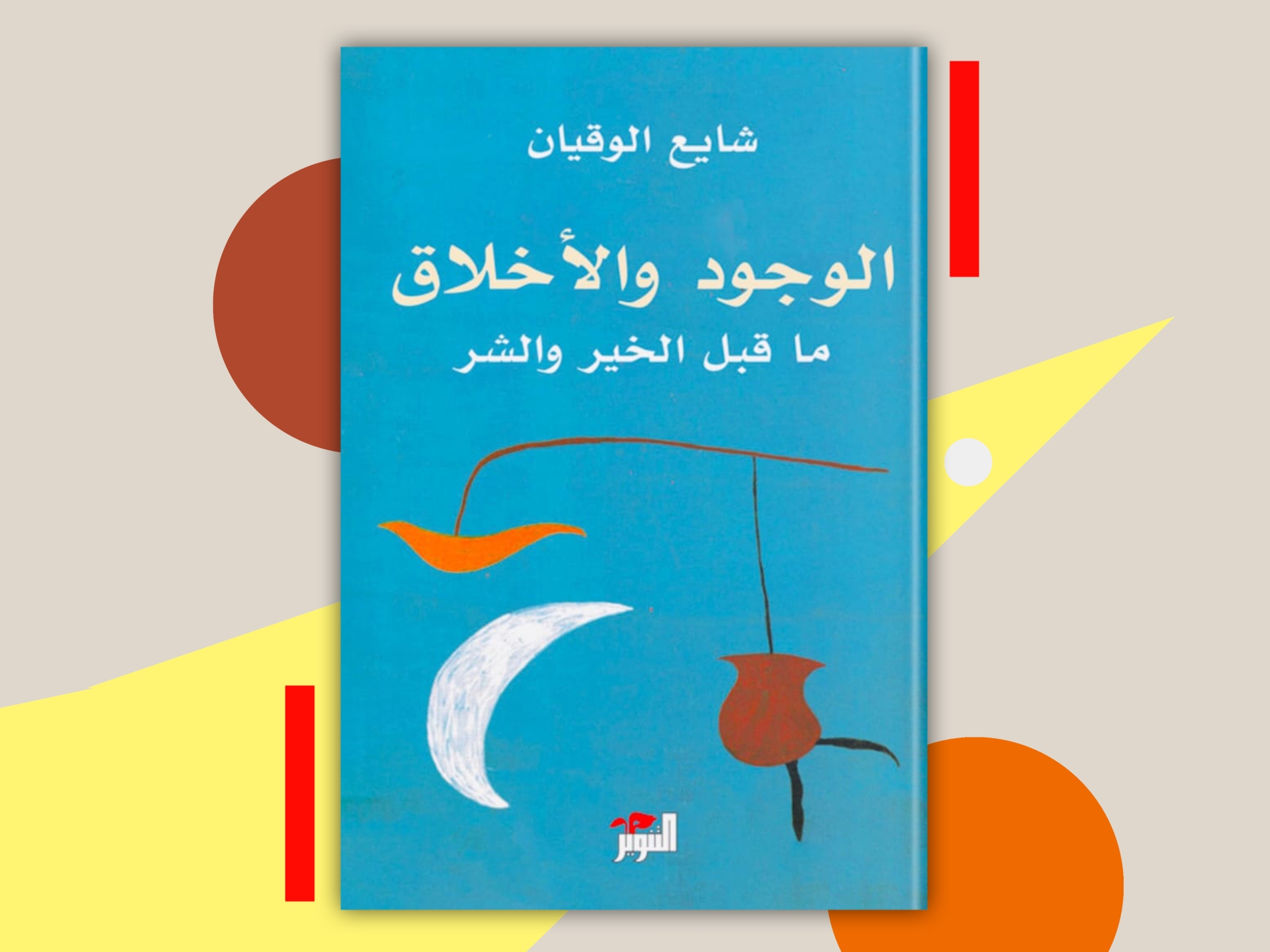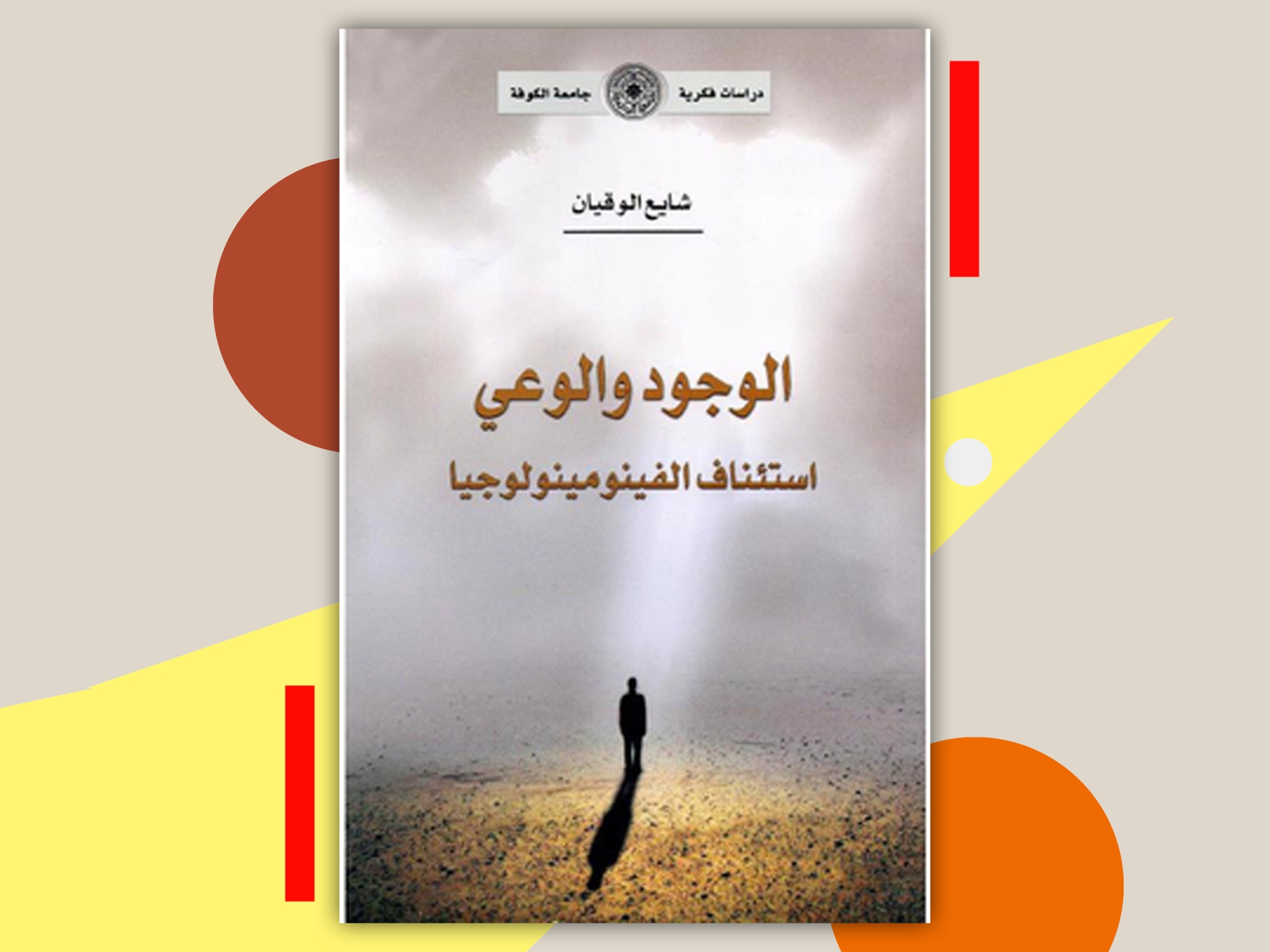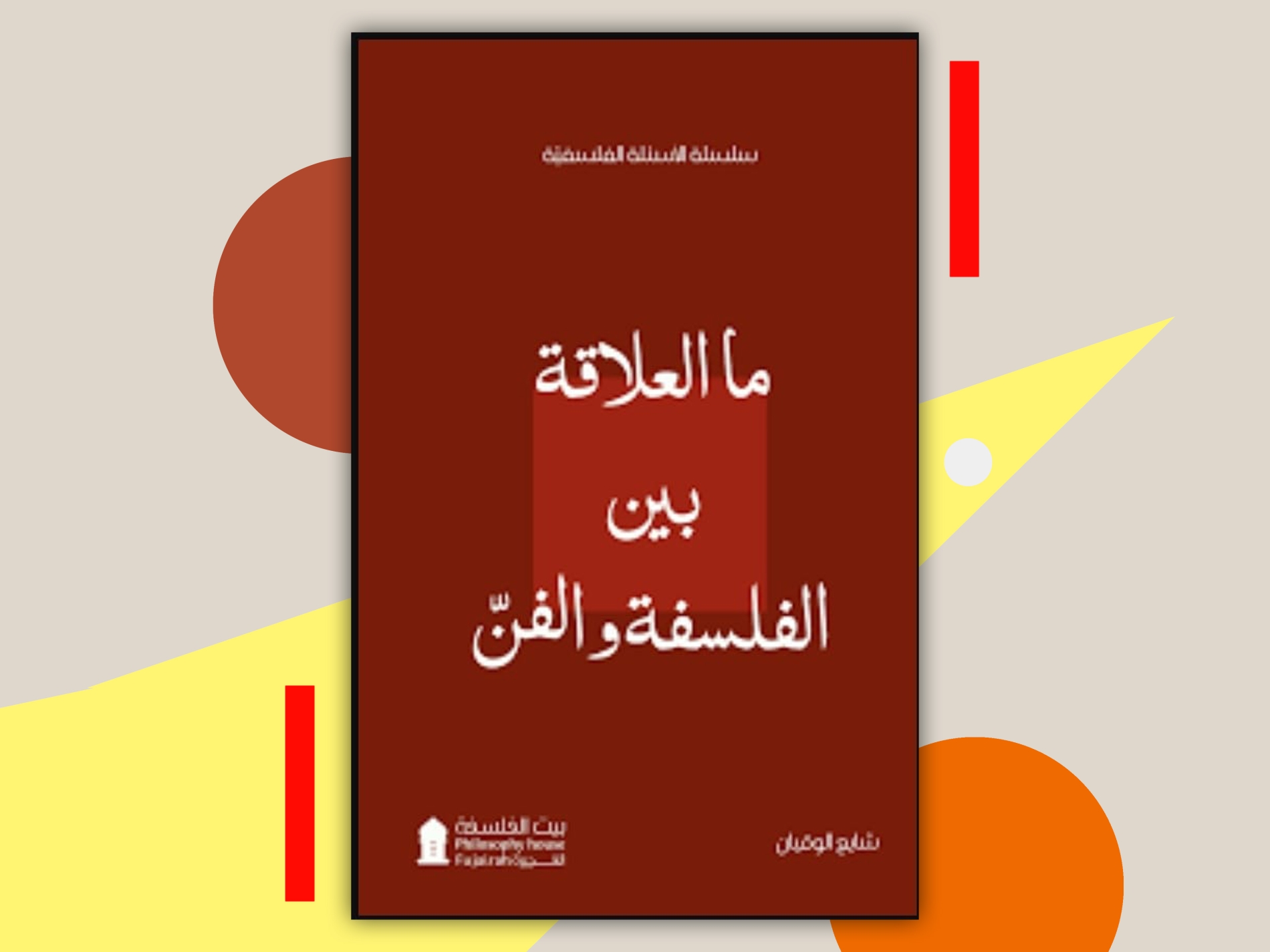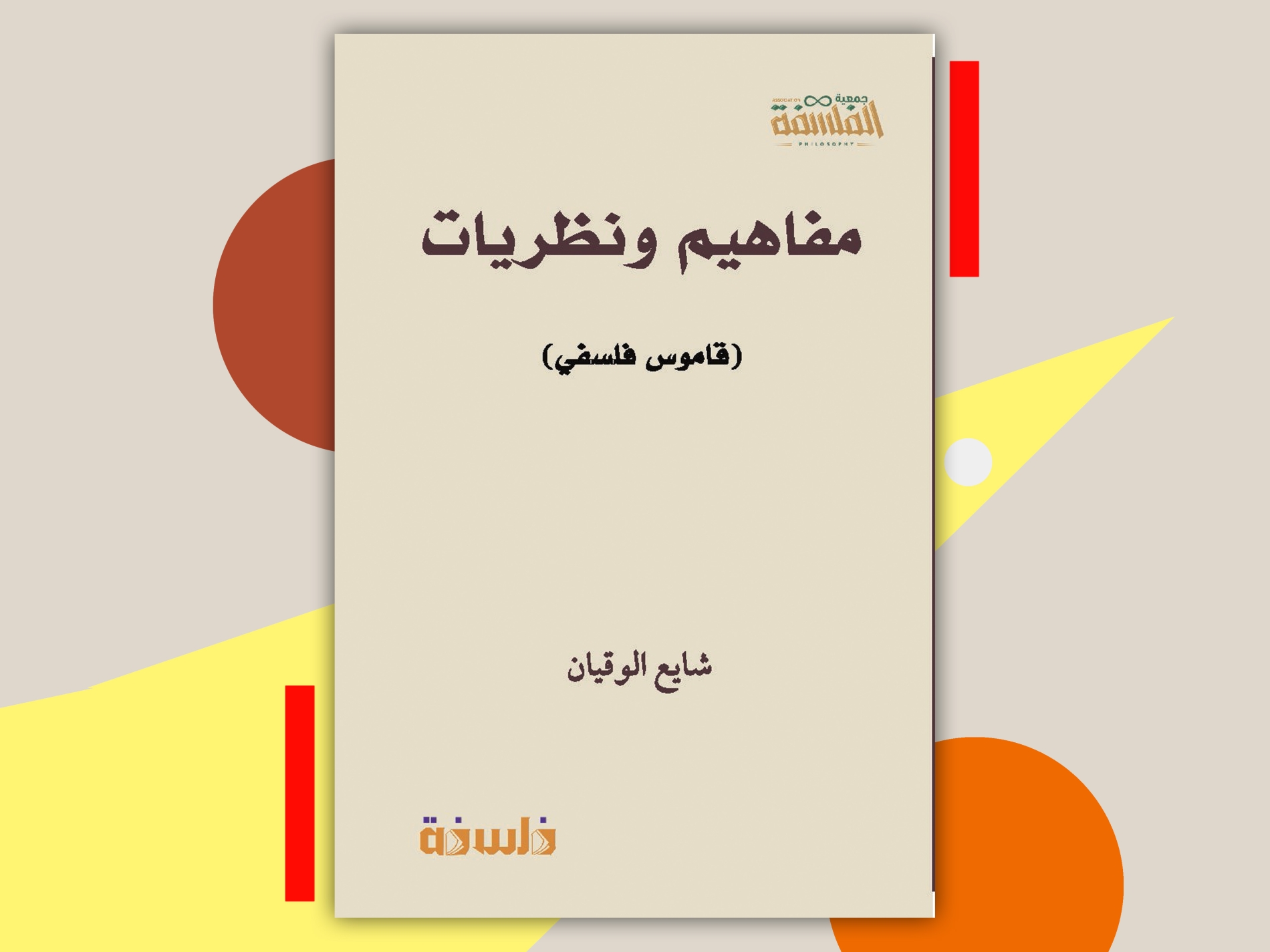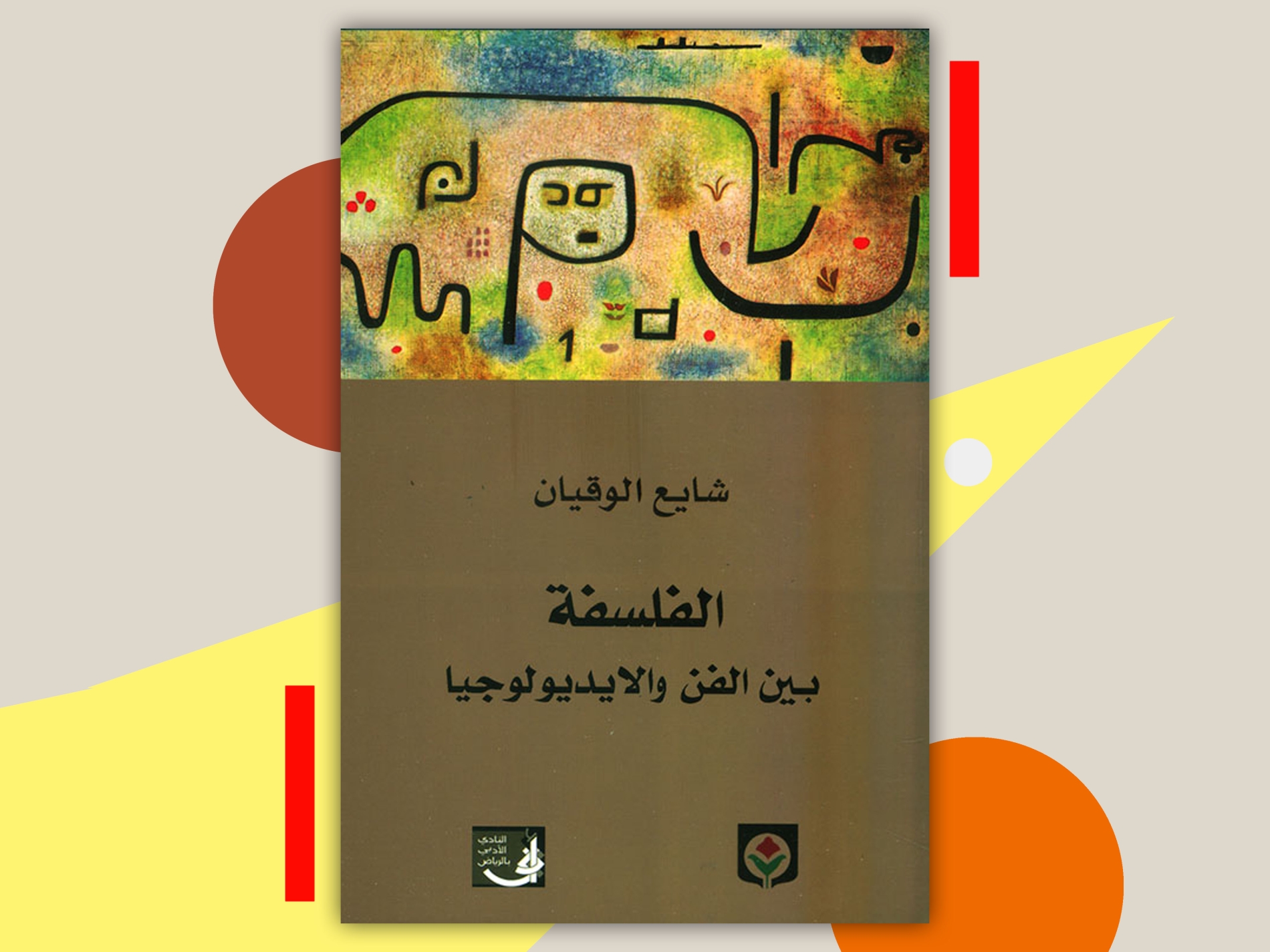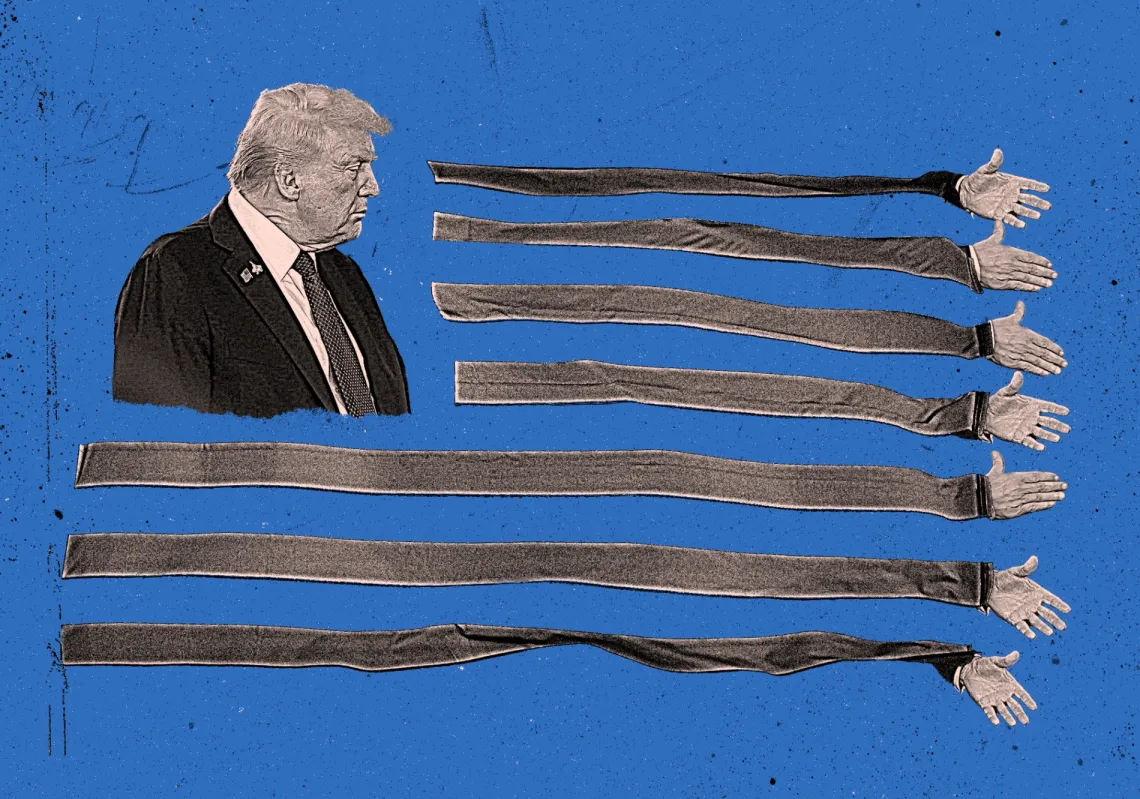يعدّ الكاتب السعودي شايع الوقيان واحدا من أبرز المشتغلين في حقل الفلسفة في العالم العربي، يقدم برنامج "الفيلسوف" على قناة "الثقافية" السعودية، وهو أحد مؤسسي "حلقة الرياض الفلسفية" و"الجمعية السعودية للفلسفة"، ومن كتبه "الفلسفة بين الفن والأيديولوجيا"، "مفاهيم ونظريات" و"الوجود والأخلاق ما قبل الخير والشر". هنا حوار "المجلة" معه.
لماذا صفة الفيلسوف، لا تزال تثير الجدال والنقاش في العالم العربي، أخذا في الحسبان دور العرب التاريخي في هذا الحقل، بداية من ترجمة الفلسفة اليونانية؟
هناك اعتقاد قديم بأن الفلسفة علم عصي على معظم الناس، وبأنه خاص بالنخبة أو حتى بنخبة النخبة. وهذا الاعتقاد أعطى الفلسفة مكانة مقدسة، ومن الغرائب أن خصومها يعطونها مكانة منحطة، فكأنها إما علم مقدس أو علم مدنس. والحقيقة أنها كغيرها من أنماط المعرفة الإنسانية، ولا يميزها إلا درجة التجريد التي تنتهي إليها، واللغة الصارمة التي تعبر بها عن قضاياها.
ما يثير الجدال عربيا في ما يتعلق بالفلسفة له شقان: شق يتعلق بأن الفلسفة علم بعيد المنال كما أسلفنا، ومن ثم فليس لنا القدرة على التفلسف إلا في نطاق ضيق، وشق يتعلق بماهية الموضوعات التي تتناولها الفلسفة، وهي موضوعات تمس جذور الفكر والاعتقاد، وبالتالي تحوم حول مواطن الخطر. لذا فلا ريب أن يشك الكثيرون في الفيلسوف أو المتعاطي مع الفلسفة من ناحية إيمانه. فالفيلسوف يبدأ بالشك المنهجي في كل ما يتلقاه، وهذا الشك يفتح الباب للإنكار في بعض الحالات.
بخصوص الموقف الأول، وهو الإفراط في تقدير مفهوم الفيلسوف، فهو أيضا لا يقل عن الموقف الثاني (الارتياب في الفيلسوف) من ناحية صدوره عن تصور خاطئ. ولو سألنا الناس: هل هناك فيلسوف عربي معاصر؟ فسيردون بصوت واحد: لا. ربما أن هذا الجواب نابع من شعور مضمر باحتقار الذات إزاء تمجيد الآخر. بل إن هناك من المشتغلين في الفلسفة من يرى هذا الرأي، وينفي القدرة على التفلسف عن الإنسان العربي. وهذا الازدراء ينعكس سلبا للأسف على النشاط الفلسفي العربي، حيث يكف الفلاسفة عن التفلسف ويضطرون فقط إلى شرح وتفسير وتحليل النظريات الفلسفية الآتية من الخارج.
التفلسف عربيا
كيف تقيم إذن واقع التفلسف في العالم العربي، وما المقومات في رأيك التي يمكن العمل عليها للنهوض به؟
من ناحية فردية، هناك فلاسفة جديرون بالاعتبار، وهناك أنشطة مستمرة. لكن الواقع الفلسفي يعاني من أزمات عدة. فهناك تقصير في الدعم المادي والمعنوي للنشاط الفلسفي. فالجامعات مثلا ليست على صلة عميقة بهذا النشاط، ولا يكفي أن تعقد الجامعة المؤتمرات والدورات، بل يجب أن يصبح النشاط الفلسفي جزءا من منهجها التعليمي، بحيث لا ينحصر المنهج على الفلسفات القديمة وفلسفات الغرب المعاصرة، بل يجب أن يمتد ليشمل الفلاسفة العرب. فالاحتفاء بإنتاجهم سوف يساهم بشكل كبير في الارتقاء بالتفلسف.