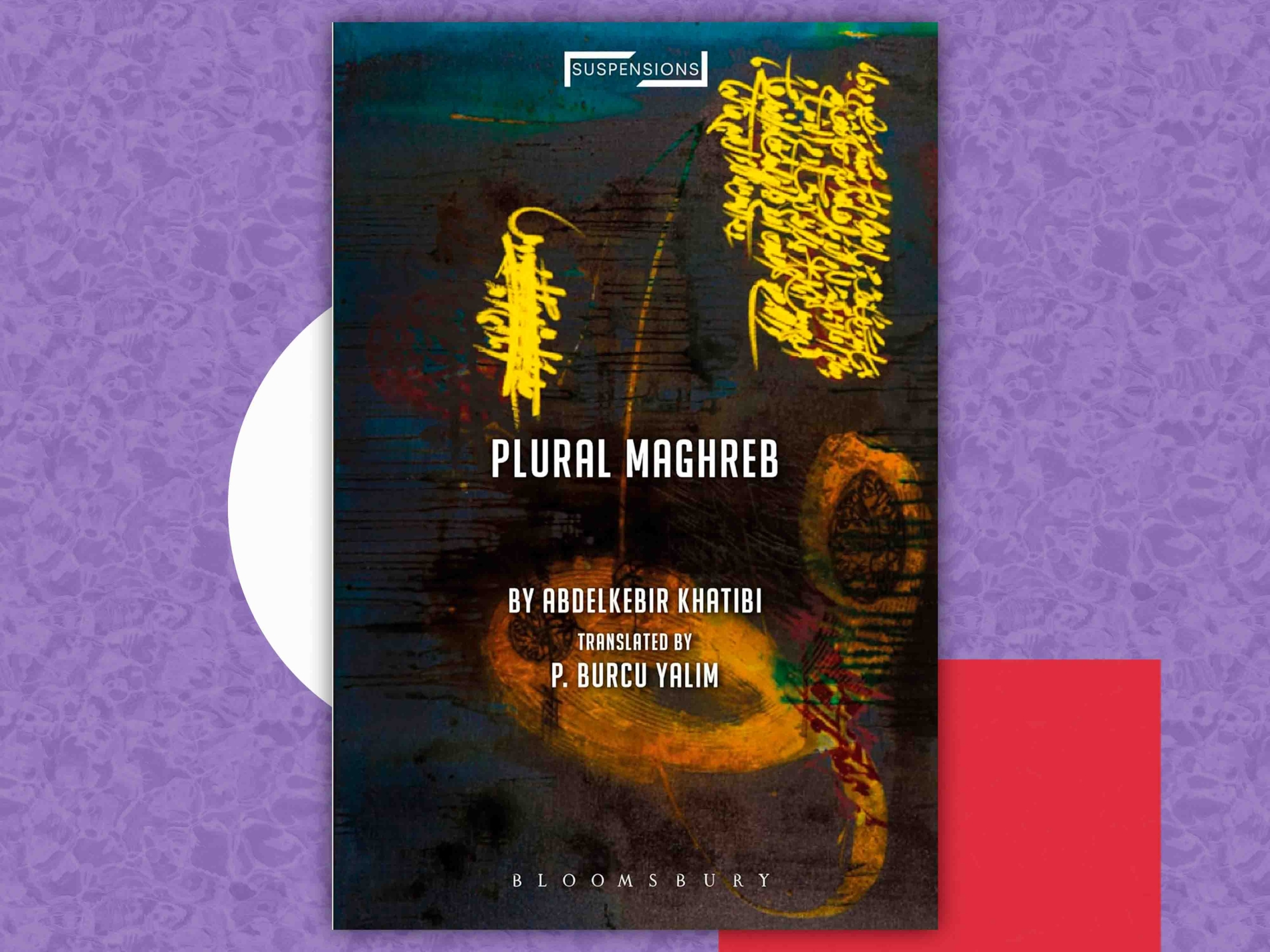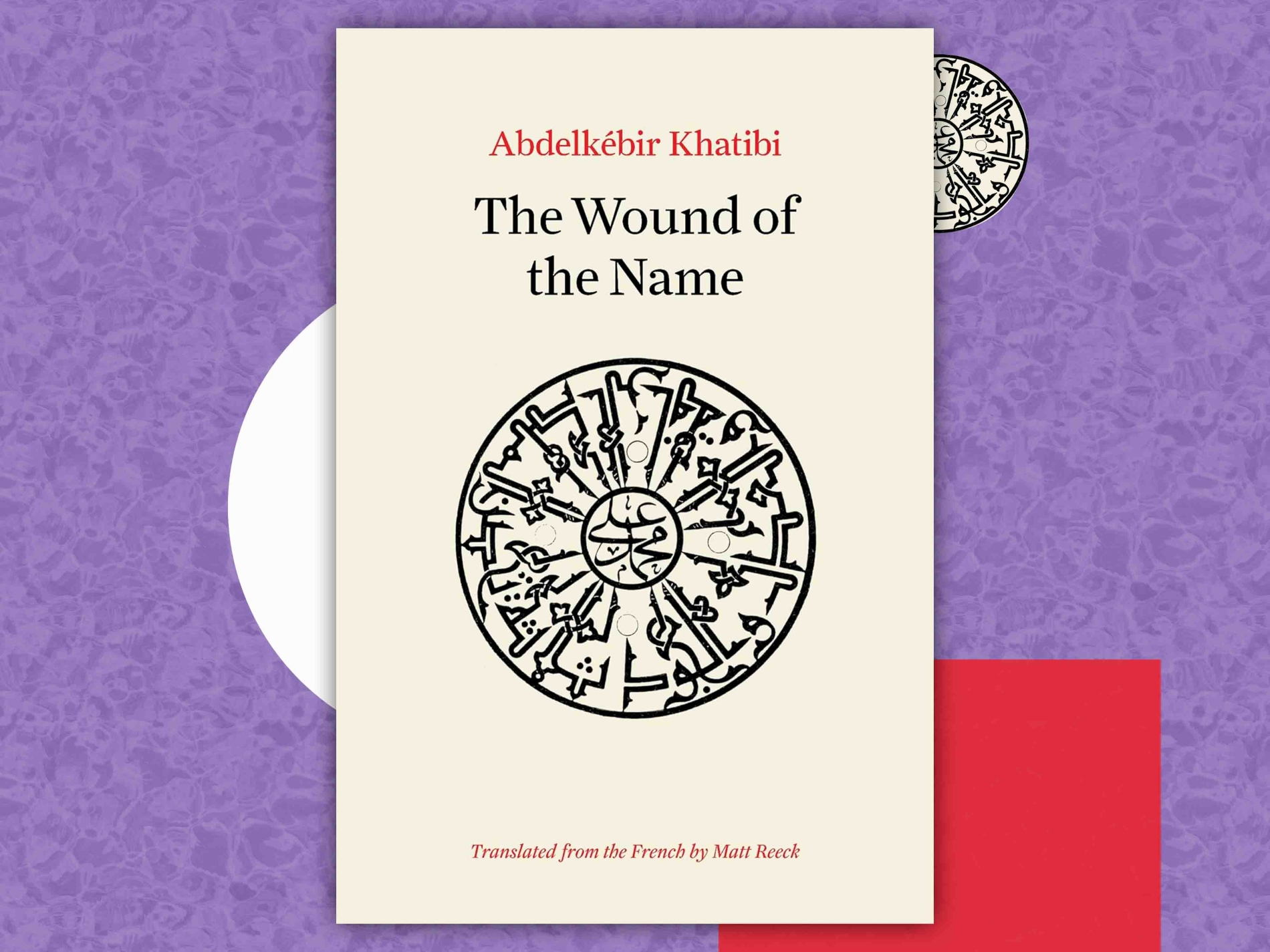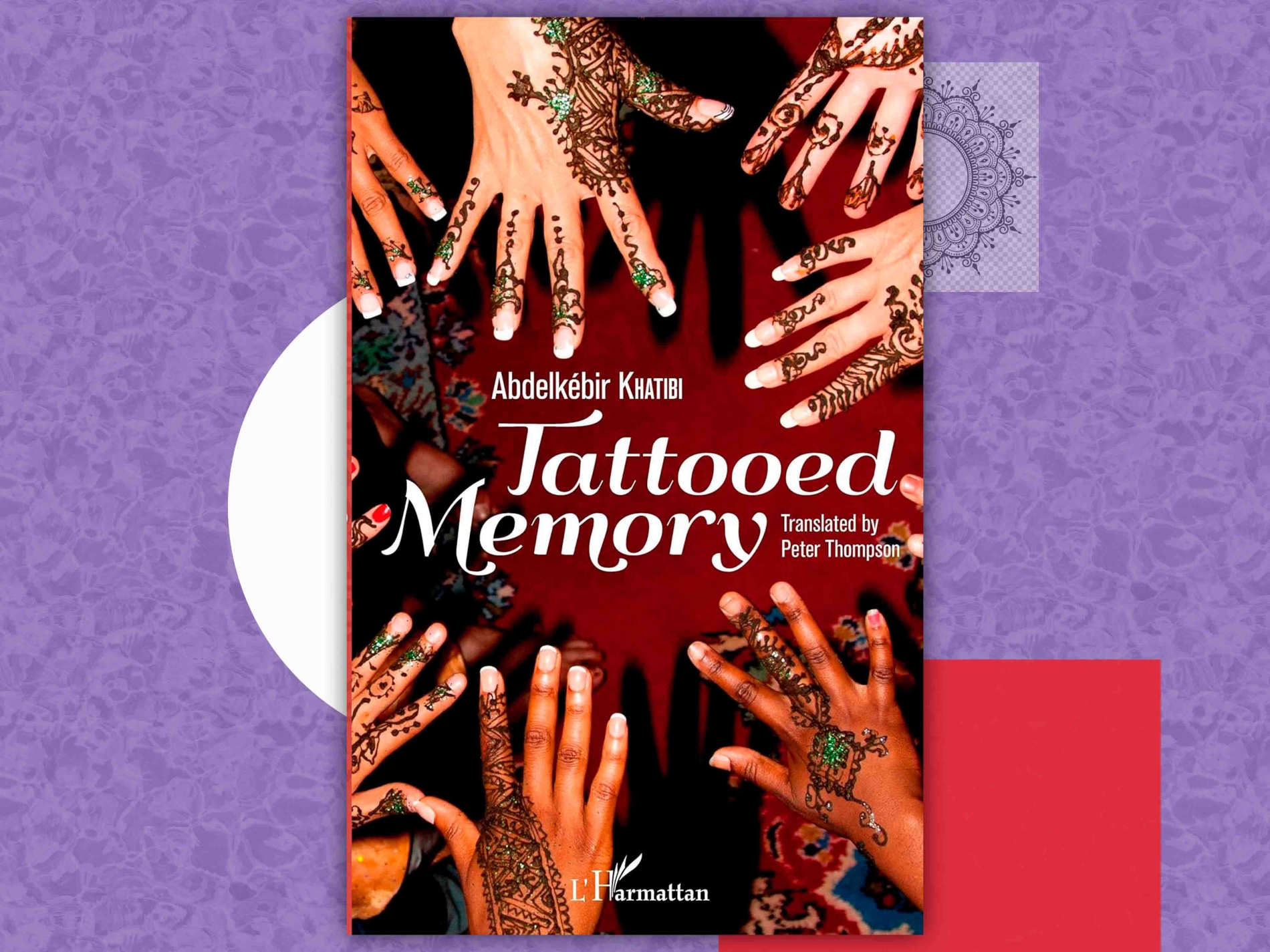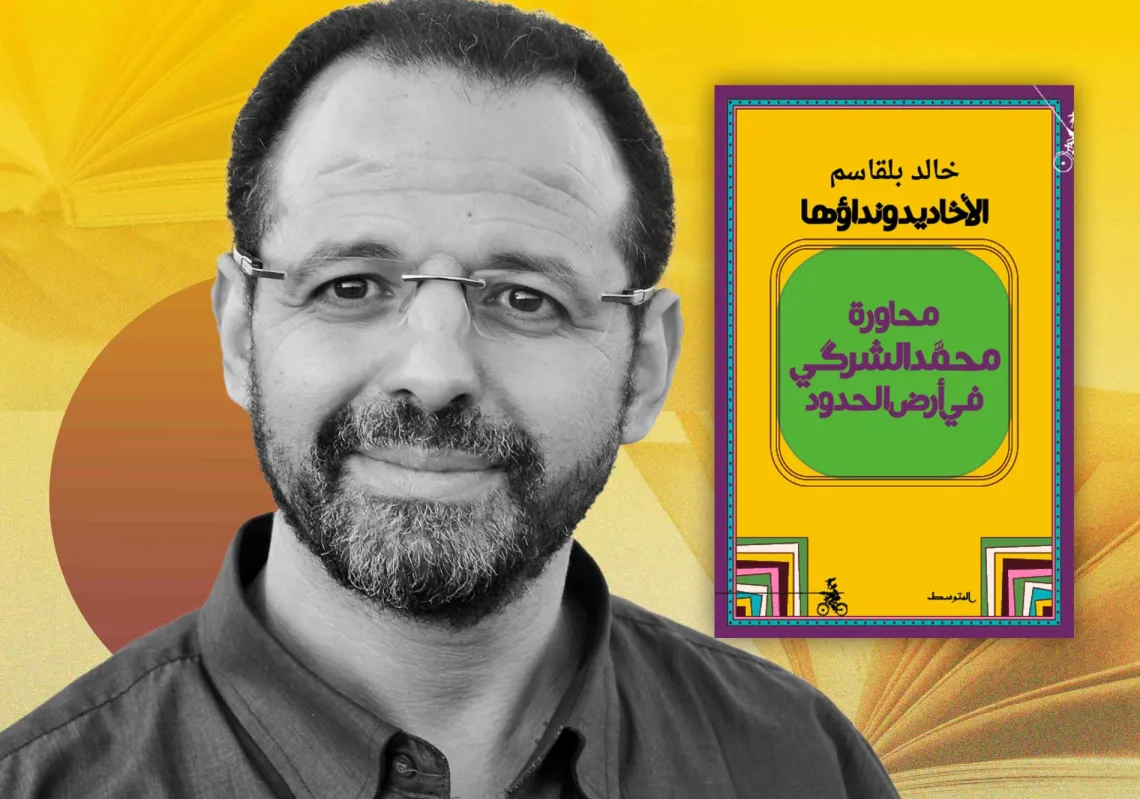صدرت قبل أشهر قليلة الترجمة الإنكليزية لكتاب المفكر المغربي الراحل عبد الكبير الخطيبي "الاسم العربي الجريح"، الذي كان وضعه بالفرنسية في 1974 وترجم إلى العربية عام 1980. الترجمة التي صدرت عن جامعة "نورثويسترن" الأميركية، جاءت بتوقيع مات ريك، وهي تعيد الاعتبار إلى كتاب أقل ما يوصف به أنه كان علامة فارقة في زمنه، حتى بات من كلاسيكيات الفكر العربي المعاصر.
تعددية معرفية
رحل عبد الكبير الخطيبي عام 2009 تاركا خلفه الكثير من الأحلام الفكرية المعلقة. وعلى الرغم من رحيله المبكر، بالمقارنة مع مجايليه، يظل صاحب "الذاكرة الموشومة" أحد أكثر المفكرين العرب تأثيرا في بنية الثقافة العربية المعاصرة، رغم عدم الاعتراف بذلك، بحكم الإمكانات المذهلة التي ظل يحبل بها مشروعه الفكري الممجد للتفكيك والمدافع عن مفاهيم فكر الاختلاف في إطار ما بات يُعرف بـ"النقد المزدوج".
أحيانا وأنت تقرأ الخطيبي يخيل إليك أنك تفهمه، لكن في لحظة ما تشعر أنك داخل متاهة فكرية يصعب عليك الخروج منها، لأنها تستحوذ عليك وتهدم كل أفكارك المسبقة التي كونتها تجاه مفهوم أو موضوع ما.
ورغم الترجمات المختلفة التي أنجزها العديد من الكتاب والباحثين العرب للخطيبي ونسجوا معه صداقة حقيقية في حياته الفكرية مثل محمد بنيس وفريد الزاهي ومحمد برادة وأدونيس وغيرهم من الكتاب الذين ترجموا دراسات أو مؤلفات صاحب "المناضل الطبقي على الطريقة التاوية"، تبقى كتاباته شائكة، تفرض على القارئ أن يكون قارئا نهما لكتابات كل من موريس بلانشو وجاك دريدا ورولان بارت وجيل دولوز وغيرهم من المفكرين الذين يحضرون في ثنايا نصوصه، لكن عبر التحليل والمساءلة والنقد وليس من طريق الاجترار وتدوير الكلام.
فهذه الأسماء الفكرية الفرنسية القريبة من الخطيبي، تفكيرا وصداقة، جعلته مبكرا يجترح مشروعه الفكري الخاص الذي لا يقلد فيه أحدا، بقدر ما يحاول أن يجد له موطئ قدم داخل فكر الاختلاف الذي جعل منه علامة بارزة في مساره الفكري.