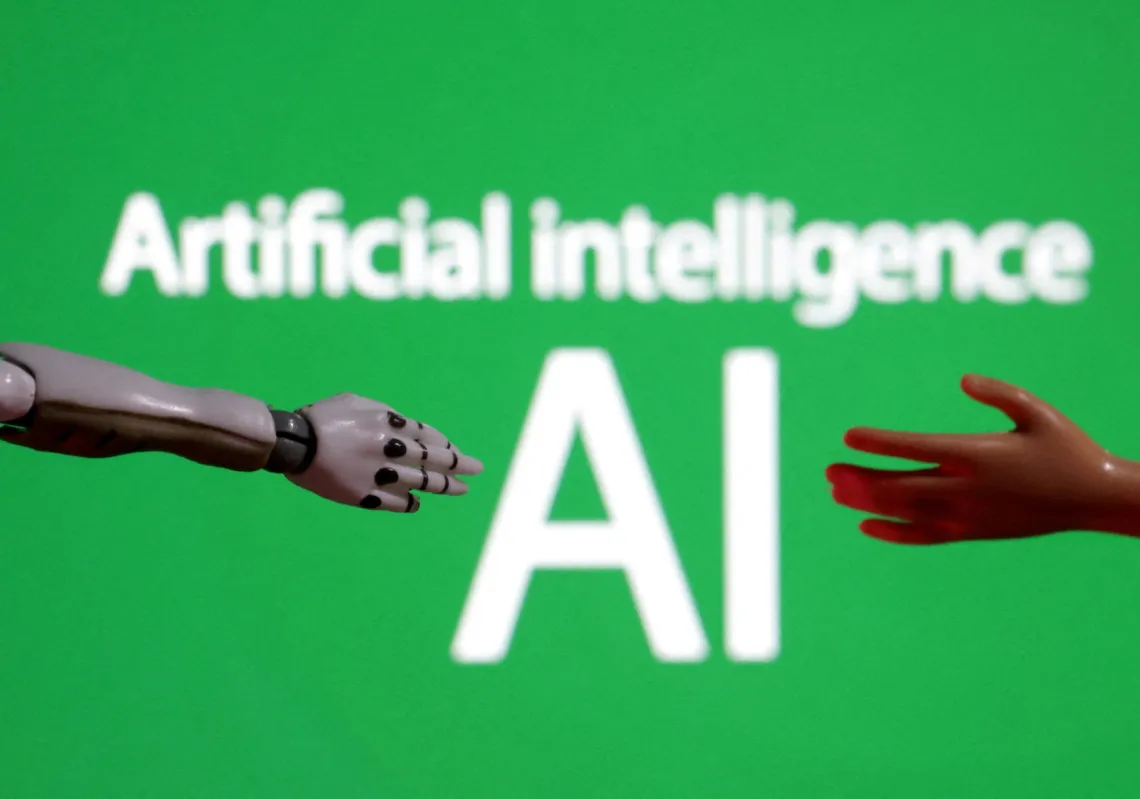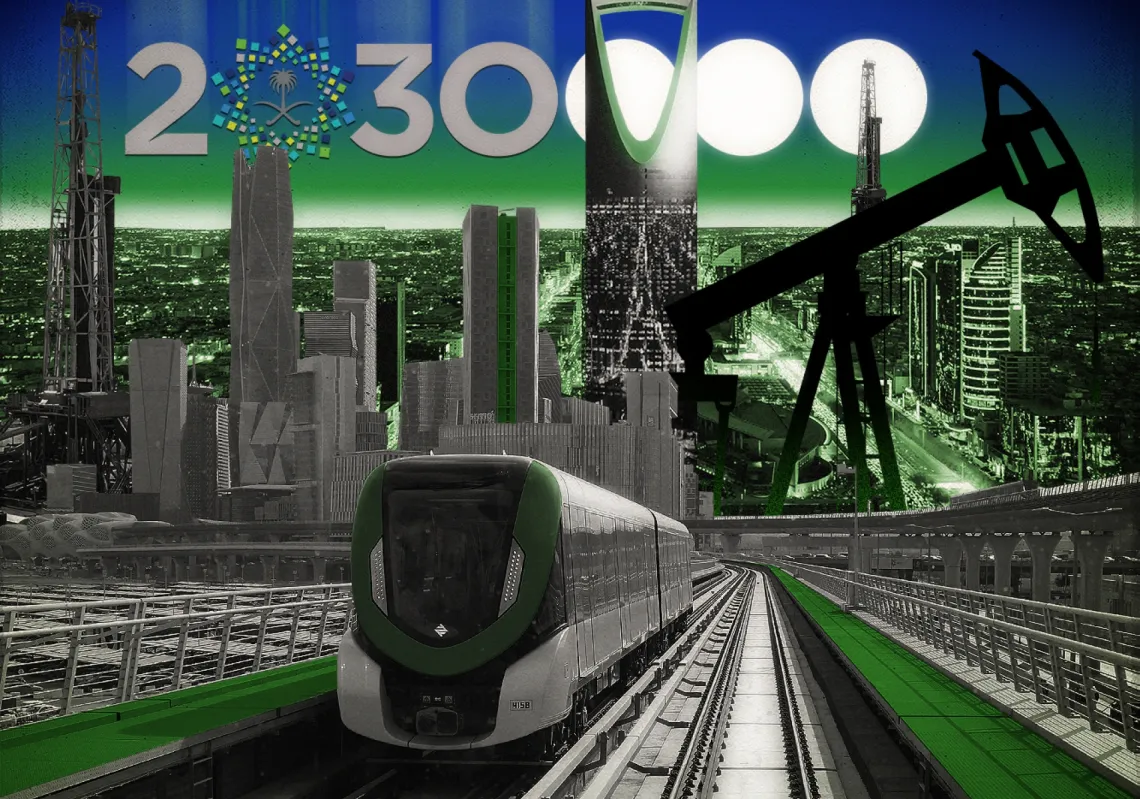في عام 2000، كان الفصل الثاني من ولاية بيل كلينتون يقترب من نهايته، وكان يبذل جهودا محمومة للتوصل إلى اتفاق نهائي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك وياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية. فريق كلينتون، شأنه شأن الإدارات السابقة، كان يرى أن حل الدولتين سيمهد الطريق لاتفاق شامل بين إسرائيل والدول العربية يرسخ استقرارا دائما في المنطقة. وفي اجتماعات كامب ديفيد الأخيرة، انغمس كلينتون شخصيا في تفاصيل الخرائط والحدود، متفحصا أحياء وشوارع بعينها في القدس، محاولا صياغة تسوية نهائية بين باراك وعرفات. لاحقا حمّل كلينتون عرفات مسؤولية الفشل، لكن كتابا جديدا لمساعده روبرت مالي يشكك في هذا الحكم.
بيل كلينتون يسعى إلى حل الدولتين
وبينما كان كلينتون يسعى إلى حل الدولتين، كان يمارس ضغوطا على صدام حسين للتعاون مع تحقيقات الأمم المتحدة بشأن برنامج الأسلحة العراقية للدمار الشامل. وقد أطلق بضع ضربات صاروخية، لكنه تجنب أي تدخل بري أميركي في المنطقة. وكما فعل سلفه الرئيس جورج هربرت ووكر بوش، لم يرغب كلينتون في الانخراط في تغيير النظام أو في سياسات العراق الداخلية، بل فضل استخدام الضربات الصاروخية والعقوبات القاسية لانتزاع تعاون بغداد. وبررت وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت العقوبات على العراق، على الرغم من آثارها الكارثية على المدنيين العراقيين، بمن فيهم الأطفال.