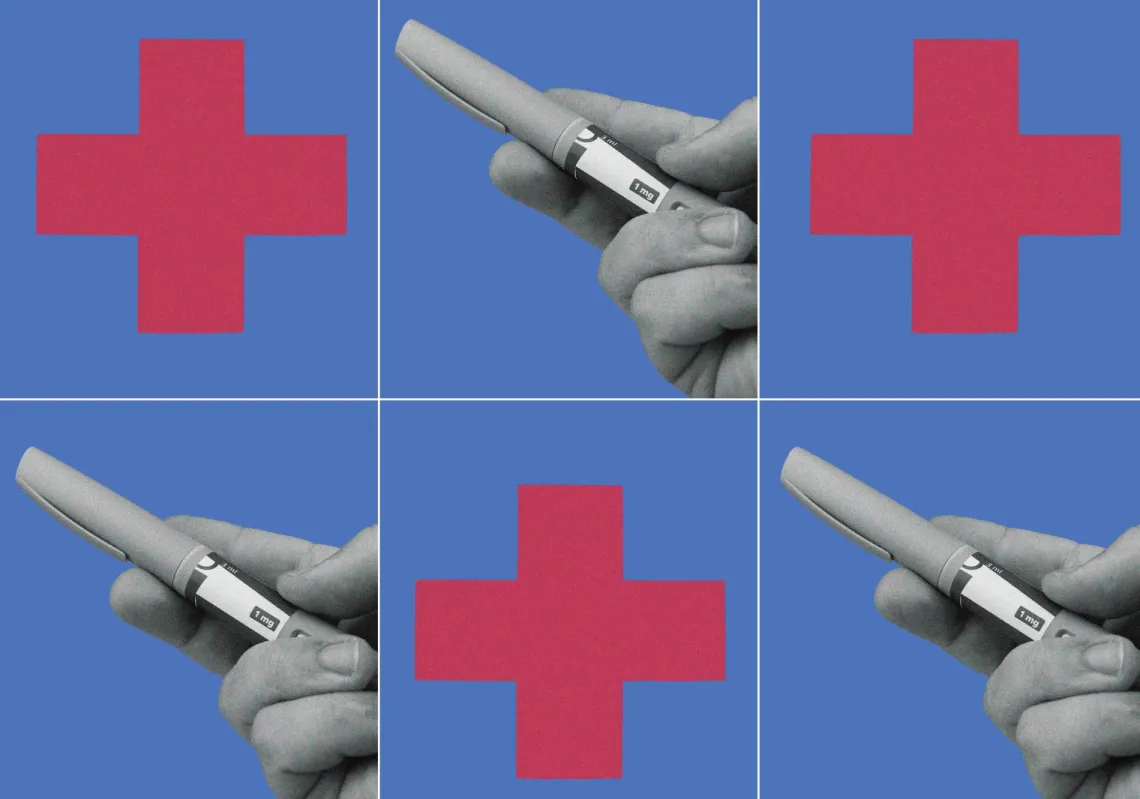مع انتهاء ربع قرن كامل من الألفية الجديدة، يتضح أن العالم لم يشهد مجرد تقدم تقني متسارع، بل مر بأكبر سلسلة تحولات تكنولوجية في تاريخه الحديث.
خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، تغير كل شيء تقريبا من الأدوات التي نستخدمها، وطرق العمل والتواصل، حتى شكل العلاقات الإنسانية وطريقة فهم الفرد للعالم من حوله، بدأت هذه التحولات بالثورة الرقمية والانتشار الكاسح للهواتف المحمولة والإنترنت، ثم تبلورت في شبكات التواصل الاجتماعي التي أعادت تشكيل السلوك البشري والوعي الجمعي.
ومع العقد الثاني من القرن، ظهر الذكاء الاصطناعي بقوة، ليتحول من مفهوم أكاديمي وتجارب مخبرية إلى لاعب مؤثر في مقدمة قطاعات الاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية وميزان القوى العالمي. لم تعد التكنولوجيا مجرد وسيلة مساعدة للإنسان، بل أصبحت قوة مستقلة تساهم في صياغة القرار السياسي، وتوجيه الرأي العام، والتحكم في تدفق المعلومات، بل وحتى في التأثير على الحالة النفسية للبشر وهويتهم الثقافية.
ولم يبق هذا التحول محصورا في التقنية الرقمية، بل تمدد إلى عوالم أكثر عمقا مثل البيوتكنولوجيا، والتعديل الجيني، والهندسة الحيوية، والطب الوقائي المعتمد على البيانات، ما يعني أن التكنولوجيا لم تعد تغير الأدوات فحسب، بل بدأت تتداخل مع جسد الإنسان نفسه وتعيد تعريف مفهوم الحياة والصحة والقدرات البشرية.
قبل عام 2007، لم يكن اسم "آبل" محسوبا في سوق الهواتف المحمولة أساسا، بينما كانت "نوكيا"- بلا منافس- اللاعب الأكبر والمهيمن على السوق العالمية. ففي مطلع الألفية، امتلكت "نوكيا" ما يقارب نصف سوق الهواتف عالميا، وكانت أجهزتها رمزا للمتانة كما كانت البطارية طويلة العمر، بالإضافة إلى البساطة التي يحتاجها المستخدم العادي، فهواتف مثل "نوكيا-3310" و"نوكيا-1100" أصبحت جزءا من الذاكرة الجمعية لمئات الملايين، وكانت وسيلة الاتصال الأساسية لعدد هائل من الناس حول العالم، إلى درجة أن بعض الدول ربطت انتشار الإنترنت والاتصالات المحمولة بتوسع "نوكيا" نفسه.
لكن كل شيء تغير في عام 2007. فمع إطلاق "آبل" للجيل الأول من "آيفون"، تعرضت صناعة الهواتف لـ"زلزال تقني" لا يشبه أي حدث سابق. "الآيفون" لم يكن مجرد هاتف جديد، بل قدم فلسفة مختلفة بالكامل، من ضمنها شاشة لمس كاملة بدل الأزرار، ومتجر تطبيقات، وإنترنت سريع في الجيب، وتكامل بين الجهاز ونظام التشغيل والخدمات الرقمية. هذا لم يغير شكل الهاتف فقط، بل غير تعريفه، وانتقلت الصناعة من عصر "هاتف للاتصال" إلى عصر "منصة رقمية متعددة الوظائف" تعمل ككاميرا، ومركز ترفيه، ومحفظة مالية، وأداة للعمل، ومساحة شخصية للتواصل والذاكرة الرقمية.
تزامنا مع ذلك، تحول النجاح التاريخي لـ"نوكيا" إلى نقطة ضعف قاتلة. فالشركة اعتبرت أن التغيير جذري لكنه مؤقت، وتمسكت بنموذج الهواتف التقليدية وبأنظمة تشغيل قديمة بدل التحرك بسرعة نحو نظام أكثر تطورا مثل أندرويد. وعندما أدركت أن السوق تغيرت فعلا، كان الوقت قد تأخر؛ فخلال أقل من عشر سنوات، انهارت سيطرة "نوكيا" وخرجت من سباق الهواتف الذكية تقريبا، بعد أن كانت اللاعب الأول بلا منافس طوال عقود.