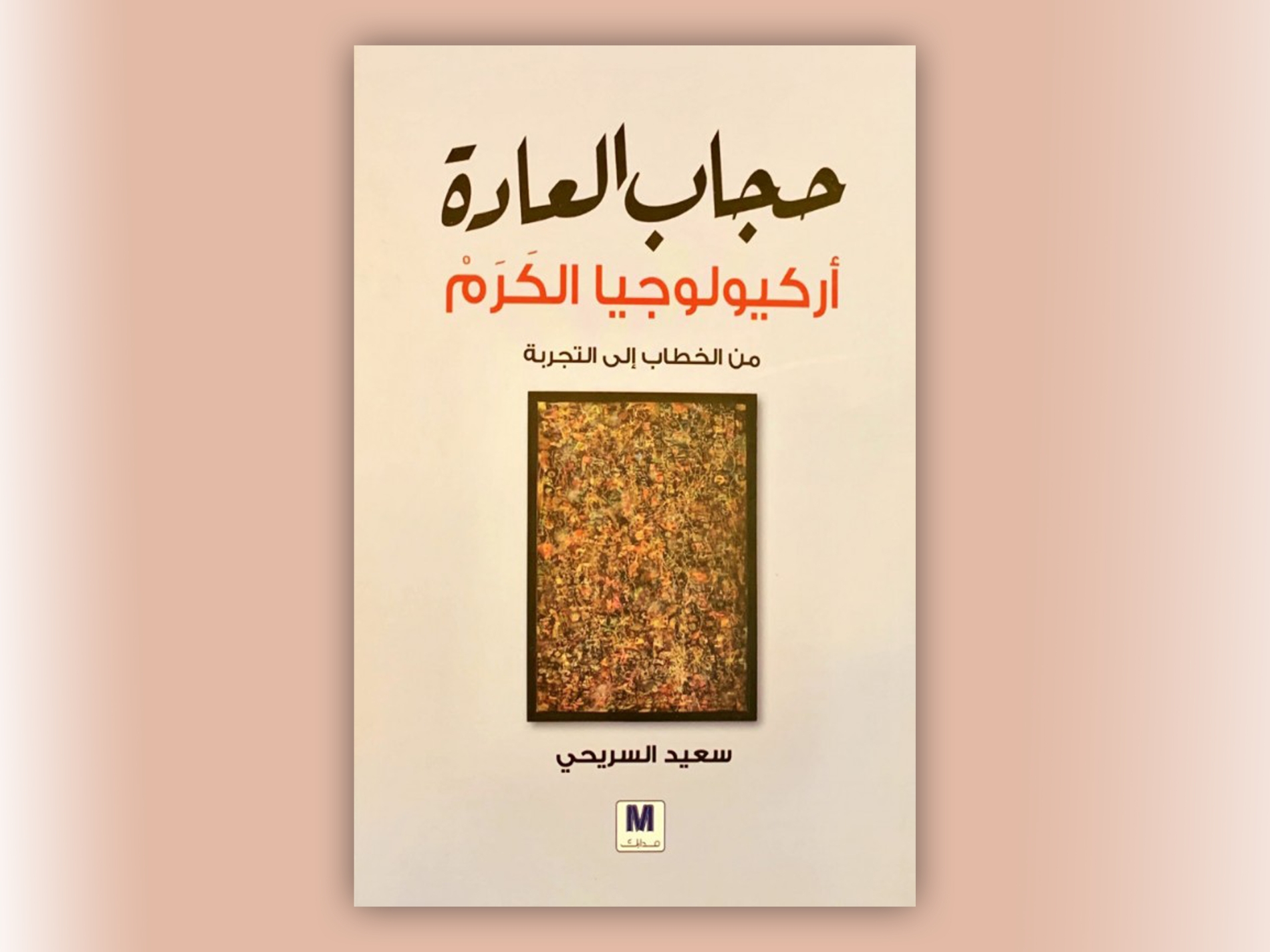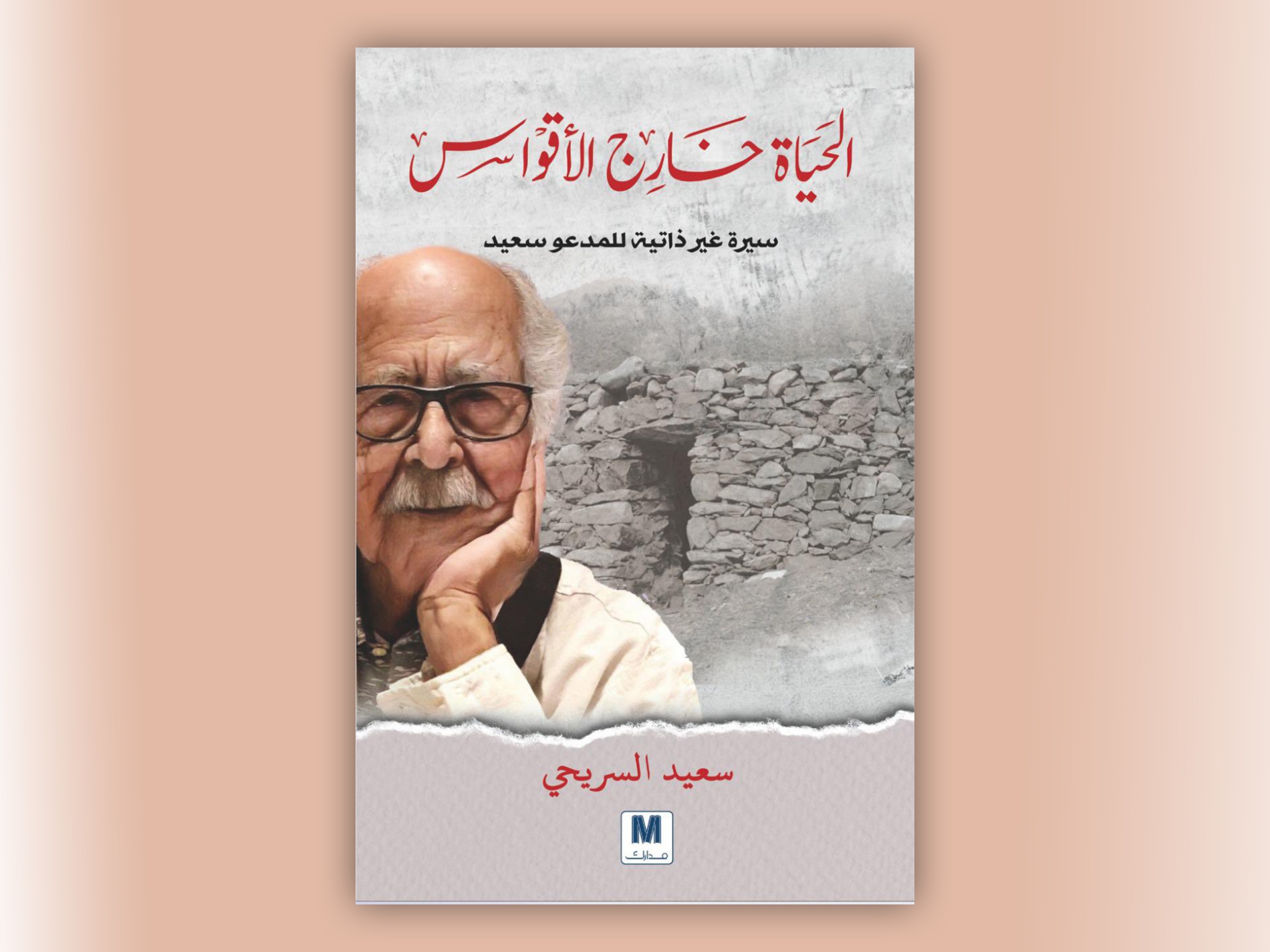ودعت المملكة العربية السعودية الأديب والناقد الكبير الدكتور سعيد السريحي الذي حمل على عاتقه، طوال عقود، إنتاج المعرفة بوصفها واجبا أخلاقيا لا امتيازا ثقافيا أو إبداعيا.
مضى السريحي بصمته المعتاد تاركا خلفه فراغا لا يملأ بسهولة. فلم يكن رحيله حدثا عابرا، بل خسارة كبرى في جسد الثقافة العربية، إذ بغيابه يغيب عقل اعتاد أن يرى أبعد من اللحظة الراهنة، وأن يكتب ضد النسيان والتلاشي. إلا أن بعض النقاد والمفكرين لا يغادرون العالم حين يموتون، بل يتركونه أكثر انفتاحا على الفهم، وجرأة على السؤال، وأشد ارتباطا باللغة واشتباكا مع الحياة.
فضاء الميلاد
ولد سعيد مصلح السريحي في عام 1953، في أحد أحياء جدة العتيقة، وعاش في حي الرويس حتى بلغ 12 عاما، في المنزل الذي احتفظ بأحلامه، وبركة الماء التي طالما وقف عليها لمشاهدة الحارة بتشكلاتها، ذلك الحي الذي احتفظ بأحلامه اللا منتهية، والتي عاد إليها بعد غياب كأنه يحتضنها لتبقى ملهمته.
ولما كان ذلك الطفل في مرحلة الخامس ابتدائي، وفي الحي ذاته، وقف أمام "الميكروفون" للمرة الأولى في حياته، وألقى كلمة مدرسته الابتدائية في احتفال تولي الملك فيصل مقاليد الملك، كان ذلك في عام 1965، بطفولته الشجاعة ألقى خطابه المفوه ذاك، كأنه جاء إلى العالم بروح تشبه البحر الذي يجاور مدينته. بحر مفتوح على الاحتمالات، عميق في أسئلته، وغزير في أمواجه وذكرياته.
لم تكن يومها مدينة جدة وتحديدا حي الرويس بالنسبة له مكانا فحسب، بل فضاء أوليا للدهشة، وحيا تتقاطع فيه الحكايات، وتتولد منه الأزمنة، وتمنح ساكنها حسا مبكرا بتعدد الأصوات واختلاف الرؤى. في تلك البيئة الحجازية المشبعة بالتاريخ واللغة، بدأت بذور الفكر تنمو في صدر السريحي منذ الطفولة.
كان انشغاله المبكر بالكلمة يتجاوز الحفظ والتلقي إلى فضول حاد تجاه المعنى، وما تختزنه اللغة من سلطة وخفاء. لم يكن طالبا عاديا في سنواته الأولى، بل قارئا يلتقط ما يناسبه من وراء السطور، ويصغي إلى النبرة الخفية في النصوص، وكأنه يتهيأ لكتابة اختارته قبل أن يختارها، ليثبت لاحقا وعلى امتداد عقود مسيرته أن اللغة وجدته أرضا صالحة لقلقها الدائم.
فضاء التحديات
بعدما أنهى السريحي مراحله الدراسية في جدة انتقل إلى مكة المكرمة ليلتحق بجامعة أم القرى، وتحديدا بكلية اللغة العربية، وما أن أنهى مرحلة البكالوريوس حتى انتقل إلى فضاء من التحديات الجديدة، ليعد أطروحته لنيل رسالة الماجستير، التي تناول فيها "شعر أبي تمام بين النقد القديم ورؤية النقد الجديد"، مركزا في رسالته uلى قدرة أبي تمام على احتضان التجربة الإنسانية في أفقها الزمني الواسع، مؤكدا القدرات الشعرية التي امتلكها أبو تمام للخروج على النسق المعتاد، والمتكرر في تراكيبه اللغوية.