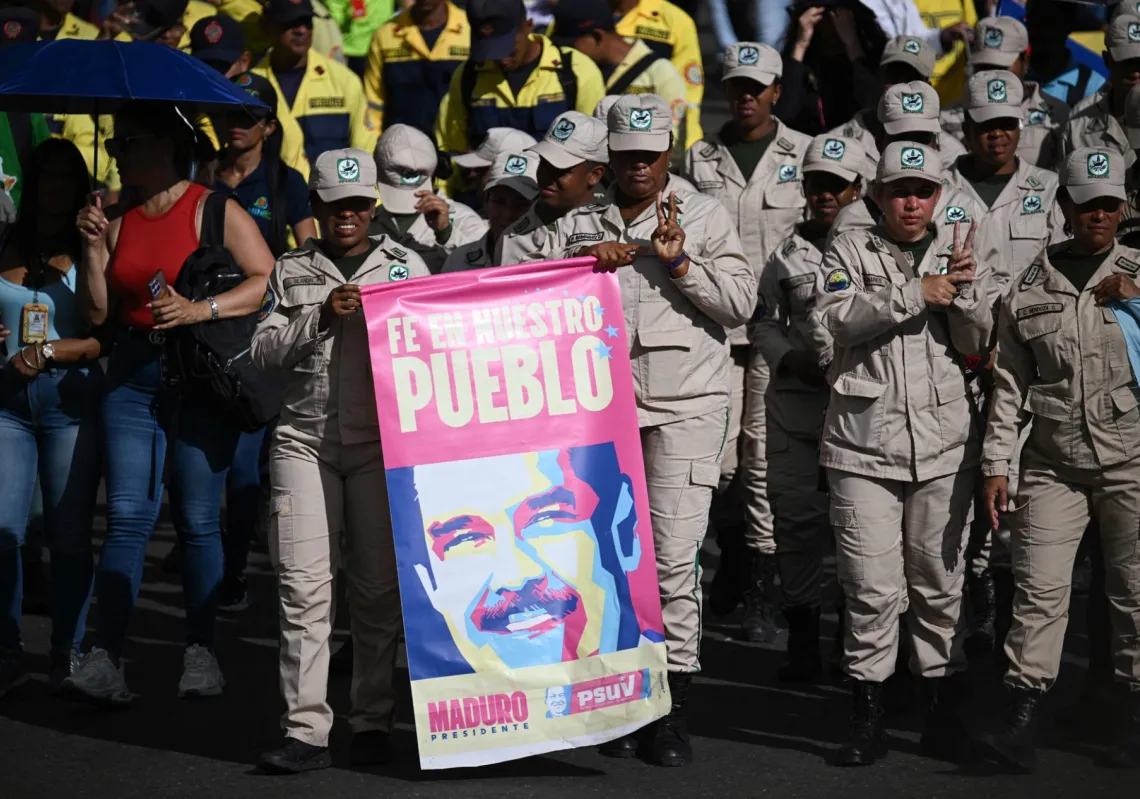تعود التعريفات الجمركية إلى القرن الخامس عشر، مع الاكتشافات الكبرى للعالم، منذ كريستوفر كولومبوس، وتوسع التجارة الخارجية للدول الأوروبية التي قامت على أساس تعريفة جمركية مرتفعة للحد من الواردات التي ترتبط بتدفقات مقابلة من الذهب والفضة إلى الخارج.
أدت الثورة الصناعية في أوروبا، نهاية القرن الثامن عشر، إلى تغيير مهم في دور التعريفة الجمركية، فقد زاد إنتاج السلع بشكل كبير في الدول الصناعية، وظهرت السكك الحديد والسفن البخارية مما سمح ببيع المزيد من منتجاتها إلى الدول الأخرى، وعزز خفض تعريفاتها الجمركية على شركائها في التجارة، بعكس الدول التي كانت في بداية التصنيع تبقي تعريفاتها الجمركية مرتفعة، حماية لصناعاتها الناشئة.
كانت الولايات المتحدة بين آخر الدول التي رفضت نظرية ديفيد ريكاردو، أحد أعمدة المدرسة الكلاسيكية في علم الاقتصاد، حول الميزة النسبية في مجال التجارة الدولية، واتبعت سياسة حمائية تظهرت بوضوح مع "قانون ماكينلي للتعرفة الجمركية"، وهو قانون أميركي صدر عام 1890 وقضى بزيادة التعريفات الجمركية من أجل حماية الصناعات المحلية، فارتفع متوسطها كنسبة مئوية من القيمة الجمركية للواردات الأميركية من 20,5 إلى 29 في المئة.