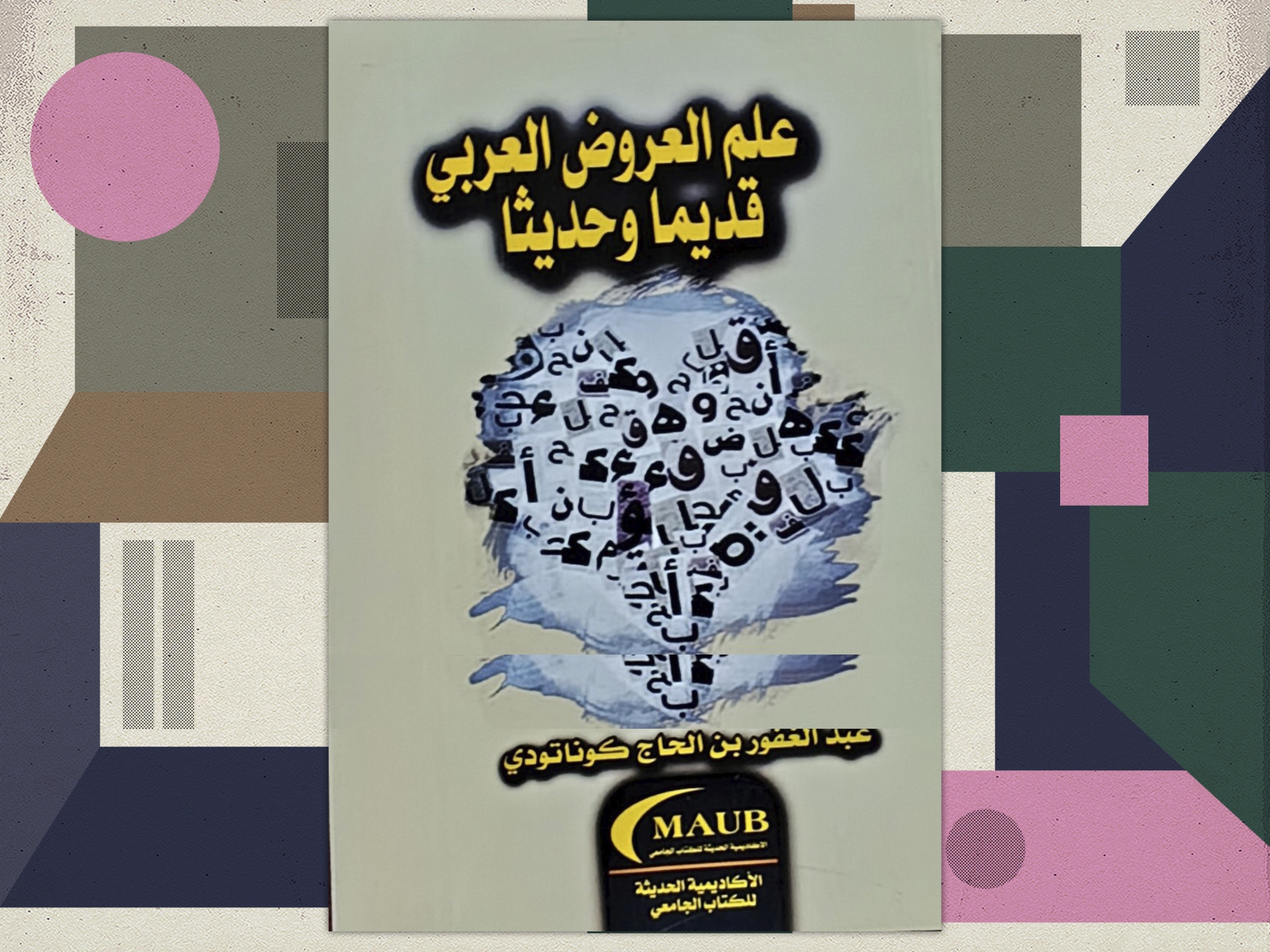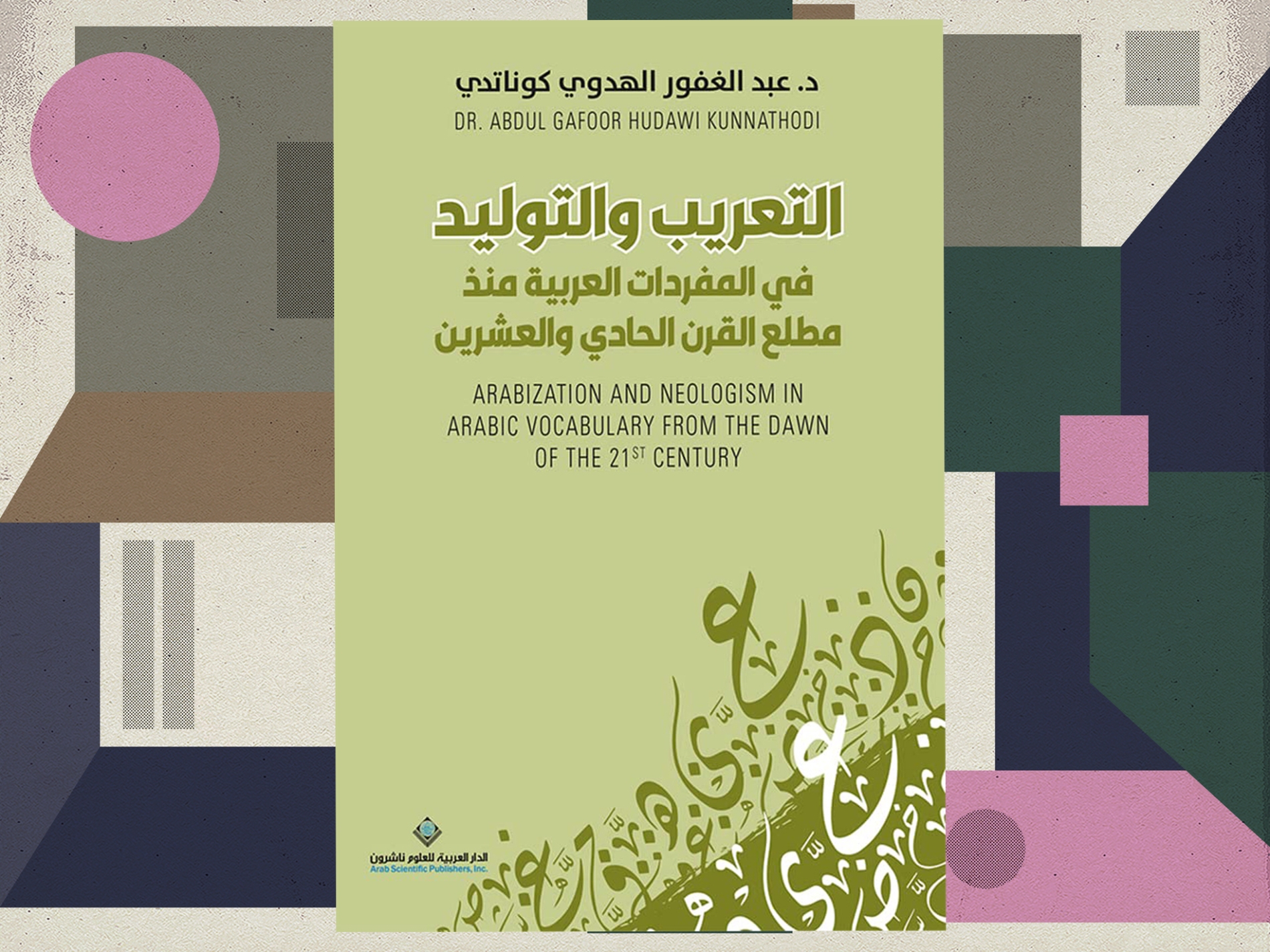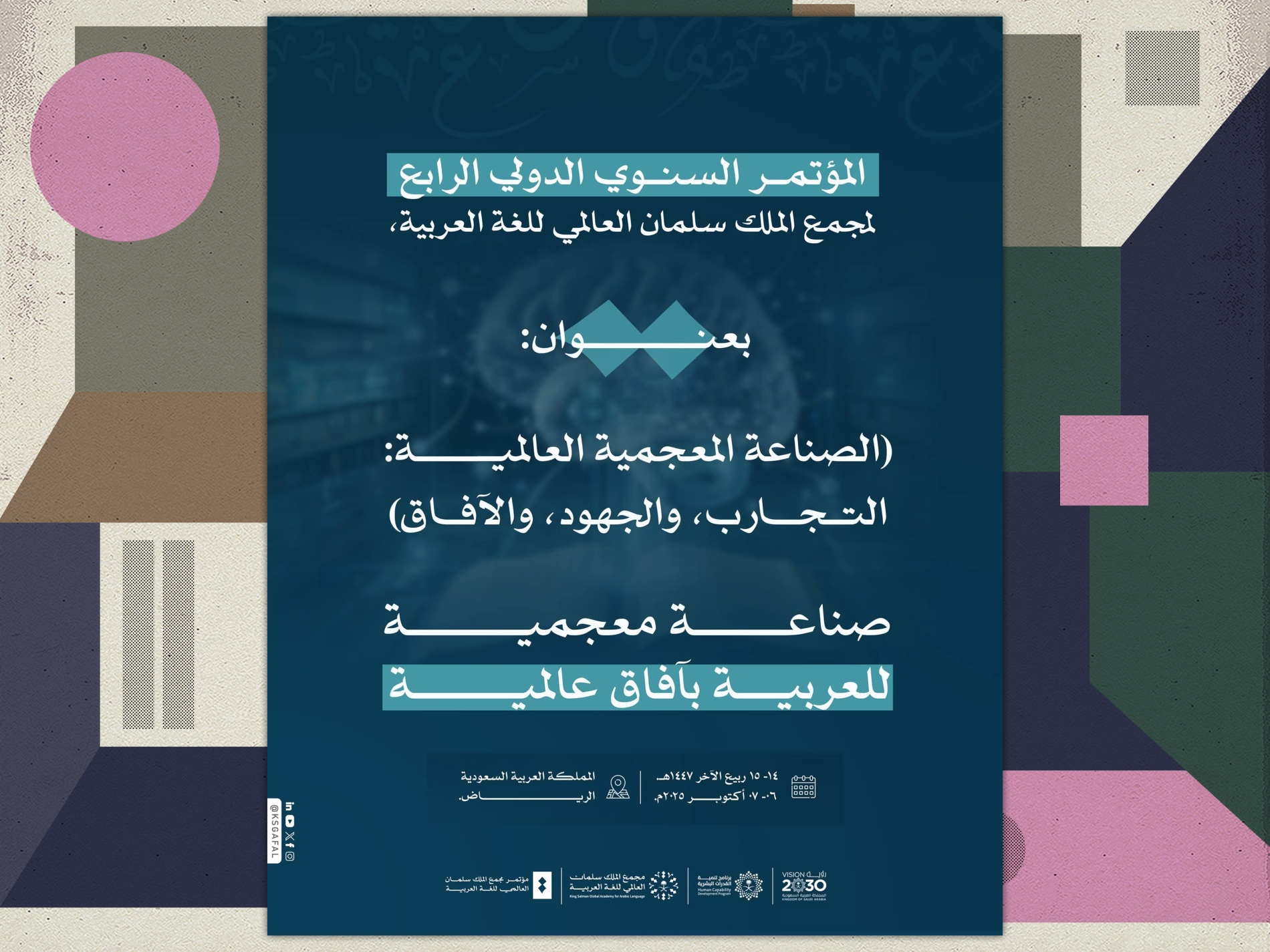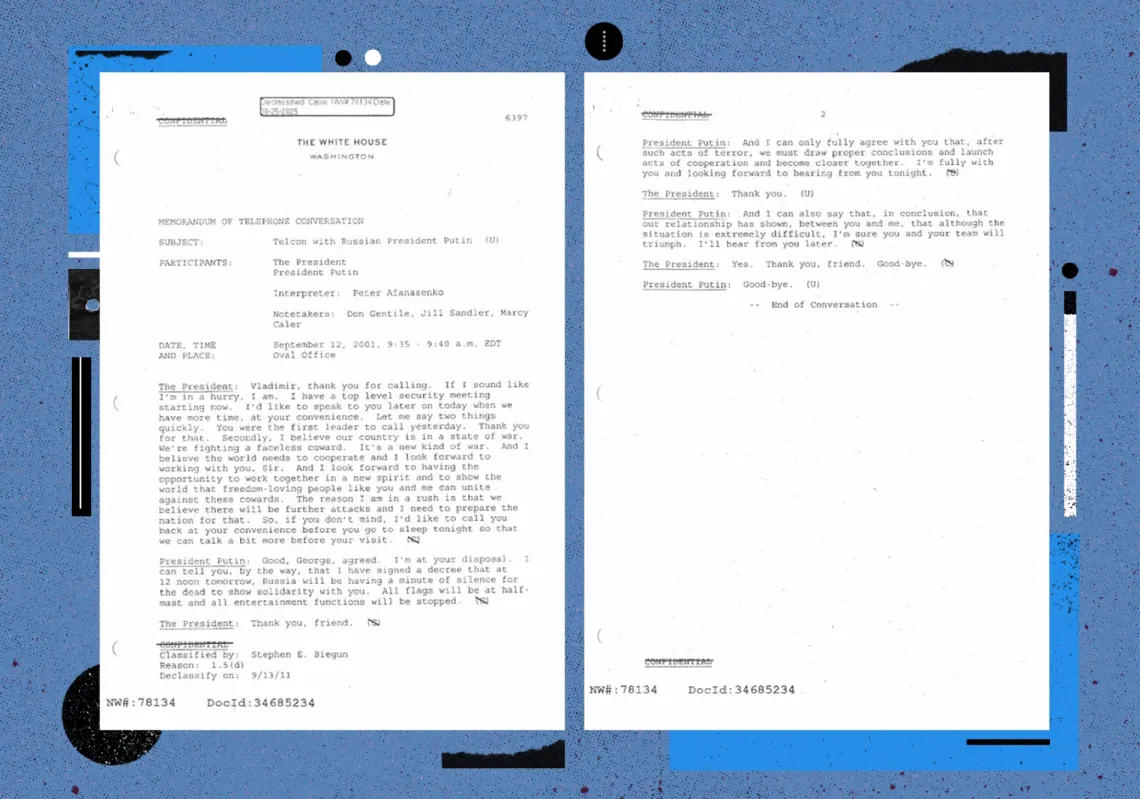في عصر يتسارع فيه إنتاج المعرفة العلمية عالميا، تبرز اللغة العربية كوعاء حضاري قادر على استيعاب المستجدات العلمية والتقنية. وتأتي المملكة العربية السعودية في طليعة الدول الداعمة للعربية، حيث يلعب مركز الملك سلمان العالمي للغة العربية دورا محوريا في ترسيخ مكانتها.
ومن الأصوات الأكاديمية البارزة في هذا المجال البروفسور الهندي عبد الغفور الهدوي كوناتدي، الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية في كلية تونجان الحكومية التابعة لجامعة كالكوت جنوب الهند، الذي يرى أن مستقبل "الصناعة المصطلحية العربية يواجه تحديات حقيقية تتطلب الابتكار لمواكبة التطورات السريعة مثل الذكاء الاصطناعي". ويعد كوناتدي من أبرز الوجوه العلمية المعنية بالحوار الثقافي العربي- الهندي، ومن المهتمين بإعادة بناء جسور التواصل بين الثقافتين في ضوء التحولات الأكاديمية المعاصرة في دراسة العالمين العربي والإسلامي.
"المجلة" التقته خلال فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الرابع، "الصناعة المعجمية العالمية: التجارب، الجهود، والآفاق" الذي انعقد في الرياض يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تحت شعار "صناعة معجمية للعربية بآفاق عالمية".
ما الذي دفعكم لاختيار "معجم مصطلحات كوفيد-19" الصادر عن "الألكسو" بشكل خاص كحالة دراسة تطبيقية؟ وهل ترون أن استجابة المؤسسات اللغوية الرسمية للجائحة كانت بالمستوى المطلوب من حيث السرعة والدقة؟
اختياري لـ"معجم مصطلحات كوفيد-19" لم يأت مصادفة، بل لأنه يمثل أول استجابة عربية مؤسسية شاملة لطارئ لغوي وعلمي عالمي بهذا الحجم. فقد وضع هذا المعجم في ظرف استثنائي يتطلب سرعة في التوليد ودقة في الخضوع للقواعد، وهو ما جعله مختبرا حيا يمكن من خلاله قياس كفاءة الصناعة المصطلحية العربية تحت الضغط. لقد حاول المعجم أن يوازن بين الأمانة العلمية والأصالة اللغوية، وهو جهد يستحق التقدير. ومع ذلك، فإن سرعة الاستجابة لم تكن دائما مقرونة بالتوحيد أو التداول الواسع، مما يكشف عن حاجة المؤسسات اللغوية العربية إلى مزيد من التنسيق والتكامل في مواجهة الأزمات المصطلحية الطارئة.
تراكيب وصفية معقدة
كشفت دراستك المقدمة الى المؤتمر أن آلية "التركيب" هيمنت على صوغ مصطلحات المعجم بنسبة تفوق 80%، هل يعكس هذا الإفراط في الاعتماد على التركيب قصورا في الآليات الأخرى كالانشقاق والنحت، أم أنه الخيار الأمثل لطبيعة المصطلحات العلمية المركبة؟
هيمنة آلية التركيب بهذه النسبة الكبيرة لا تعد بالضرورة ضعفا في الآليات الأخرى، بل هي، إلى حد كبير، انعكاس لطبيعة المصطلحات العلمية الحديثة التي تميل إلى التراكيب الوصفية والمعقدة. فالمفاهيم الطبية والصحية – كـ"العزل الصحي" و"ضعف التنفس" و"كمامة الوجه" – بطبيعتها تتطلب بناء وصفيا يحدد العلاقة بين المكونات. ومع ذلك، فإن الإفراط في التركيب قد يضعف مرونة المصطلح ويحد من قابليته للتداول، خاصة بين الأوساط المتخصصة. لذلك أرى أن التوازن هو الحل الأمثل: ينبغي توظيف الاشتقاق والنحت والتوليد الدلالي كلما أمكن، لأنها تمنح المصطلح العربي قوة في الاختصار وسلاسة في الاستعمال، دون التفريط في الدقة العلمية.
أشرت في الدراسة إلى "المفارقة المركزية" المتمثلة في محاولة التوفيق بين الأصالة اللغوية والانفتاح على المصطلحات العالمية. كيف يمكن تحقيق هذا التوازن الدقيق عمليا دون الوقوع في براثن الجمود اللغوي أو الذوبان في المصطلح؟
هذه المفارقة بين الأصالة والانفتاح هي جوهر معركة اللغة في العصر الحديث. فالعربية لا تطالب بالانغلاق، بل بالتمكن الواعي من ذاتها قبل أن تنفتح على الآخر.