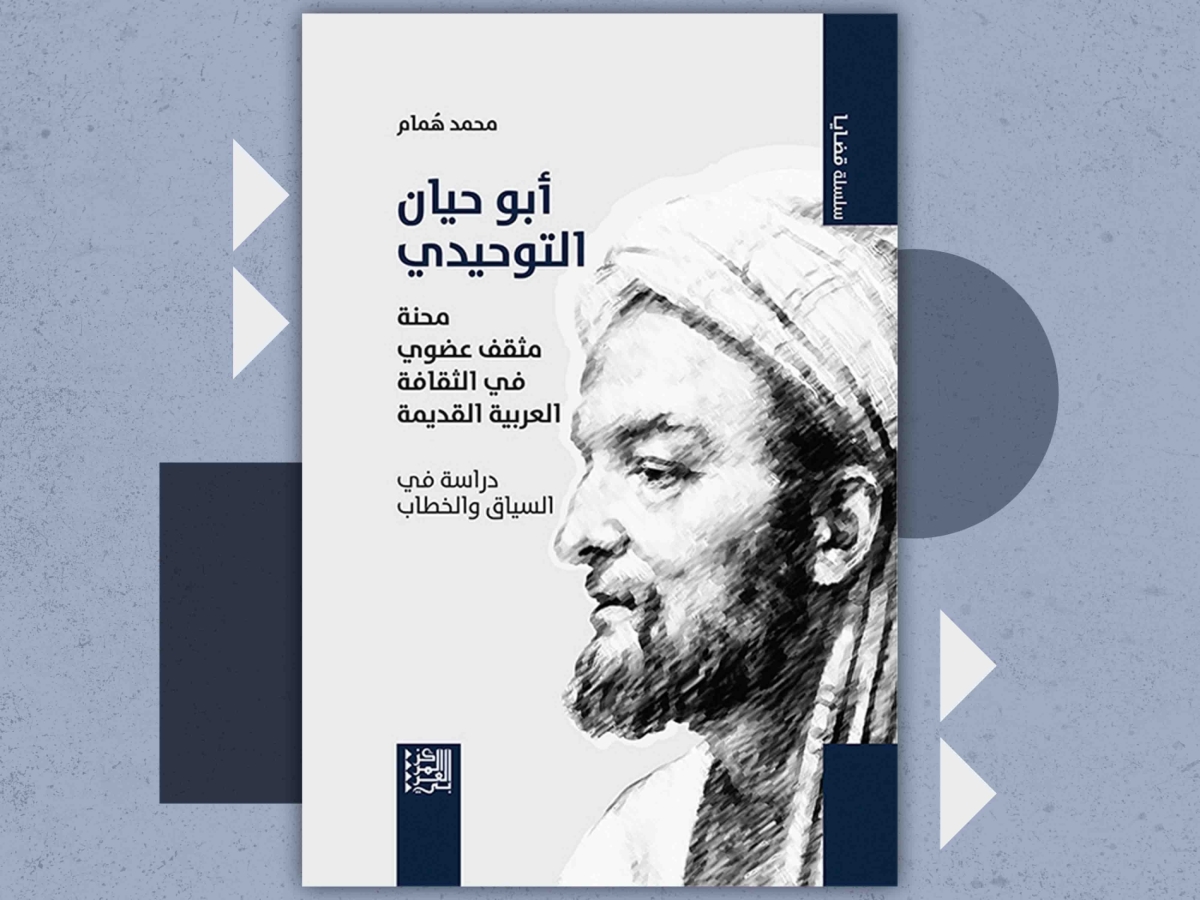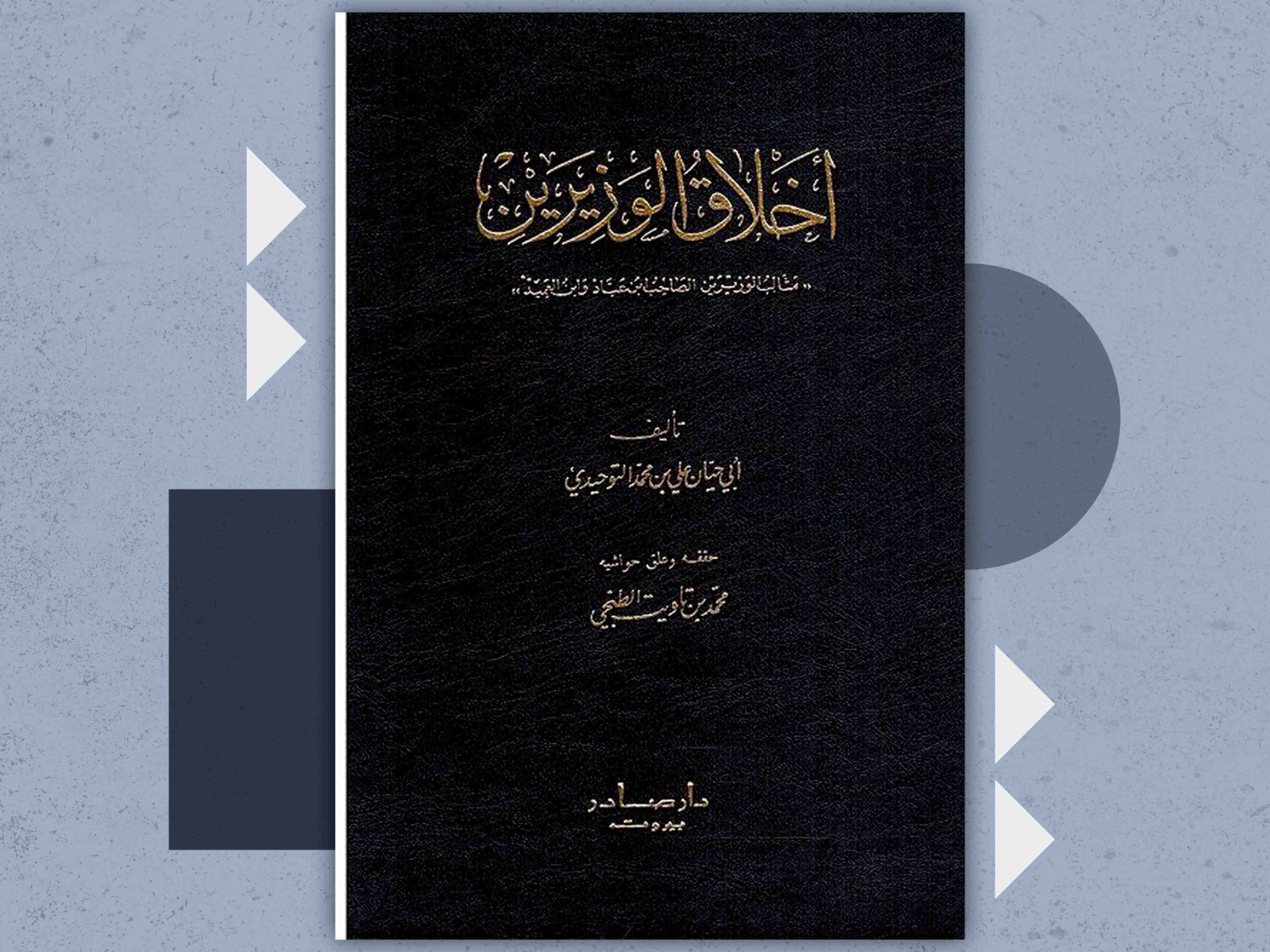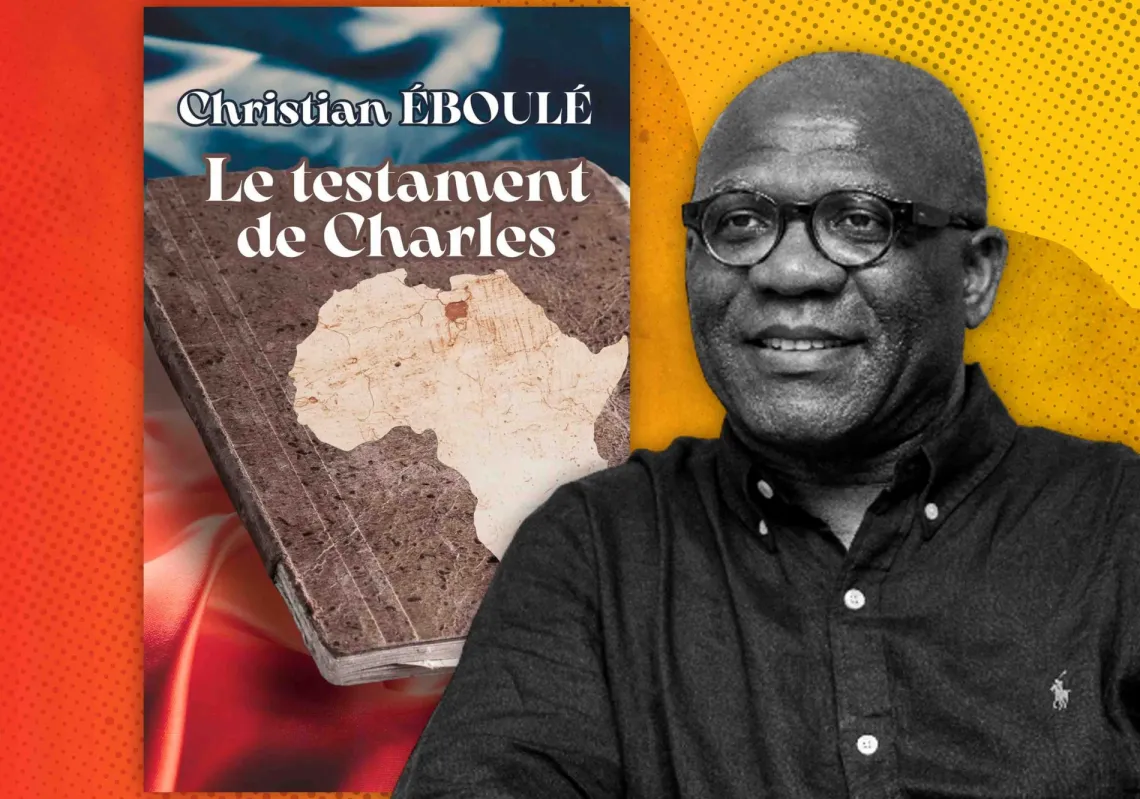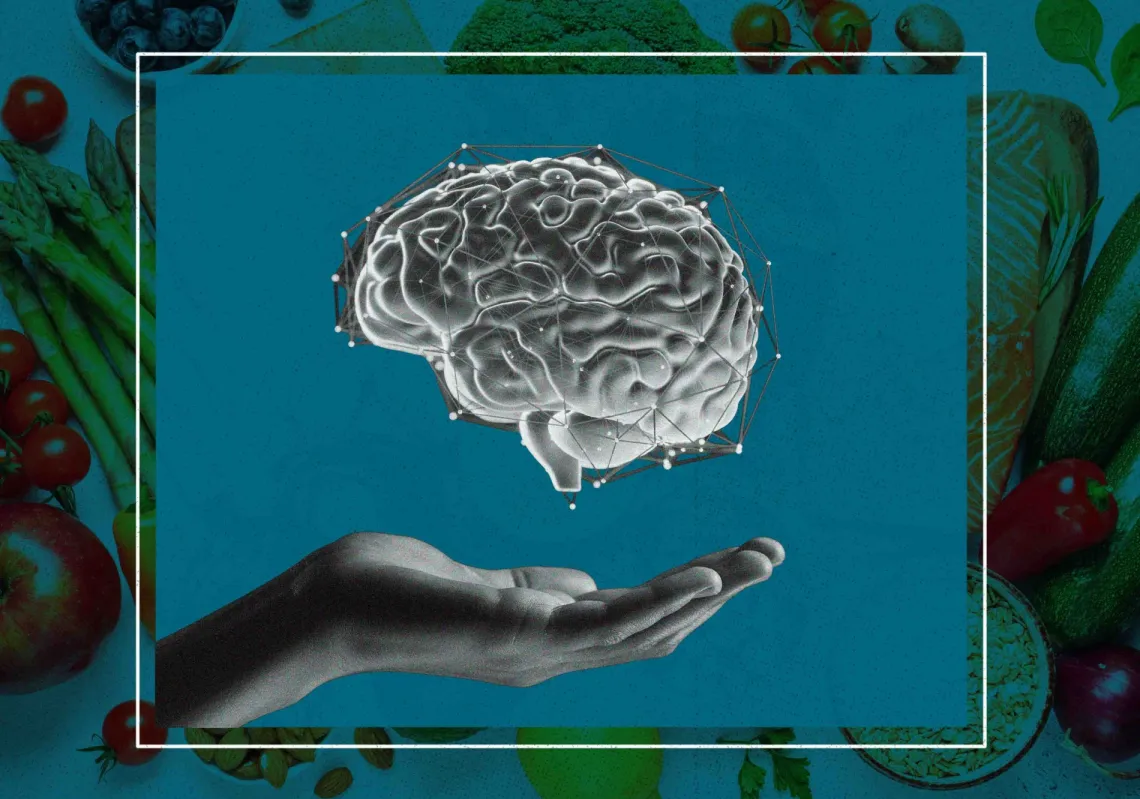يقدم كتاب "أبو حيان التوحيدي: محنة مثقف عضوي في الثقافة العربية القديمة، دراسة في السياق والخطاب"، الصادر حديثا في بيروت (2025)، عن "المركز العربي للأبحاث"، للمؤلف محمد همام، أستاذ البلاغة وتحليل الخطاب في جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب، دراسة تحليلية لمسيرة المثقف في الثقافة العربية القديمة، متخذا من أبي حيان التوحيدي نموذجا حيا. يغوص الكتاب في أعماق شخصية التوحيدي الفكرية، مسلطا الضوء على صراعه المرير وعلاقته المعقدة مع السلطة والمجتمع، وكيف شكل التراث اليوناني فلسفته وهويته، ليقدم تحليلا جريئا لأزمة المثقف العضوي في عصره.
الأصول الثقافية والفكرية
يتتبع الكتاب المراحل التكوينية لتشكل ثقافة التوحيدي (922-1023م)، من خلال تأثره برموز الفكر العربي، مبتدئا بتأثره العميق بالجاحظ (868م)، الذي كان الأستاذ المؤسس في الأدب والتقنيات البلاغية، ويتبدى أثره خصوصا في كتابي التوحيدي، "البصائر والذخائر" و"الإمتاع والمؤانسة".
وقد أشار التوحيدي إلى الجاحظ في أكثر من كتاب، واصفا كتبه بأنها "الدر النثير واللؤلؤ المطير"، وكان استفاد من عناصر الصراع الحضاري، خصوصا بين العرب والعجم، معتبرا إياه عنصرا فاعلا في تشكيل وعيه. ولم يتوقف عند تأثره بالجاحظ، بل امتد إلى العالم اللغوي والفيلسوف علي بن عيسى الرماني (994م)، الذي لازمه التوحيدي كثيرا، وقبس من علمه وتلقى منه ما بثه من ثقافة كلامية في كتبه، ويذكره التوحيدي بصفة "الشيخ الصالح".
أما في المحور اللغوي، فتأثر التوحيدي بالنحوي المعروف بالقاضي، أبو سعيد السيرافي (978م)، الذي رآه "شيخ الدهر، وقريع العصر، العديم المثل، المفقود الشكل".
ويناقش الكتاب الانفتاح المعرفي غير المسبوق للتوحيدي على الثقافات الأخرى، ويرصد الأثر الأجنبي وحدوده في ثقافته، خصوصا أن كتبه تؤشر إلى أنه درس الفلسفة اليونانية على يد أعظم فلاسفة عصره، إذ تتلمذ على يد الفيلسوف والمترجم متى بن يونس القنائي (939م)، وأبي سليمان المنطقي (توفي 990م)، دون إغفال تأثره بالتصوف الإسلامي الذي ظهر في كتاباته، مما يوضح تكوينه الثقافي المتنوع والمتوازن.
وفي مرحلة الانكفاء والعزلة، انعزل التوحيدي في بغداد، منصرفا إلى كتابة صوفية ذات بعد تربوي، كما في كتابه "الإشارات الإلهية"، الذي لم يكن انتحابا، بل كان تعبيرا عن "غربة وجودية مؤمنة"، ويؤكد المؤلف أن "نصوصه تدل على عمق إيمانه واتزانه".
تشويه الصورة وحقيقة التهم
شغل التوحيدي موقعا متميزا في المشهد الثقافي العام للقرن الرابع الهجري، حيث استطاع بصفته أديبا ومتصوفا وفيلسوفا، مزج الفلسفة بالأدب، وجمع ببراعة بين التراث اليوناني والثقافة العربية. غير أن هذه المكانة لم تسلم من التشويه المتعمد عبر العصور، إذ تعرض لهجوم حاد من مؤرخين ومفكرين بارزين. فقد هاجمه قاضي القضاة وأحد أشهر كتاب التراجم العربية، ابن خلكان (1282م)، في كتابه "وفيات الأعيان"، وهاجم خصوصا كتاب التوحيدي "أخلاق الوزيرين"، وادعى أن من يقتنيه تتعسر أحواله. وكان المؤرخ والمحدث الحافظ الذهبي(1348م)، هو الآخر هاجم التوحيدي، واتهمه بالزندقة.