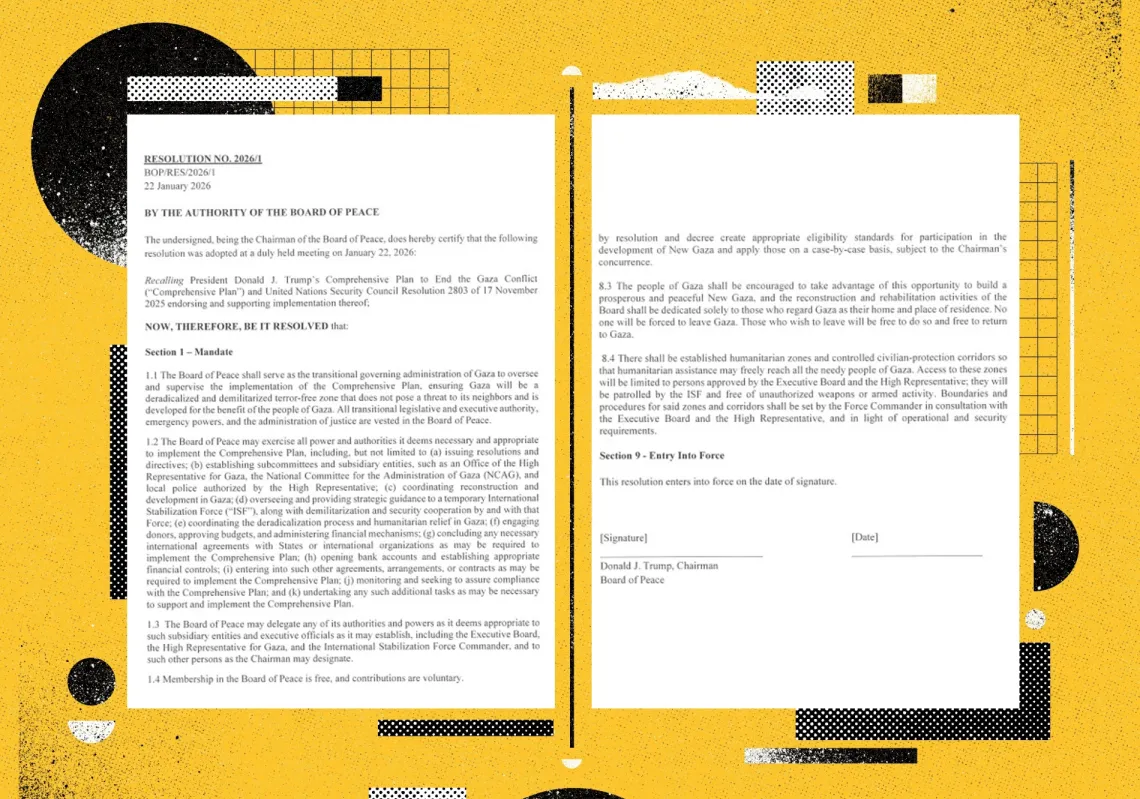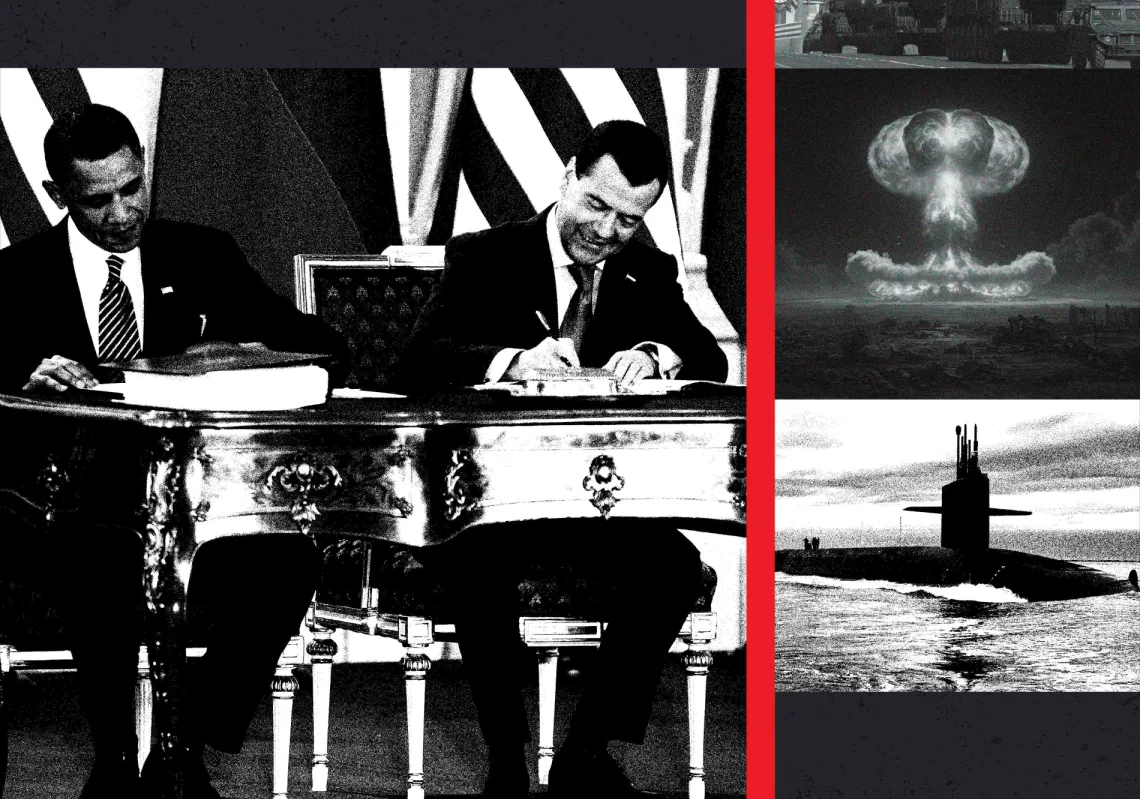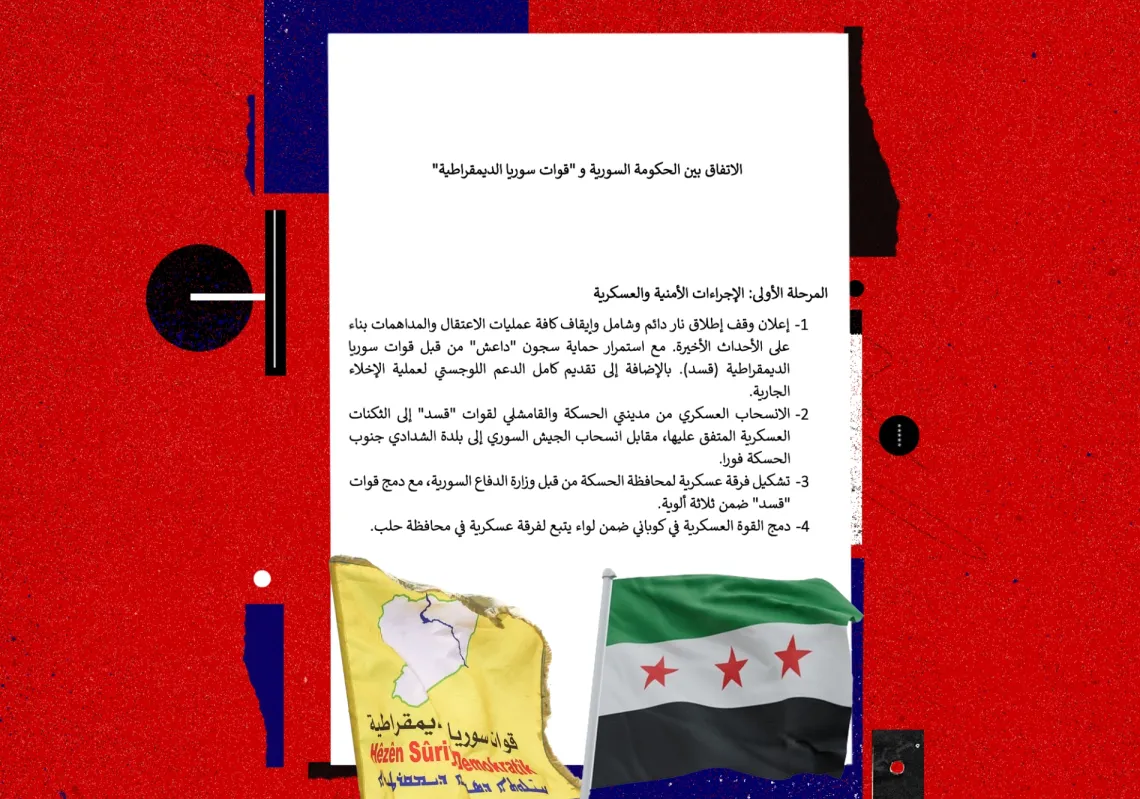نظريا، بدأت إسرائيل عام 2025 في وضع مثالي لمواجهة برنامج إيران النووي. فقد تركت الضربات الإسرائيلية التي نُفذت في العام السابق إيران عاجزة فعليا، وفشلت أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تطورا لديها. كما أُصيب "حزب الله"- أحد أقوى وكلاء إيران، الذي صُممت ترسانته الصاروخية جزئيا لردع أي هجوم إسرائيلي أو الرد عليه- بحالة انهيار كامل. وزاد الأمر أهمية أن الرئيس ترمب، الذي انسحب سابقا من الاتفاق النووي لعام 2015 وتعهد بإعادة فرض أقصى درجات الضغط، كان على وشك العودة إلى البيت الأبيض.
لكن بعد أربعة أشهر فقط من بداية العام، تبددت تلك الثقة المفرطة ليحل محلها الشك. فالإدارة الأميركية بقيادة ترمب تبدو غير مستعجلة للاشتراك مع إسرائيل في ضرب إيران، أو حتى لمنح تل أبيب حرية التصرف (والأسلحة) اللازمة للقيام بذلك من جانب واحد. وعلى الرغم من تصريحات الرئيس الأميركي بأنه "سيكون في الطليعة" في مهاجمة إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن الحكومة الإسرائيلية بدأت تشكك في ذلك وترى في تصريح ترمب مجرد تكتيك تفاوضي وليس تهديدا جديا.
وفي الوقت نفسه، فإن الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه حاليا يمكن أن يسمح لإيران بسهولة بالبقاء "على العتبة النووية"، أي دولة يمكنها بسرعة تجاوز العتبة النووية وبناء قنبلة.
وتدور نقاشات داخلية حادة داخل الإدارة الأميركية، يحتمل أن تؤثر بالفعل على الجولة الرابعة من المحادثات التي جرى تأجيلها. ويبدو أن واشنطن مرتبكة بشأن ما تريده من الاتفاق، وما إذا كانت تبحث عن اتفاق بأي ثمن، أم إنها تريد اتفاقا يزيل التهديد النووي الإيراني بشكل أكثر شمولا.
خطة إسرائيل لإحكام الخناق على إيران
كانت خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسيطة نسبيا. فمع كون إيران أضعف من أي وقت مضى أمام الضربة، ستمارس إسرائيل والولايات المتحدة ضغوطا على إيران للقبول باتفاق تستطيع إسرائيل التعايش معه، أو (الأرجح) ستشنان ضربة مشتركة على إيران لإزالة التهديد تماما- على الأقل لفترة من الوقت.
وبالطبع كان بوسع إسرائيل أن تجرب استراتيجية أكثر عدوانية، بالتحرك الفوري للضغط على إدارة ترمب لضرب إيران في الأسابيع الأولى من ولايته، دون إعطاء الدبلوماسية فرصة. ولكن خلال الأسابيع التي سبقت تنصيب ترمب، أصبح من الواضح (كما توقع بعض مراقبي ترمب) أن الرئيس يريد إبقاء الباب مفتوحا أمام التواصل الدبلوماسي.
من جانبها، أدركت إيران أهمية إرسال إشارات تدل على استعدادها للحوار مع الإدارة المقبلة. فبعد أيام من فوز ترمب في انتخابات عام 2024، ظهرت تقارير تفيد بأن سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، التقى مع إيلون ماسك. ولعل طهران قد وجدت في ماسك قناة فعالة للتواصل مع الإدارة الجديدة، على عكس الكثير من صقور السياسة الإيرانية الذين كان متوقعا أن يشغلوا مناصب بارزة في مجالي الأمن القومي والسياسة الخارجية. وتتماشى هذه البادرة مع التصريحات العلنية للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الذي انتُخب في منتصف عام 2024، حين أعلن خلال حملته استعداده للتفاوض مع ترمب في حال عودته إلى السلطة.
وسرعان ما أصبح جليا أن الرئيس ترمب سيمنح الأولوية للمسار الدبلوماسي. وفي حينها، رأت إسرائيل في هذا التوجه إزعاجا أكثر منه عقبة جوهرية. فالإدارة الجديدة، من منظور تل أبيب، تمتلك الوسائل الكفيلة بإجبار إيران على قبول اتفاق أشمل بكثير من "خطة العمل الشاملة المشتركة" التي حملت اسما مضللا، في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015. ومن وجهة النظر الإسرائيلية، يجب أن يشمل هذا الاتفاق تفكيكا كاملا للبرنامج النووي الإيراني، ناهيك عن معالجة قدرات طهران في مجال الصواريخ البالستية وشبكتها الواسعة من الوكلاء الإقليميين.
وفي الأسابيع الأخيرة، أشار رئيس الوزراء نتنياهو إلى "النموذج الليبي" كإطار محتمل لأي اتفاق مع إيران، وكان ذلك إشارة إلى اتفاق عام 2003 الذي تخلى بموجبه الزعيم الليبي معمر القذافي عن برنامجه النووي الوليد. إلا أن مصير القذافي لاحقا قد يكون أحد الأسباب التي تدفع إيران إلى عدم التفكير جديا في مثل هذا الترتيب.
هل كانت فرص التوصل إلى اتفاق وفق تلك المعايير ضئيلة؟ بالتأكيد. غير أن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا ستجدان نفسيهما– مع مرور الوقت وفشل المسار الدبلوماسي– مستعدتين لتوجيه ضربة عسكرية تستهدف وتدمر البرنامج النووي الإيراني. وإذا نجح ترمب، بما يشبه "معجزة من معجزات فن الصفقات"، في إقناع إيران بالقبول بتلك الشروط، فإن ذلك سيمثل نصرا غير مسبوق.
وفي كلا الاحتمالين، كانت النتيجة المرجوة واحدة: تراجع النفوذ الإقليمي الإيراني وتضاؤل قدرتها على استغلال الحروب الأهلية والفوضى المنتشرة في المنطقة، وهي التي ساهمت في خلق الكثير منها. وإذا وجدت إيران نفسها عاجزة عن تعويض هذا التراجع من خلال التهديد بالتحول إلى دولة نووية، فإنها ستغدو معزولة ومنزوعة السلاح.
وتتشابه هذه الاستراتيجية، في كثير من جوانبها، مع تلك التي تبناها الدبلوماسي الأميركي جورج كينان خلال الحرب الباردة تجاه الاتحاد السوفياتي: احتواء إيران، ومواجهتها عند كل مفترق، ومنعها من توسيع نفوذها الخارجي، إلى أن تُجبر في نهاية المطاف على التعامل مع مشكلاتها الداخلية العميقة. وتتنوع هذه المعضلات من صراع داخلي محتدم داخل قيادة متأزمة، إلى تصاعد المعارضة في معظم شرائح المجتمع الإيراني ضد نظام بات يعتمد على القمع أكثر من أي وقت مضى، بعدما فقد الكثير من شرعيته.
مفاجأة ترمب
إن القاعدة الأولى في المعارك هي أنه لا يمكن لأي خطة أن تصمد عند الاحتكاك بالعدو، ومحادثات إيران لم تكن استثناء من هذه القاعدة. وجاءت المفاجأة الأولى عندما أعلن الرئيس ترمب خلال اجتماع مع نتنياهو في البيت الأبيض عن نيته استئناف المحادثات مع إيران. وقد أُخذ نتنياهو على حين غرة فيما بات اليوم خطوة ترمبية نمطية لتحويل الاجتماعات الخارجية الباهتة عادة إلى مشاهد تلفزيونية مسلية لعامة الجمهور. وقد حولت الجولتان الأوليان من المحادثات التي جرت في وقت لاحق من شهر أبريل/نيسان شعورا خفيفا بالقلق في إسرائيل والارتباك بشأن نوايا ترمب إلى مخاوف حقيقية للغاية.