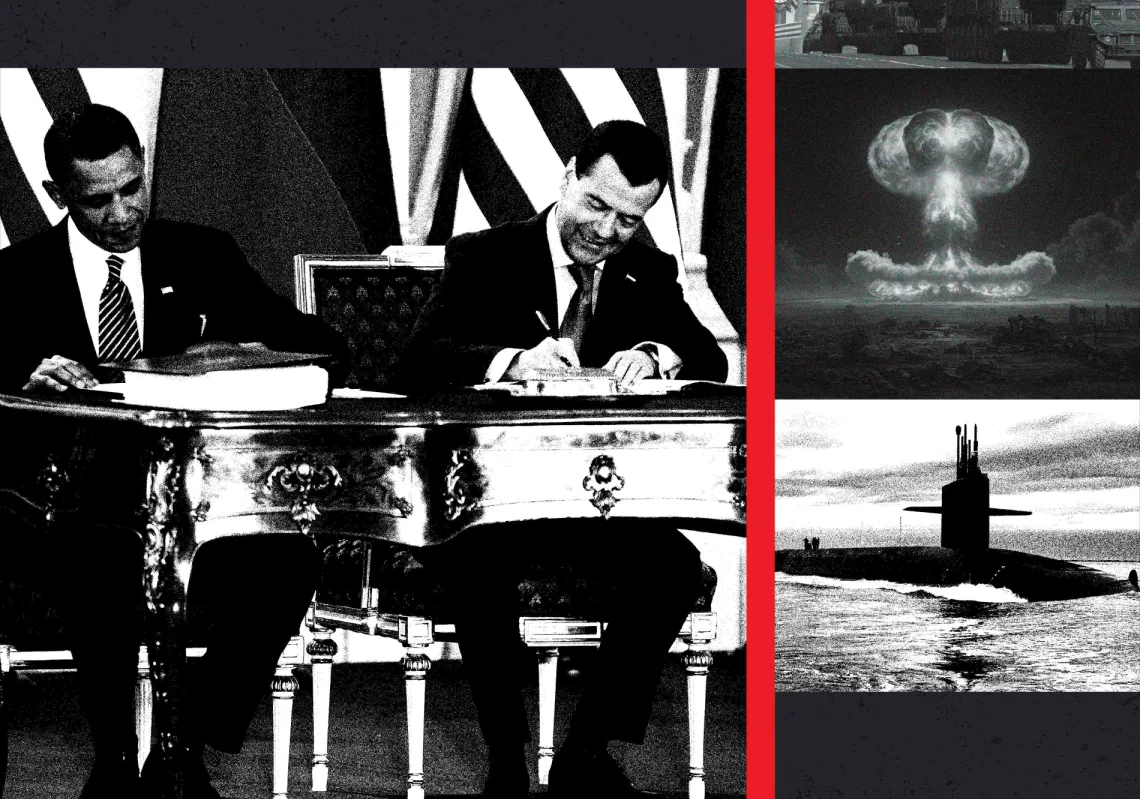لا أحب التقاط الصور الفوتوغرافية، تحديدا لما هي عليه، أي كونها صورا. بصمات مخاتلة لزمن مضى، قطع لحظة راهنة وضمها إلى الذاكرة. ولا أحبها لسبب آخر، وهو أنني أبدو دائما شخصا آخر فيها. أنظر إلى نفسي في الصورة الأحدث، وأرى غريبا تاما. الأسوأ بالطبع حين أضطر إلى الابتسام، وهو غالبا ما يحدث في الصور التي يلتقطها الآخرون لي. يريدونني أن أبتسم كدليل على السعادة أو على الأقل على السعادة خلال لحظة التقاط الصورة، أو أكثر، على الرغبة في السعادة. أو – الأسوأ من هذا كله – على الكياسة، كياسة تقدير اللحظة.
في المكسيك التي لم أتخيّل أن أزورها يوما، بسبب بعد المسافة وكرهي المزمن للطيران، لم أشعر بالحاجة الماسة لالتقاط الصور الفوتوغرافية، أو لإثبات وجودي في أيّ من الأمكنة التي زرتها، وحيدا أو برفقة آخرين، خلال أسبوعين أمضيتهما هناك بين "المكسيك العاصمة" (أو "المكسيك المدينة" الذي يقابله مسمى "مكسيكو سيتي" بالإنكليزية)، ومدينة "التكيلا" غوادالاخارا.
ولماذا أريد أصلا أن أتذكر المكسيك من خلال صورة فوتوغرافية؟ لن تستطيع تلك الصور التقاط شعوري تجاه صداقة جديدة كونتها مع شاعر مكسيكي مجايل لي يدعى أوسكار دي بابلو، أو شريكته في الحياة باولا أبرامو، أو تجاه شادي روحانا المترجم والأكاديمي الحيفاوي المقيم في المكسيك منذ عشر سنوات وزوجته الفنانة مارسيلا مورا، اللذين أصدرا معا كتيبا صغيرا ضم قصائد مترجمة لشعراء من غزة، صار من الأكثر مبيعا بين الكتب المتعلقة بالحرب الأخيرة.
كذلك لن تستطيع أي صورة التقاط الأوقات الدافئة التي أمضيتها صحبة الكاتب العراقي صموئيل شمعون، صاحب "عراقي في باريس" الصادر أخيرا بترجمة إسبانية في المكسيك عن دار "فوندو دي كولتورا إيكونوميكا"، وشريكته في الحياة والعمل مارغريت أوبانك، ناشري النسختين الإنكليزية والإسبانية من كتابي الأخير، اللتين كانتا مناسبة هذه الرحلة، للمشاركة في "معرض غوادالاخارا الدولي للكتاب".
مدينة تبدأ ولا تنتهي
لحظة دخول الطائرة إلى أجواء "المكسيك العاصمة"، وتحليقها طويلا فوق المدينة قبل أن تحط في مطارها الدولي، كانت هي اللحظة الوحيدة التي شعرت فيها بالامتنان لجلوسي في مقعد النافذة. عدا ذلك، لا بد من نصح كل من يسافر على الدرجة الاقتصادية في رحلات طويلة كهذه بعدم حبس نفسه في هذا المقعد، واختيار المقعد الطرفي أو حتى الأوسط وإلا انتهى به الأمر محشورا في ذلك المكان الضيق، مترددا في الطلب من قاطني المقعدين المجاورين النهوض كلما دعت الحاجة إلى ذلك. لكن المسافرين الأقحاح ليسوا بحاجة على الأرجح إلى نصيحتي هذه.