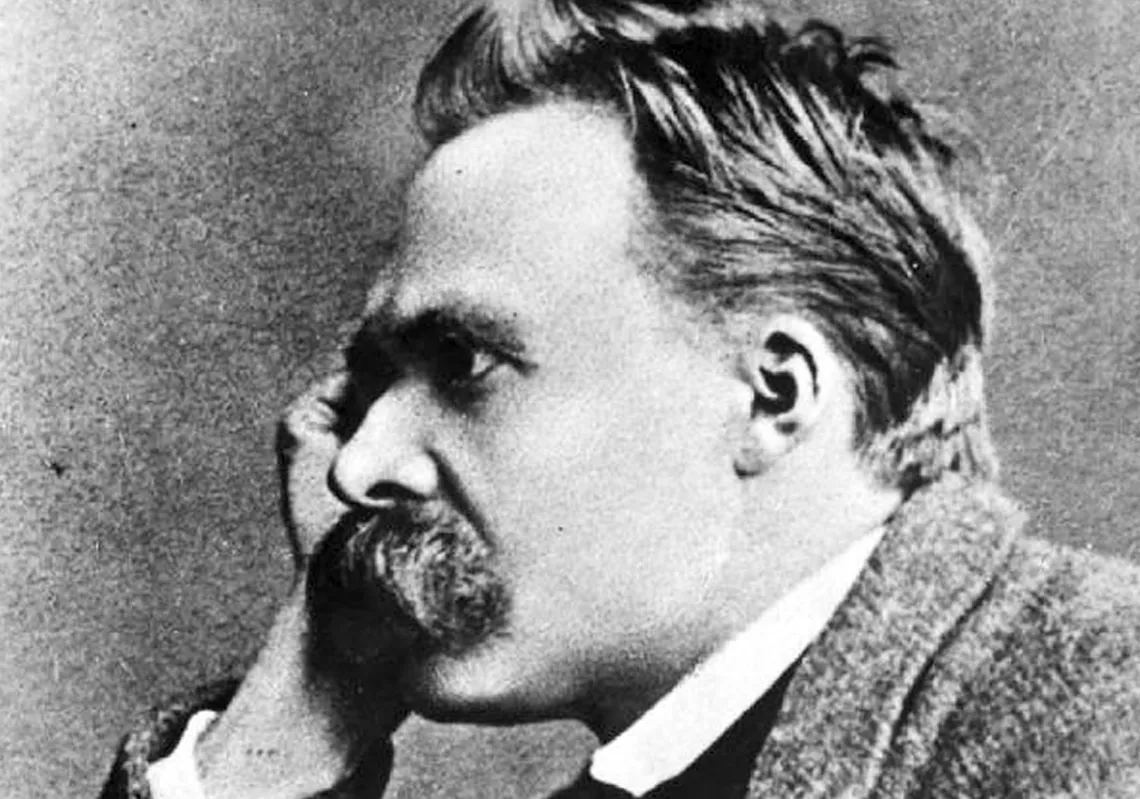ما الأدب دون غموض، دون أن يثير فينا أسئلة مفتوحة على كل الإمكانات؟ لا يصير النص أدبيا إلا حينما يتحرر من صيغة المباشرة وينعرج ذهابا في دروب المجاز والاستعارة ويلج جغرافيا التأويل المشرع على كل الاحتمالات. إذ يتحرر النص من قيود التواصلي، ويزيل عنه أثقال الفهم المغلق الذي يقيد في حيز الزمن والمكان الضيق، فيموت. فالنص الأدبي يحيا في قابلية إعادة قراءته المستمرة، أي في استحالة القبض على معناه. أمر شبيه بمفهوم الإرجاء الدريدي (نسبة إلى جاك دريدا)، غير أنه يعمل على الإقامة الدائمة في مسمى "المفتوح" أو "العصي على القراءة". ليس معنى الامتناع عن فكر شفراته اللغوية واللسانية، لكن وقوعه في فضاء مكشوف وغامض في آن، بقدر ما نقترب من معانيه تتولد لدينا ثغرات وتنكشف حفر، علينا أن نسدها في متاهة هرمسية في عود أبدي.
المتاهة الهرمسية
في هذا المعنى تحديدا، نقف عند نصوص تشبه أبوابا مغلقة، من زمن أولى الخربشات على الجدران، مرورا بالملاحم والمقامات وصولا إلى المنجز التفاعلي... كأن الكلمات فيها حجب والجمل اختبارات تقيس قدرة القارئ على التماهي معها. بعض هذه النصوص يبدو أنه يعلن رفضه للقراءة، وفي هذا الرفض يكمن التحدي الأكبر: هل النص يقاوم القارئ أم أن القارئ غير مستعد لالتقاء العمق الذي يفتحه النص؟ يحيلنا هذا السؤال مباشرة إلى العلاقة بين النص والمتلقي، حيث يصبح الفهم عملية متوترة بين الإمكان والتحقق، بين ما يعطى وما ينتج، بين النص كمادة ومنظومة دلالية تفرض على القارئ حركة مستمرة في القراءة. الأمثلة الأدبية المعاصرة على هذا النوع من النصوص عديدة، من "عوليس" لجيمس جويس، إلى نصوص كافكا وبيكيت، وحتى الشعر الرمزي الذي أشار إليه بول فاليري حين اعتبر أن العمل الأدبي يظل مشروعا دائما لا يكتمل، فالنص ليس قطعة جاهزة للامتلاك وإنما حقل تجريبي يتشكل من خلال تجربة القارئ.
هذا النص المقاوم لا يرفض القراءة بشكل عشوائي، فهو بخلاف ذلك يضع شروطا على فعل القراءة ذاته، مما يجعل النص فضاء ليليا دلاليا (موريس بلانشو)، لا يسمح بمرور سهل، ويجعل القارئ شريكا في صناعة المعنى، يعيد النظر في التفسير ويعيد ترتيب علاقته بالكلمات والجمل. هكذا تصبح المقاومة النصية ممارسة بنيوية، وليست نتيجة قصور فهم القارئ، إذ تتحقق في التوتر بين النص وقراءة القارئ، في مساحة تفاعلية تتضمن التاريخ الثقافي، المعرفة السابقة، وسياق التلقي.