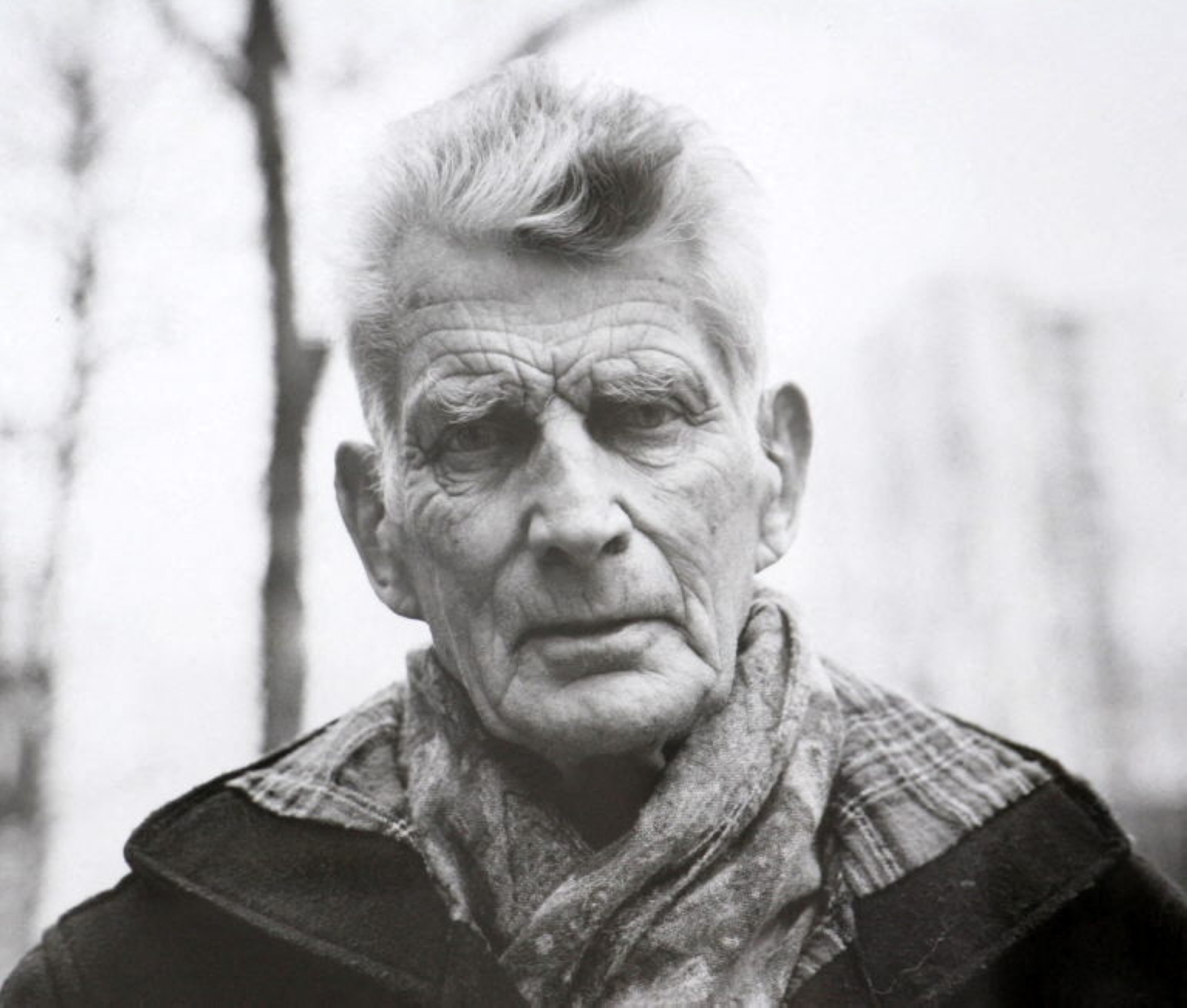يظهر الأدب في الوعي الثقافي العام بوصفه حاملا للتجربة الإنسانية، وسيلة تمنح الحياة إمكان البقاء بعد انقضائها، وصيغة تحفظ ما يهدده الزوال. هذا التصور يجد جذوره في علاقة الإنسان القديمة بالحكي، حيث ارتبط السرد منذ البدايات الأولى بمحاولة مقاومة الفناء، سواء عبر الأسطورة أو الملحمة أو السيرة. الكتابة، ضمن هذا الأفق، تستقبل بوصفها امتدادا للذاكرة، ووعاء قادرا على احتضان التجربة الفردية والجماعية، ونقلها عبر الزمن. هذا التصور لا ينبني على فكرة تقنية عن الذاكرة، وإنما على إحساس وجودي يرى في الأدب نوعا من التعويض عن هشاشة العيش وقابليته للاندثار.
غير أن هذا الوعي، على بداهته الظاهرة، يخفي تحولا عميقا في طبيعة ما يحفظ. فالأدب لا يحمل التجربة كما حدثت، ولا يحتفظ بها في حالتها الخام، وإنما يعيد تشكيلها وفق منطوق اللغة ومنطق الخيال. فالذاكرة التي يعمل بها الأدب لا تشبه الذاكرة البيولوجية، ولا الذاكرة العصبية، وإنما تنتمي إلى حقل رمزي، تتحول من خلاله الوقائع إلى دلالات، والأحداث إلى صور، والألم إلى بنية قابلة للقول. من هنا يبرز الأدب كفضاء تعبير، لا كمخزن محايد.
الحكي والمشترك الجمعي
بالتالي، تتخذ الذاكرة، في هذا السياق، شكل الحكي، لا شكل الخزان. هذا الأخير الذي يفترض التراكم، بينما الحكي يفترض الاختيار والترتيب والحذف، أي إنه يحتم رفع الصوت، وجعل المحكي يهيم في الهواء، فالذاكرة هي حالة فردية صامتة أما الحكي فحالة المشترك الجمعي الهدار. إذ كأن الحكاية تنطوي على قرار ضمني في شأن ما يقال وما يترك خارج النص، لهذا هي ابنة الشفهي، بينما ذاكرة الأدب هي سليلة المدون، الذي يقاوم الريح.
هذا التحول يجعل الذاكرة الأدبية ذاكرة فاعلة، لا ذاكرة تسجيل. فالذاكرة السردية ترتبط بالهوية، كما يخبرنا بول ريكور لأنها تمنح الذات إمكان فهم ذاتها عبر الزمن، من خلال ربط الأحداث ضمن مسار ذي معنى، يتعلق أساسا بالجماعة، التي تعمل على الحفاظ على المحكي/المسرود بالتواتر، والكتابة أيضا. غير أن الذاكرة، في علاقتها بالأدبي، لا تعمل بوصفها استعادة ميكانيكية، وإنما بوصفها بناء تأويليا. فالأدب لا يحاكي وإنما يؤول، وكل مسعى للمحاكاة يبوء بالفشل، إذ أن للذاكرة دائما ثغرات، كما أن النص الأدبي، وهو يعمل على نقل الواقعي، يحول إلى منطوق اللغة التي لا تنفصل في عملية السرد عن منطق الخيال، مما يجعل كل عملية تبتغي محاكاة الواقع مستحيلة التحقق، فالكتابة خيانة للواقع، ونسيان له. إذ "ما يمضي له مسكنه في النسيان" (برنار نويل).